عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"فلسفة الإعلام والاتصال" لمحمد بابكر.. خريطة معرفية شاملة
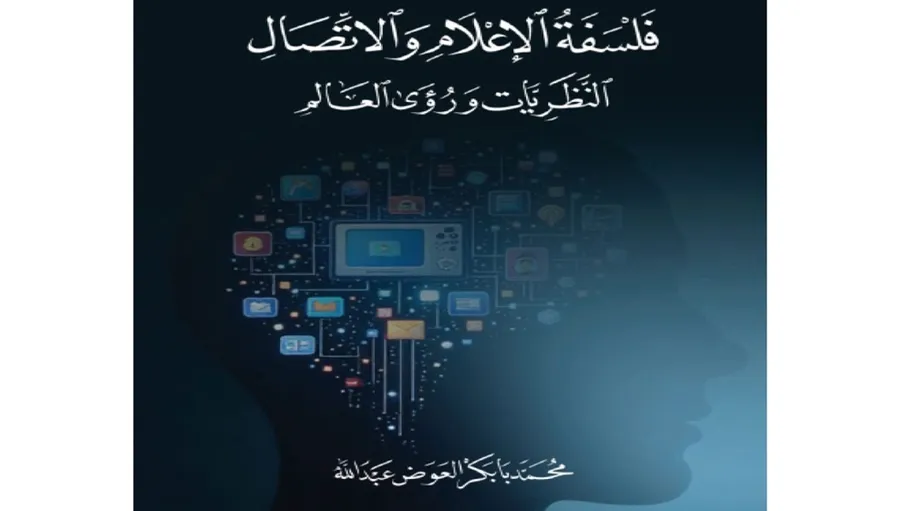
الغد-عزيزة علي
يأتي كتاب "فلسفة الإعلام والاتصال: النظريات ورؤى العالم" للدكتور محمد بابكر العوض، كخريطة معرفية شاملة، تمزج بين الفكر الفلسفي العميق والمنهجية العلمية الصارمة، لتقدم للقارئ رحلة عبر تاريخ الاتصال، من جذوره الفلسفية القديمة إلى أحدث التجارب والتطبيقات المعاصرة.
لا يكتفي الكتاب الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بعرض النظريات والنماذج، بل يسعى إلى فهم الاتصال من منظوره الإنساني والاجتماعي والثقافي، مع التفاعل النقدي الواعي مع التقاليد الغربية والشرقية والإسلامية، بما يجعل القارئ في قلب تجربة معرفية غنية، تجمع بين الاستيعاب والتحليل، بين النظرية والتطبيق، وبين الحلم الرقمي والطموح الحضاري.
يمثل الكتاب مرجعا أكاديميا متكاملا، يجمع بين الإثارة الفكرية والتحفيز المنهجي، ويضع بين يدي الباحثين والدارسين والمهتمين أدوات فكرية لقراءة الواقع الاتصالي، وفهم تحولات الإعلام والتواصل في القرن الحادي والعشرين، في ظل ثورة الشبكات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومتغيرات العولمة المعرفية والثقافية.
الكتاب جاء في ثلاثة أقسام، وعشرة فصول، وخاتمة. ويتناول القسم الأول: تكامل الأسس المنهجية للاتصال الإنساني، ويعرض ماهية الفكر الاتصالي، وخصائصه، وأبرز موضوعات البحث في فلسفة الاتصال. كما يقدم تعريفا بالتأسيس الفلسفي للفكر الاتصالي، ويضيء على حقيقة التكامل بين مفاهيم هذا العلم ومناهجه، رغم تباين الرؤية الكلية.
ويكشف القسم عن أسس منهجية التفكير الاتصالي، والوضع الاعتباري لدراسات الاتصال، والأصول المنهجية لنظرياته، وأهم منطلقاتها للاجتهاد والتجديد. كما يعرف بشبكة العلاقات التي تربط علم الاتصال بالعلوم الأخرى.
أما القسم الثاني، الذي جاء بعنوان "اتجاهات الفكر الاتصالي وتقاليده"، فيستعرض أهم الاتجاهات والمذاهب والتقاليد السائدة في البحث الاتصالي، بدءًا من التوجهات اللغوية والبلاغية، مرورًا بنظريات الخطابة، والاتصال اللغوي، والسيميائية، والبلاغة الجديدة.
ويناقش القسم الثالث، المعنون بـ"ما بعد نظرية الاتصال الغربية، واقع الفكر الاتصالي وتباينات رؤية العالم في القرن الحادي والعشرين. ويبحث هذا القسم في اختلاف المقاربات الاتصالية السائدة اليوم، وفي تفكيك النزعة الغربية المهيمنة على دراسات الإعلام، محللًا تباين المنظورات في بحوث النظرية الاتصالية. وتياراته القديمة والحديثة، شرقًا وغربًا.
ويسعى إلى رسم خريطة شاملة للتجارب والنماذج الاتصالية الفاعلة حتى بداية القرن الحادي والعشرين، من خلال مقاربة منفتحة تتجاوز حدود الأكاديميا لتشمل رؤية ومقاربات اتصالية متنوعة، ما جعل البحث أكثر عمقًا واتساعًا.
ويبين المؤلف أن فصول الكتاب تتوسع في تتبّعها لتاريخ الاتصال، لتستوعب تطوّر الأجهزة الثقافية والوسائط الاتصالية، وما ينبغي أن يكون عليه التواصل، وهي تحكي روايتها حول تطورات الواقع التواصلي ومجرياته، متتبعةً إبداعات العقل الإنساني وما قدّمه من افتراضات جريئة حول طبيعة وماهية التفاعل البشري، وكيف تتواصل المجتمعات، وما تستخدمه من وسائل وأدوات تجمع بين تجسيد الحالة الثقافية ومخاطبة المجتمع الإنساني.
وانطلاقًا من ذلك، كما يوضح عبدالله، أن الكتاب يفتح قوس الابتداء في مناقشة الفكر الاتصالي ومعالجته بالمراجعة والنقد بـ"المنطق الخطابي"، بوصفه الصورة الأولية والنموذج التأسيسي للتفكير في ظواهر الاتصال، وباعتباره نقطة جوهرية ومسلمة مشتركة تجمع بين النظرية الغربية المتغلّبة بأفقها الواسع وتقنياتها العالية، والنظرية الشرقية الإسلامية المناهضة بخيالها المستقل.
ويقول المؤلف "إن هذا الكتاب يحاول أن يجمع، في مجمل بنائه، بين الإثارة الفكرية والتحفيز المنهجي للباحثين والأساتذة، وبين الإفادة العلمية والتأسيس المعرفي للطلاب والمهتمين في مجالات الإعلام والاتصال. وعلى الرغم من محدودية العمل، فإنه يقوم على الجمع بين ثلاثة أبعاد رئيسية: "بعد تأصيلي: يعيد النظريات والنماذج الاتصالية إلى أصولها الفلسفية الأولى، أيًّا كان سياقها الثقافي أو الحضاري. بعد منهجي: يضبط عمليات الاسترجاع التاريخي والتأصيل النظري بغايات معرفية ومنهجية واضحة. بعد قيمي: يتوخّى الحكمة والنظر في مآلات الأمور".
ولتحقيق هذه الأبعاد، شرع المؤلف في استرجاع شامل لأصول النظريات الاتصالية الحديثة، من خلال مداخل واسعة تعرض بوضوح أهم الأفكار الجامعة بين تلك النظريات، وتدرس الأطروحات الأساسية التي شكلت ملامح هذا العلم، وأبرز المساهمات التي قدمت في مجاله.
وكتب تقديما للكتاب الدكتور محمد السيد مختار، الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية بالبحرين، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب يتفرد في مباحثه وموضوعاته ومنهجه، ويتسم بسعة أفقه وشموله. وهو كتاب جدير بالاحتفاء طباعة ونشرا وتوزيعا، وبالدعوة إلى اعتماده مرجعا أساسيا في مقررات نظريات الاتصال وفلسفته على مستوى الدراسات العليا.
كما يؤكد أنّ الكتاب يجسد منهجية الاستيعاب والتجاوز في أنضج صورها، صعودا بالنظريات والنماذج المعرفية والمنطلقات الفلسفية إلى أفق الرؤية العالمية، واستيعاب مختلف المنظورات التي قدمت فكرا اتصاليا. ويتجاوز الكتاب ذلك، إلى آفاق الاعتراف بتعددية رؤية العالم والاحتفاء بتنوعها، متحررًا من نزعات المركزية التي تحمل وهم الربوبية وتصر، عبثًا، على تشكيل العالم وفق صورتها.
