عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"اللغة.. التعليم.. الدين والمجتمع".. إصدار جديد لإبراهيم عثمان
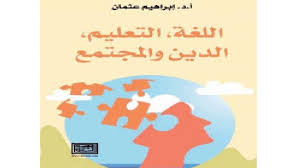
الغد-عزيزة علي
صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "اللغة، التعليم، الدين والمجتمع"، لـ"أ. د. إبراهيم عثمان"، يتناول الكتاب مجموعة من الموضوعات، من أبرزها: النظام الرمزي، الذات والاجتماع الإنساني، التعليم الجامعي العربي والاستجابة للتحديات المستقبلية، وجدل المقاربات، الفكر الديني السلفي والتنمية.
كما يتحدث الكتاب عن الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتطورها في الأردن، البناء الاجتماعي في الأردن، التدرج والطبقة الوسطى والديمقراطية في المجتمع الأردني، علم الاجتماع بين الخصوصية والعالمية، نظرية ابن خلدون في تشكيل الوجود الطبيعي والاجتماعي وتطورهما.
يقول الدكتور إبراهيم عثمان في مقدمته للكتاب: "إنه تناول فيه مواضيع محورية متعددة ظهرت في فترات متفرقة، ورغم تنوعها، فإنها ما تزال تحمل الأهمية نفسها، خاصة في ارتباطها المستمر بحاضر ومستقبل المجتمعات العربية". ويشير إلى أن هذه المواضيع ترتبط بالتأثيرات الإقليمية والعالمية في ظل التشابك العالمي. ورغم اختلاف الموضوعات، فإنها تتقاطع جميعها في دورها في تنمية المجتمعات.
ويبين المؤلف أن أول هذه الموضوعات هو اللغة، التي يعتبرها أساسا للتجمع الإنساني وبناء شخصية الإنسان ولا تنحصر أهميتها في الاتصال والتعبير، فاللغة تتجاوز مجرد الاتصال والتعبير لتصل إلى بناء العقل والذات الإنسانية. فلا يمكن تكوين المعاني إلا من خلالها، ولذلك فهي تعد من أهم الأدوات التي تبني الشخصية. وعلاوة على ذلك، واللغة بأهيمتها في بناء الشخصية، فإنها تمثل هوية الجماعة ومنجزاتها الثقافية.
ويشير عثمان إلى أنه في منتصف القرن العشرين كان الاهتمام كبيرا باللغة، إلا أن هذا الاهتمام بدأ يتراجع، مما قد يؤدي إلى فقدان الأجيال القادمة جزءًا مهما من أسس انتماءاتهم الثقافية. فاللغة الأم وما يمكن اكتسابه من مهارات لغوية هي من الضرورات الأساسية لتحقيق التقدم الفكري والعملي.
أما الموضوع الثاني، كما يقول عثمان، فهو التعليم، الذي كان وما يزال من أهم عوامل التغيير في المجتمعات العربية. فإذا كانت الثورة الصناعية قد حولت المجتمعات الغربية من مجتمعات إقطاعية زراعية إلى مجتمعات صناعية وتجارية ذات بناءات أكثر تعقيدا، فقد لعب التعليم دورا مشابها في البلدان العربية.
ويرى المؤلف أن التعليم كان له دور كبير في تشكيل وتوسيع الطبقة الوسطى. ومع ذلك، فالتعليم في العالم العربي، كان محصورا بين النقل وحفظ ما كان وما هو كائن، ولم يلعب الدور المطلوب في إحداث التغييرات الفعلية، من خلال تنمية قدرات الإبداع أو ربط التعليم بحاجات الواقع أو العمل على تنميتها.
ويرى المؤلف أن الدين لعب دورا مهما في تاريخ مجتمعاتنا، على المستويين الجماعي والفردي، ولذلك كان من الضروري طرح هذه المسألة للنقاش والحوار. أما ما جاء باللغة الإنجليزية في الكتاب، فهو ليس محاولة للرد على المواقف المغرضة والمزعومة من الغرب والصهيونية فحسب، بل أيضا لتعريف القراء بحقيقة بعض التوجهات الدينية وأبعادها.
أما الموضوع الرابع، فهو كما يقول عثمان: تحليل للبناء الاجتماعي الأردني من خلال المنشورات العلمية الاجتماعية، وهو من المواضيع التي ندر التعامل معها. إضافة إلى ذلك، يتناول التحدي المتمثل في تبلور الطبقات بمعنييها الفعلي والعملي. حيث استمرت أهمية التجمعات التقليدية كالوحدات الأساسية في البناء الاجتماعي، مع الابتعاد عن التحليل الطبقي الذي يعكس واقعا ملموسا، مما أضعف قدرة هذه التجمعات على منافسة قيام مؤسسات مجتمع مدني فاعلة، وخاصة الحزبية منها.
وخلص المؤلف إلى أنه يسعى من خلال هذا الكتاب إلى بناء نظرية ابن خلدون في الوجود الطبيعي والاجتماعي والشخصي، مبرزًا عمق تناوله وتكامله وسبقه في طرح نظرية التطور. والأهم من ذلك، هو خروجه عن التأويلات الشائعة حول ظهور الإنسان، معتمدا على أن الإنسان قد ظهر نتيجة لعمليات تاريخية من التطور.
وعن اللغة وعلاقتها بما هو اجتماعي وثقافي هي علاقة جدلية ويتضمن مفهوم الجدلية عدم ثبات العلاقة أو حتمية الارتباط، كما أن أي تغيير في أحد أطراف العلاقة، يمكن أن يرتبط بتغييرات في الطرف الآخر، وقد أوضح د. نهاد الموسى مثل هذه العلاقة الدينامية في تناول اللغة وتطورها في مشروع حصاد القرن (الموسى (2007)، حيث تشمل التغييرات الاجتماعية والثقافية الجوانب الفكرية والمعنوية والمادية، وتفرض هذه استحداث مصطلحات جديدة.
كما أن اللغة العربية، بحسب عثمان مرت بمثل هذه القضية منذ احتكاك العرب بالحضارات الأخرى، فكانت الاستجابة إما بالرجوع للنظام اللغوي بما يتضمن من قواعد التجديد، أو بأخذ المصطلح الغريب كما هو ليصبح جزءا من البناء اللغوي، وقد يختلف هذا بين اللغة الفصحى والمحكية، إذ رغم استخراج المصطلح عربيا في الفصحى، فإن اللغة المحكية تميل غالبا إلى استخدام المصطلح الجديد كما هو في اللغة الأصلية، من هذا القول: الراديو والتلفون بدلا من استخدام المذياع والهاتف. وكما أن التغييرات الاجتماعية تفرض تجديدا لغويا باستحداث مفردات ومصطلحات، فإنها يمكن أن تغيب الحاجة لمفردات ومصطلحات كانت موجودة تاريخيا، وقد تؤدي العمليتان إلى لغة شبه جديدة.
ويرى المؤلف أن النظام الاجتماعي لهذه اللغة أنتجه وطوره الإنسان ضمن ظروف اجتماعية، لا يدرس أو يحلل بشكل تكاملي إلا في علاقته بالنسق الاجتماعي وأجزائه. وتعتبر اللغة والنظام الرمزي عامة من أسس تشكيل الذات والعقل والجماعة وترتبط من حيث أنماطها بالبناء الاجتماعي بعلاقة جدلية دينامية مستجدة. وقد برز ضمن هذه العلاقة رابط بين المعاني والأفكار والإنتاج الفكري، إلا أن الإنتاج الفردي يرتبط إلى حد كبير بالظروف الاجتماعية الثقافية التي يعيشها الفرد المنتج، وفي الوقت نفسه يرتبط باللغة وأساليب التعبير في مجتمع الفرد المنتج.
