عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"المدن والتجارة".. إطلالة على التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا
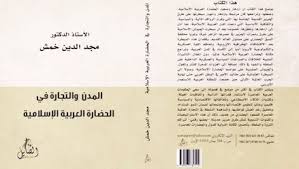
الغد-مجدي دعيبس
يأتي كتاب "المدن والتجارة في الحضارة العربية الإسلامية"، حصيلة جهد معرفي كبير تراكم على مدى سنوات طويلة من العمل الأكاديمي والبحث والاطلاع على المراجع العربية والغربية، التي تقدم وجهة نظر رصينة ذات صلة بموضوع الدراسة.
ولعلي أعرض قراءتي للكتاب، من خلال إبراز مسارين رئيسيين: الجهد البحثي والجهد التأملي. فالكتاب يجمع بين التاريخ وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا؛ والمدن الإسلامية ورحلتها الحضارية في وصفة إبداعية تشتمل على جرعة معرفيّة عالية التركيز، بمنهجية تقدم وجهات نظر كتاب وكتب وازنة في الموضوع المطروح. ويتهيأ لي أن فكرة هذا الكتاب ظلت تراود الدكتور خمش لسنوات طويلة قضاها في تدوين الملاحظات والأفكار وعناوين المراجع التي عليه الاطلاع عليها، قبل أن يجلس في مكتبته أمام شاشة اللابتوب ويشرع بالكتابة.
على مدار مقدمة وستة فصول وخاتمة، سعى الباحث إلى استنطاق التاريخ الإنساني من خلال طرح الأسئلة التي تدعم وجهة النظر مدار البحث، ولم يكتف بذلك، بل تراه في مناسبات كثيرة يتأمل ما حدث ويفكر بصوت مرتفع ويحاول أنسنة الأشياء للوصول إلى استنتاج ما. ولا أقصد بهذا أن للكتاب صفة أدبية أكثر منها علمية، بل هي محاولة صادقة من لدن الباحث تدفعه حماسة متوقدة للوقوف على أصل الأشياء وحركة تطورها.
تبدأ الفكرة عند الدكتور خمش مثل نار صغيرة يداريها بحرص المقرور في ليلة باردة، ويهيئ لها كل أسباب الصمود في وجه التيارات المفاجئة التي قد تطيح بها في أي لحظة حتى تتحول في نهاية الفصل إلى نار عظيمة احتفالًا بهزيمة البرد والعتمة. وربما تجدر الإشارة هنا، إلى أن السرد التاريخي الذي وقف عليه الكتاب لكثير من الحوادث والمفاصل والمراحل المهمة المرتبطة بالسياق العام، كان موجزا وموضوعيا وغير متحيز، واشتمل في مواقع كثيرة على الطرافة والنفس الحكائي ليخفف حدة الإحصائيّات والأرقام والنسب المئويّة.
وهناك عشرات الكتب التي يستشهد بها الباحث لإنارة الموضوع من زوايا متعددة، قبل تقديم رؤيته الخاصة ووجهة نظره بالقضية المطروحة. فيبدو الأمر على أننا في محكمة يقدم فيها المدعي العام مرافعة، ثم يأتي دور محامي الدفاع قبل أن يحيل القاضي الحكم إلى هيئة المحلفين الذين هم القراء.
تقوم فلسفة الكتاب في الجهد البحثي الذي توزع على الفصول الخمسة الأولى، على فكرة تاريخية تقول بتحول المدن الواقعة على طرق التجارة العالمية (اصطلاحًا طريق الحرير)، إلى مراكز قوة وسيطرة وتأثير ثقافي وإشعاع حضاري. ويستشهد على ذلك بأمثلة من التاريخ القديم، لكنّه يركّز على المدن الإسلامية التي نشأت مع ظهور الإسلام كقوة سياسية، وتطورت أدوارها مع اتساع رقعة الدولة العربية الإسلامية. التجارة تحقق الثروة والرخاء للمدن وسكانها ،وبالتالي تبدأ عجلة النهضة الشاملة بالدوران، ولا تطال فقط مستوى المعيشة والخدمات، بل تتوسع باتجاه الفكر، والعلوم، والطب، والتعليم. عندما كانت شوارع إشبيلية مضاءة ليلًا، كانت العواصم الأوروبية غارقة في ظلام دامس.
ويعرض الباحث لإشكالية نظرية التحديث وعلاقتها بالتراث، ويقدّم وجهات نظر متفاوتة تجاه هذا الأمر ويطرح أمثلة من الواقع الآسيوي، تؤكد أن الإنجاز والإنتاجية لا يتعارضان مع التراث، بل على العكس من ذلك؛ يمكن استغلال قيم مستمدة من التراث مثل الانضباط والإخلاص في العمل، والولاء السياسي الوطني لتعظيم حركة التصنيع والتحول إلى دولة مكتفية ذاتيا، قادرة على تصدير سلع استراتيجية إلى العالم أجمع.
وفي الفصل الثاني، لا يكتفي الباحث بعرض مراحل تطور مكة والمدينة والطائف كمدن لها أهمية دينية وتجارية في الجزيرة العربية، بل ينحو إلى تقديم الموضوع من وجهة نظر اجتماعية وأنثروبولوجية لتوضيح منبت الفكرة ومسألة تعلق الإنسان بالأصنام وعلاقتها بالتوتمية عند قبائل العرب قبل ظهور الإسلام، الذي وحد هذه القبائل وحولها إلى كيان سياسي مترامي الأطراف.
ويتجلى الجانب الاجتماعي من الكتاب في الفصل الرابع، حيث تبرز ملامح المدن العربية في التاريخ القديم والحديث، وينكشف أمامنا جهدًا بحثيًَا كبيرًا في الديموغرافيا والكثافة السكانية، والفئات الاجتماعية، والعمارة والمهن والمساكن والدكاكين والأسواق والبيع والشراء، وتنظيم العلاقات التجارية وغيرها من التفاصيل الدقيقة.
ويتحدث الباحث في الفصل الخامس، عن تأثير المدن العربية الإسلامية في النهضة الأوروبية الحديثة، ويشير إلى السفينة ذات الشراع المثلث والإسطرلاب وصناعة الورق، ويذكر بحسب غوستاف لوبون أنّ الحضارة العربية الإسلامية كانت شديدة السطوع في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، بينما كان يعيش في المدن الأوروبية متأخرون يفخرون بأنهم لا يقرأون ولا يكتبون. لم تكن أهمية العرب في هذا المجال في الكتب والمراجع التي وضعها علماؤهم فقط، بل أيضًا في الكتب التي ترجموها عن اليونانية وغيرها من حضارات العالم القديم.
أما الجهد التأملي الذي أشرت إليه في البداية، فهو الفكرة التي ظهرت وتجلت في نهاية الكتاب وتدور حول أن مفهوم طريق الحرير يمكن عصرنته من خلال آليات مختلفة عن التاريخي والتقليدي الذي يتمثل بالقرب من طرق التجارة العالمية أو المركزية الدينية والعسكريّة والثقافية. كما يمكن لدول محدودة المصادر تحقيقه، وأشار الباحث إلى نمور آسيا الذين صنعوا طريق الحرير الخاص بهم، وحققوا التنمية والنهضة المنشودة مثل كوريا الجنوبية وتجربة صناعة الإلكترونيات والسيارات التي غزت العالم، كما تناول الكتاب التجربة الصينية بأرقام وإحصائيّات وتفاصيل توضح السياسات وآليات الصعود وصولًا إلى العملقة الاقتصادية.
ويشير الدكتور خمش، إلى التصنيع بجودة تنافسية كآلية أساسية من آليات طريق الحرير الجديدة التي تستفيد من اتفاقيات التجارة العالمية وأدوات العصر الرقمي لفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، لكن العائق العنيد الذي حال دون الوصول إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي المنشود في كثير من الدول العربية هو تباطؤ التنمية المستدامة وبالتالي ما يزال هناك فقرا وبطالة وتراجعا في مخرجات التعليم وضعفا في منظومات الرعاية الصحية وارتفاعا في تكلفة تأمين المياه النقية، التي ستؤثر في مجملها على خلق بيئة صناعية منافسة. ومن الآليات الأخرى المتاحة، اقتصاد المعرفة والابتكار وريادة الأعمال التي ما تزال دون المستوى المأمول، لأنها تحتاج لبيئة جاذبة تدعمها سياسات حكومية مدروسة. ولم تغفل الدراسة عن إمكانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والميتافيرس، والاستراتيجيات المتعلقة بها، للدخول في الثورة الصناعية الرابعة كلاعب مؤثر عالميًا، وليس متلقيا ومستهلكا لمخرجاتها.
الدكتور مجد الدين خمش، أكاديمي وباحث حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من الولايات المتحدة الأميركية العام 1980. توج مسيرته العملية بعمادة كلية الآداب في الجامعة الأردنية. وأثرى المكتبة العربية بمؤلفات عدة، كما وصل كتابه (المدن والتجارة في الحضارة العربية الإسلامية)، إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع التنمية وبناء الدولة للعام الحالي.
