عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"في الرواية الأردنية الجادة": إضاءات نقدية لإبراهيم خليل
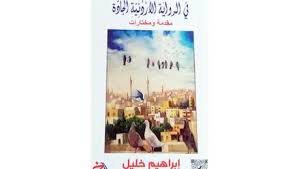
الغد-عزيزة علي
لا يكتفي الدكتور والناقد إبراهيم خليل، في كتابه "في الرواية الأردنية الجادة: مقدمة ومختارات"، بعرض النصوص، بل يسعى لإلقاء الضوء على عمقها الفني، وثراء تقنياتها السردية، مسهماً في إبراز جدية الرواية الأردنية ومكانتها في الأدب العربي الحديث.
وينطلق المؤلف في كتابه الصادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع، من نافذة تطل على أهم التجارب الروائية الأردنية، وتقديم قراءة متأنية لست عشرة رواية اختارها بعناية، من أعمال كبار الروائيين، مثل غالب هلسا، جمال أبو حمدان، زياد قاسم، أمجد ناصر، وغيرهم.
في مقدمة الكتاب، يقول د. إبراهيم خليل: "قبل العام 1870 لم يكن في الأدب العربي النثري أو الشعري ما يعرف بالرواية. وتعزى المحاولات الأولى إلى سليم البستاني (1848-1884)، مؤسس مجلة الجنان اللبنانية، وقد اتسمت كتابات الجيل الذي تمثله تلك المجلة بالسرد التاريخي العشوائي الذي لم يكن يخضع لقوانين الفن الروائي.
وانضم إلى هذا الجيل من الكتاب يعقوب صروف (1852-1927)، صاحب مجلة المقتطف، الذي كتب رواية "فتاة الفيوم"، بعد معارضة شديدة، وكذلك جورجي زيدان (1861-1914)، مؤسس مجلة الهلال، إلى جانب آخرين تتبع محمد يوسف نجم (1925-2009) أعمالهم في كتابه "القصة في الأدب العربي الحديث"، (1952)".
ويرى المؤلف أن مؤرخي الرواية العربية أجمعوا على أن رواية "زينب"، لمحمد حسين هيكل، الصادرة العام 1913، هي أول رواية عربية يصدق عليها هذا المصطلح شكلاً ومضموناً. غير أن بعضهم يعدها أقرب إلى السيرة الذاتية للمؤلف، مؤكدين أن شخصية حامد، بطل الرواية، إنما تمثل هيكل نفسه.
وبعد رواية "زينب"، تلت محاولات أخرى في فلسطين، حيث كتب خليل بيدس، صاحب مجلة النفائس، رواية بعنوان "الوارث" العام 1920. وفي سورية، نسبت الريادة إلى شكيب الجابري (1912-1996) بروايته "نهم" الصادرة العام 1937.
ويشير خليل إلى أنه في الأردن، فقد عزا ناصر الدين الكركي في كتابه "الرواية في الأردن"، (1986)، الريادة إلى تيسير ظبيان، صاحب صحيفة الجزيرة، مشيراً إلى روايتيه "أين حماة الفضيلة" و"مذكرات طالب ثانوي" بوصفهما دليلا على تلك الريادة.
غير أن يعقوب عويدات "البدوي الملثم"، في كتابه "القافلة المنسية" من أعلام الأردن، رأى أن السبق يعود إلى عقيل أبو الشعر، إذ كان الأسبق في كتابة روايات نشرت بالفرنسية، مثل "الفتاة الأرمنية في قصر يلدز"، (1912)، و"القدس حرة".
غير أن هذه الريادة تظل موضع إشكال، لسببين رئيسين؛ أولا: أن تلك الروايات كتبت بالفرنسية أو الإسبانية لا بالعربية، مما حال دون اطلاع الروائيين العرب عليها أو تأثرهم بها.
وثانياً: أن البحث في تاريخ الرواية العربية ينصرف، منطقيا، إلى الأعمال المكتوبة بالعربية أصلا، لا المترجمة عن لغات أخرى، الأمر الذي يجعل تجاهل هذه الريادة مبررا، من غير أن يتضمن ظلما لأبي الشعر أو لغيره ممن ترجمت أعمالهم في السنوات الأخيرة، أي بعد أكثر من قرن على صدورها.
ويقول المؤلف إنه اطلع على إحدى الروايات المترجمة إلى العربية، وهي "القدس حرة"، فوجدها أقرب إلى مراسلات صحفية منها إلى نص روائي متكامل. وقد أسهم عدد من الكتاب الأردنيين، والمقيمين في الأردن أو خارجه، في تغذية التيار القصصي والروائي.
ويرى أن روكس بن زائد العزيزي، يعد من أبرز من كتب روايتي "جرائم المال"، (1935"، "أبناء الغساسنة"، (1937)، وعيسى الناعوري الذي يعد أكثرهم احترافا وشهرة، إذ ألف رواية "بيت وراء الحدود"، (1952)، "مارس يحرق معداته"، "جراح جديدة"، "وليلة في القطار"،(1974)، وهي الأخيرة التي اعتبرها في مقدمته علامة فارقة في مسار الرواية العربية عموماً، لا الأردنية فحسب.
كما كتب عبد الحليم عباس روايتي "فتاة من دير ياسين"، (1950) و"فتاة النكبة". وأسهم حسني فريز (1907-1990) في إثراء المشهد الأدبي بمزج الشعر بالقصة والرواية، فأصدر أعمالاً منها: "مغامرات تائبة"، "حب من الفيحاء"، و"العطر والتراب". ومن الروائيين أيضاً شكري شعشاعة (1890-1963) صاحب السيرة "ذكريات"، أما روايته الجادة فهي "في طريق الزمان"، التي تقترب من مواصفات العمل الروائي بمعناه الفني، متجنبة الطابع التقليدي الذي كان يغلب عليه الوعظ والسرد العشوائي والدروس والمباحث الاجتماعية التي تحول الكاتب إلى مربّ في حجرة الدرس.
واستعرض خليل كتاب الرواية في تلك الحقبة، منهم: ميشيل الحاج (الرجل الذي فقد نصفه)، وصبحي المصري "القبلة المحرمة، 1959"، ونبيل أنشاصي "دموع لا تجف، 1957"، وعبد الحميد الأنشاصي. أما الحقبة التي تلت حرب حزيران (يونيو) 1967 فقد شهدت ازديادا ملحوظا في النتاج الروائي، من حيث الغزارة في العدد، والتنوع في الموضوعات، إلى جانب حدوث تحول جذري -أو شبه جذري- في النسق السردي للرواية العربية.
في هذه الفترة، كتب الشاعر تيسير سبول (1939-1973) روايته الشهيرة "أنت منذ اليوم" (1968)، التي لفتت الأنظار بما اعتمدته من تقنيات سردية جديدة، مثل الجمع بين الراوي المشارك والراوي العليم، وتوظيف المونولوج الداخلي إلى جانب الحوار، فضلا عن تداخل الأزمنة بين الماضي والحاضر، والابتعاد عن السرد الخطي بالانفتاح على التداعيات وتسليط الضوء على العالم الداخلي لبطل الرواية "عربي".
ومع ذلك، أخذ بعض النقاد عليها مآخذ خطيرة، فعدوها أقرب إلى السيرة منها إلى الرواية، وهو ما ينتقص -في رأي بعض الدارسين- من قيمتها الفنية، إذ يشترط أهل هذا الفن أن يتجنب الكاتب تضمين روايته ذاته أو حضوره المباشر، ولو من بين السطور ومن وراء الكلمات.
وفي العام (1968)، أصدر سالم النحاس رواية "أوراق عاقر"، حيث لجأ إلى الرمز؛ فالحمل الكاذب والحريق الذي شب في الفندق وما رافقه من إخفاقات، كانت جميعها إشارات إلى النكسة ونتائجها المخيبة للآمال والتطلعات.
ثم استعرض المؤلف أعمال الروائي غالب هلسا، الذي عرف بكثرة تنقله بين المنافي، فكتب رواية "الضحك"، (1970)، ثم رواية "السؤال"، "ثلاثة وجوه لبغداد"، "الروائيون"، "البكاء على الأطلال"، "سلطانة"، وغيرها، وهي أعمال منع تداول بعضها في الأردن ورفع عنها الحظر بعد رحيله العام 1989.
كما أشار إلى روائيين آخرين أسهموا في كتابة الرواية، حيث نشر فؤاد القسوس رواية "العودة من الشمال"، التي حازت أول جائزة دولة تقديرية في حقل الرواية العام 1977. وكتب طاهر العدوان عدداً من الأعمال الروائية منها: "وجه الزمان"، "حائط الصفصاف"، و"أنوار".
كما برزت أسماء أخرى أسهمت في إغناء هذا التيار التجريبي -أو شبه التجريبي- في الرواية الأردنية، من بينهم: جمال ناجي، جمال أبو حمدان، مؤنس الرزاز، زياد قاسم، قاسم توفيق، إلياس فركوح، سميحة خريس، هاشم غرايبة، أمجد ناصر، حسام الرشيد، عثمان مشاورة، هزاع البراري، محمود الريماوي، محمد حسن العمري، وسامر المجالي.
وفي السنوات الأخيرة، شهدنا زخما غير مسبوق في إنتاج الرواية، حتى غدا المشهد الروائي الأردني مكدسا بغزارة لافتة، وتكاثرت الأسماء التي يزعم أصحابها -ويصرون إصرارا شديدا- أنهم روائيون. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن يوما لا يكاد يمر من دون أن نقرأ خبرا عن صدور رواية جديدة، قد تكون لكاتب لم نسمع به من قبل.
وخلص خليل إلى "أن بعض ما ينشر يجد من يكتبون عنه مقالات يبالغون فيها، فيقولون ما لم يقله ابن زيدون في ولادة. ونادرا ما نجد بين هؤلاء من يكون على بينة من مفهوم الرواية الحقة غير الزائفة، ويستطيع، في ضوء تلك المعرفة، أن يحدد أو يعين لصاحب الرواية الأخطاء التي وقع فيها، وما المواقف التي أجاد فيها إجادة تستحق التنويه. والناقد النزيه الموضوعي الذي يفعل شيئا من هذا القبيل غالبا ما تنصب عليه اللعنات، وربما يتهم بخدمة أجندات خارجية، كما حدث معي حين تناولت رواية "سفر برلك"، لأحد الكتاب".
