عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
مع إحسان عباس ومنهجه الموضوعي
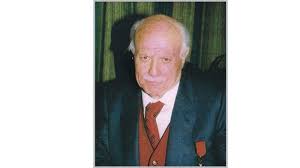
الدستور-غسان إسماعيل عبد الخالق
لم ينتم إحسان عباس لمدرسة نقدية محدّدة أو لتيار نقدي بعينه، لكنه ساق خلفه ومعه وأمامه كثيرًا من مدارس النقد، دون أن يصرّح بذلك. والحق أن أدقّ ما يمكن قوله على هذا الصعيد هو: إن إحسان عباس في النقد قد كان إحسان عباس! أي أن كثيرا مما رفد به حقل الدراسات في الأدب والنقد الأدبي العربي الحديث، تبوّأ مكانة مرموقة بين النقاد والباحثين، لأنه صدر عن إحسان عباس في ذاته. ولا ريب في أن هذا الركون الخطير، ما كان ليستقيم على سوقه، لولا المصداقية الكبيرة التي راكمها إحسان عباس، في كل ما كتب وحقّق، وظلّت تتضايف وتتضايف، حتى كادت تبلغ درجة الوثوق التام.
مع ذلك، لا بد من الاستدراك على ما تقدّم بالقول: إن إحسان عباس لم يسع ولم يطمح يومًا، لتأسيس مدرسة مستقلة في النقد، لأنه كان يدرك في قرارة نفسه، حقيقة أن ما أنجزه قد كان نتاج مهارات فردية خالصة، وليس نتاج قناعات أو مهارات جمعية، يمكن أن تُستمد من هذا التيار أو تُعزى لتلك المدرسة. وسواء كان قد خطّط لحيازة هذه المهارات، أو أنه اكتسبها دون تخطيط، جرّاء تقلّبات المكان والزمان، فإنها ستظل مهاراته وملكاته هو دون غيره من النقاد والباحثين، وعلى نحو يذكّر بتلك المهارات والملكات التي اجتمعت لعدد من الشخصيات التي أُغرم بها هو مثل: ابن حزم الذي اشتغل في حقول الأدب والفقه والفكر وتفرّد فيها، دون غيره من مجايليه الذين شاطروه كثيرًا من الظروف والمرجعيات والاهتمامات، لكنهم لم يُحدثوا ما أحدثه من بصمات راسخة. ومثل ابن خلدون الذي اشتغل أيضًا في حقول الأدب والفقه والفكر والتاريخ، وأورثنا تركة زاخرة من العلامات الفارقة دون غيره من أعلام عصره، الذين حالت مهاراتهم الفردية والجمعية دون اللّحاق بركبه. ومثل التوحيدي الذي اجتمع في شخصه الأديب والناقد والفيلسوف معا؛ فكان منه ما كان دون غيره من كتّاب عصره.
وللحق، فإننا لم نسق هذه المقدّمة جزافًا، ولكننا أردنا التمهيد بذلك للقول بأن إحسان عباس، ما كان ليبلغ ما بلغ من تفرّد وتميّز، لو لم يدرك مبكرًا حقيقة أن الثقافة الموسوعية - حسب التعبير الشائع- أو - الثقافة العابرة للتخصصات - كما نفضل أن نقول، هي الطريق الطويل الوحيد الذي يمكن أن يتكفّل للباحث، بإحراز قصب السبق في كثير من مشاغل الأدب العربي، قديمًا وحديثًا. لأن هذا الأدب يمثل حقيقة وليس مجازا، نتاج اشتباك طويل بين كثير من المعارف والعلوم مثل الفقه والمنطق والتاريخ والفلسفة وعلم الكلام والسياسة. وبالتالي؛ فإن الخوض فيها دون الإلمام بالقدر اللازم منها، أشبه بالسباحة وسط شلال هادر، وغالبًا ما يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه.
إن أية مقارنة بين ما كتبه إحسان عباس عن أرسطو أو عن التوحيدي أو عن ابن حزم أو عن ابن خلدون -على سبيل المثال لا الحصر - وبين جُلّ ما كتبه الآخرون، لن تقود إلا إلى نتيجة واحدة مؤدّاها، أن غنائم إحسان عباس قد كانت وافرة لأن عدّته قد كانت كذلك أيضا؛ فهو يمتلك القدر المطلوب من الثقافة الفقهية والمنطقية والتاريخية والفلسفية والكلامية والسياسية، ليتمكّن من تحليل وإعادة تركيب خطاب التوحيدي وابن حزم وابن خلدون وقدامة بن جعفر وحازم القرطاجي وغيرهم، فيما أن جُلّ مجايليه من الباحثين والدارسين، قد لامسوا هذا الخطاب ملامسات هيّنة خجولة، فضحت قلّة زادهم من هذه المعارف.
على أن هذه المروحة الواسعة من المعارف، تحتاج لمن يضمّها ضمّا شديدًا مُحْكَما، وبعبارة أخرى أن يسيطر هو عليها، لا أن تسيطر هي عليه. وقد وفّر علينا إحسان عباس جهد البحث عن هذا السلك الناظم، حينما وصف ابن رشيق قائلاً: (ابن رشيق ناقد بقوة شخصيته )! وقد عنى بذلك أن ابن رشيق لم يأت بجديد في كتابه (العمدة في نقد الشعر) لأنه استثمر - في الواقع - محفوظه الذي استمده من أمهات المصادر، فنسّقه ونظّمه بطريقته الشخصية ولغته الخاصة، حتى بدا كأنه من إبداعه، وحتى صار (العُمْدة) مرجعا أساسيًا من مراجع النقد العربي القديم.
مع ضرورة التذكير بحقيقة أن إحسان عباس قد كان مُجليًا في جلّ ما كتب؛ فإن - قوة شخصيته - كباحث وكناقد، تمثّل المدخل الذهبي لمنجزه النقدي، إذ هو يسيطر سيطرة لافتة على موضوعه، سواء أكان هذا الموضوع شخصا أم ظاهرة، فيبلغ مراده منه دون إطالة أو تسويف؛ كأن يترجم للشخص ترجمة مكثّفة ويسوق أبرز كتبه، ويلخّص أهم مقولاته ثم يحلّلها ويعيد تركيبها وفقا لقناعته ومنظوره الخاص. وكأن يؤرِّخ للظاهرة تأريخاً مكثّفاً، ويسرد أبرز أعراضها، ثم يلخّص أهم استنتاجاته، ويرتّب أحكامه عليها برشاقة وحسم.
ولعل أبرز حلفائه في إنجاز ما تقدّم لغته التقريرية الموجزة، التي تميل ميلًا بيّنًا إلى الاقتصاد الشديد والحسم، دون مواربة أو كناية أو تكلّف أو تصنّع أو إسفاف أو ركاكة. إلى درجة أننا نحس منه أحيانًا، ضيقًا في الصدر يذكّر بضيق صدر عبد القاهر الجرجاني في (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة). وإن كان هذا الاقتصاد اللغوي الشديد، قد عمل لصالحه في جل ما كتب من نقود وأنجز من تحقيقات، فقد عمل ضدّه في سيرته الذائعة (غربة الرّاعي)، إذ خيّم عليها التقرير والإيجاز، فبدت سيرة وظيفية أو كشف حساب قاس مع الذات. وإن كان تقدّمه في العمر يمكن أن ينهض بوصفه عذرًا وجيها له، فإن ما ران من حدّة في أحكامه على ذاته، يذكّر بما ران من حدّة على آراء ابن حزم بعد أن تقدّم في العمر أيضا.
لكن أطرف ما يمكن الإشارة إليه في سياق الكلام على منهجية إحسان عباس، هو اعتقاده بأن تحقيق المخطوطات عمل آلي يكاد يخلو من الإبداع، إذا قورن بالكتابة النقدية المحضة، وقد تمكنت هذه القناعة منه، إلى درجة أنه اعتقد بضرورة إلزام أقسام اللغة العربية بالتوقّف عن منح طلابها درجة الماجستير والدكتوراه، لقاء قيامهم بتحقيق المخطوطات! ولا ريب في أن هذه القناعة ستبدو صادمة جدا لكل من كانت خبرته قليلة في التحقيق وتهيّب ركوب أمواجه، لكن الصحبة الطويلة التي ربطت إحسان عباس بالنص التراثي - حتى صار طوع يده - جعلته يعتقد هذا الاعتقاد دون شك. وقد أدت به إلى رفد المكتبة العربية المعاصرة بعدد وافر من أمّهات المصادر، التي قد يصعب الآن على معظم المؤسسات الثقافية أن تصدر مثلها، إذا نظرنا بعين الاعتبار الشديد إلى المقدّمات الضافية التي قدّم بها لتحقيقاته، وإلى الدقة المتناهية والضبط الشديد والتكثيف المطّول، للأعلام والأماكن والمصطلحات.
تاريخ النقد الأدبي عند العرب نموذجًا
يمثّل هذا الكتاب واسطة عقد مؤلّفات إحسان عباس في النقد القديم، وقد أودعه خلاصة استقرائه للموروث الشعري العربي من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، وأمضى في تأليفه خمسة عشر عامًا (1956-1971). ويمكننا إجمال أبرز سماته الأسلوبية والنقدية والفكرية فيما يلي:
1- المراهنة على قوة شخصية الناقد : فقد كان سبّاقًا إلى التنويه بدور قوة شخصية الناقد في إيصال ما يريد لقارئه، حتى لو لم يكن مجدّدًا فيما يقول. وقد رصد على هذا الصعيد بروز شخصية أبي العلاء المعرّي، في تأويل خطاب المتنبي الشعري وفقا لمعتقده وفهمه في الحياة، كما سجّل لابن رشيق في كتابه (العمدة) حضوره المؤثّر، الذي أوهم كثيرا من الباحثين بأنه مجّدد ومبدع؛ مع أنه جامع وصاهر للآراء. وأما أبو هلال العسكري فلم يتردّد في وصفه بضعف الشخصية، على الرغم مما بذله من جهد على صعيد تنظيم وتنسيق كتابه (الصناعتين)!
2- عدم المراهنة على الثنائيات التقليدية مثل: القديم والمحدث والطبع والصّنعة والمبتكر والمسروق؛ لأن إحسان عباس رأى في هذه الثنائيات صيغة مبتذلة وميكانيكية، لتفسير الخطاب النقدي القديم وتحليله. وبدلاً من التورّط في قضية السرقات - مثلاً - التي استهلكت جهود النقاد لقرون متتالية، حتى عدّها مظهرا من مظاهر أزمة النقد العربي القديم؛ فقد اتجه لتشخيص الأزمة نفسها، وقد تمثّلت بقصور أدوات الناقد العربي التقليدي، عن مواكبة الإزاحات المتوالية التي راح يحدثها شعراء كبار، مثل أبي تمام والمتنبي والمعرّي. وهنا لا بد من التنويه بحقيقة أن إحسان عباس قد كان مقتنعًا تمام الاقتناع، بالدور الاستثنائي الذي يمكن للشاعر المبدع أن يضطلع به، على صعيد استفزاز وتحريض الخطاب النقدي.
3- التفريق بين الاقتناع بالمنهج وبين الإقرار بانسجامه؛ فعلى الرغم من أن إحسان عباس يقف على النقيض تمامًا، مما انتهى إليه قدامة بن جعفر في (نقد الشعر) - من حيث إن الشعر علم قائم بذاته ويمكن إخضاعه لمقولات المنطق اليوناني الصارمة - فإنه لم يدّخر وسعا للإقرار والإعجاب، بالتماسك البارز في الأطروحة النقدية، التي رفد بها قدامة بن جعفر حقل الشعر العربي من منظور فلسفي. ومما يدعو للإعجاب بإحسان عباس على هذا الصعيد، معرفتنا بحقيقة أن ميوله الفلسفية والمنطقية لم تؤدّ به إلى التسليم بصحة أحكام قدامة بن جعفر، على الرغم من إقراره له بالتماسك المنهجي. فإحسان عباس أكثر من يعرف أن الشعر عالم من الأخيلة والرؤى، التي يمكن تأويلها أو مقاربتها نسبيًا، لكنها تأبى دائما التنميط والتقنين.
4- التمرّد على سلطة الرّواة والأدباء؛ فعلى الرغم من تقديره الكبير للمكانة العلمية المرموقة التي تسنّمها رواة وأدباء مثل الأصمعي والمبرّد، فإنه لم يمار في أنهم ليسوا نقادًا محترفين، بل قطع بأنهم أدباء أو متأدبون يمكن النظر إلى محفوظهم الشاسع، بوصفه مرآة لثقافة أزمانهم. فالأصمعي وإن كان قد فتح بابًا كبيرًا في النقد، حين أكد أن لا ديانة في الشعر، يصعب التعامل معه بوصفه ناقدًا متمرّساً ذا منهج واضح المعالم. والمبرّد الذي فتح بابًا كبيرًا في البلاغة حين جاء على ذكر المجاز، وأكد ثبات المعنى على الرغم من تنوع أضرب الخبر، يظل لغويًا محافظا، وهو أبعد ما يكون عن الناقد المقصود.
5- المراهنة على القول باتجاهات النقد العربي وليس القول بالنظرية العربية في النقد؛ وهذه خلاصة متوقّعة تمامًا، إذا نظرنا بعين الاعتبار الشديد لحقيقة أن إحسان عباس ملم بالثقافة اليونانية أدبيًا وفلسفيًا، وأنه ملم أيضا بالثقافة العربية أدبيًا وفلسفيًا. ومثله لن ينزلق إلى ما انزلق إليه غيره من الباحثين، حينما وضعوا كل المنتج النقدي العربي القديم في سلّة واحدة، وأطلقوا عليها مسّمى ( النظرية العربية في النقد) أو (النظرية النقدية العربية). وإذا كان اليونانيون قد تمكّنوا - عبر أفلاطون وأرسطو -من صياغة نظرية كليّة في الأدب بحسناتها وسيئاتها، فإن العرب كانوا أبعد ما يكونون عن هذه الصياغة، لأن جهودهم النقدية جاءت فردية متباعدة من جهة، واحتكمت إلى كثير من المحرّكات والموجّهات الفكرية من جهة ثانية؛ فمنها ما كان انطباعيًا خالصا، ومنها ما كانت اللغة هاجسه الأول، ومنها ما كان مدفوعا بالآمر الأخلاقي الديني، فبدت لذلك مزيجًا من الآراء واللفتات والاستدراكات والخواطر، التي لا يجمعها جامع نظري مركزي، ولا يوجّهها محرّك فكري رئيسي.
6- المراهنة على تاريخ الأفكار بدلاً من التأريخ والتحقيق؛ فولعه بالتاريخ لم يؤد به إلى ممارسة الفهم الكمّي لهذا التاريخ، بل أدّى به إلى ممارسة الفهم الكيفي له. إنه يتحرّك دائما باتجاه اختيار المحطّات البارزة فيه شخوصا وظواهر، ولا يسمح لنفسه بالتورّط في السرد الزمني الميكانيكي، كما لا يسمح لنفسه بالاستغراق في تفاصيل السيرة الذاتية، لمن وقع عليهم الاختيار من النقاد . لقد أدرك بحكم استيعائه العميق لجوهر المقدّمة الخلدونية، أن أهمية التاريخ تكمن في رصد تحوّلاته الكبرى، وليس في الانصياع الآلي لتعاقبه ليل نهار. ولهذا نراه يقفز من سيرة الناقد إلى أفكاره ويستخلص من ذلك ما يريد، ويقفز من ناقد في المشرق إلى ناقد آخر في المشرق من باب الحرص على متابعة سلسلة الأفكار، حتى إذا اطمأن إلى أن المشرق لم يعد لديه ما يقدمه من أفكار، طار إلى المغرب والأندلس.
7- المراهنة على الفكر النقدي بدلاً من النقد الأدبي المحض؛ فولعه بالفلسفة والمنطق والفكر بعامة، أدى به إلى إدراك حقيقة أن النقد الأدبي الخالص - بعيدا عن استجلاء ملامح (نظريات الأدب) التي تقدّم بها الفارابي وابن سينا وابن خلدون - لن يقودنا إلا إلى الدوران في حلقة مفرغة، من الآراء والتطبيقات الجمالية الشكلانية، وإلى الحد الذي سيفقدنا التمتّع بأبرز مزايا النقد العربي القديم، ممثلة في تلك الأطر المرجعية التي انطلق منها هذا النقد، ونعني بها الفقه وعلم الكلام والفلسفة.
تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي نموذجا آخر
لم يستأثر هذا الكتاب - وكذلك سابقه (تاريخ بلاد الشام من ما قبل الإسلام حتى بداية العصر الأموي) ولاحقه أيضا (تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك) - بما يستحقه من عناية الباحثين والدارسين، وخاصة إذا نظرنا بعين الاعتبار الشديد، لحقيقة أن إحسان عباس قد أودع هذه السلسلة من الكتب، أفضل مهاراته وملكاته على صعيد كتابة التاريخ وتفسيره ونقده.
رصد إحسان عباس في هذا الكتاب، حقبة تمتد من العام 132هـ حتى العام 255هـ، وأبرز أخطر ما اشتملت عليه من أحداث وظواهر وسمات، لعل أهمها: أُفول نجم الأمويين وقدوم العباسيين، بأعلامهم السوداء وسيوفهم المشتاقة لرؤوس أهل الشام. ويمكننا أن نُجمل أبرز ملامحه فيما يلي:
1- عُني الفصل الأول من الكتاب بتحقيق مشهد خضوع الشام والجزيرة للعباسيين، وما لحق بهذا المشهد من تلوين تاريخي كثير أو قليل.
2- انشغل الفصل الثاني بتتبّع مسلسل الفتن الداخلية، كثورات الخوارج وفتن القبائل وتململ الفلاّحين وانتفاضات المدن من ناحية، ورصد سجال العرب والروم من ناحية أخرى.
3- انشغل الفصل الثالث بترسيم ملامح العمران في هذه الحقبة، واستعراض ما آلت إليه الأمور بعد طرد الأمويين.
4- يقدّم الفصل الرابع خارطة للبنية الثقافية التي أُنتجت أثناء هذه الحقبة، دون التغاضي عن جملة المؤثرات الخارجية التي فَعَلت في هذا المنتج. وقد عزّز إحسان عباس هذا المنتج بجملة من الملاحق أهمها: رسائل الإمام الأوزاعي ومواعظه والمنسوب إليهم القول بالقدر من الشاميين، وأهم مؤلفات الشاميين ومدرسة القراءات وعلم الحديث عند الشاميين.
وإذا كان التاريخ الثقافي لبلاد الشام خلال هذه الحقبة، يمثّل أبرز ما أودعه إحسان عباس في هذا الكتاب، فإن الإمام الأوزاعي يمثل أبرز علامات هذا التاريخ دون منازع؛ إذ إن أثره لم يقتصر على صياغة مصير هذه المنطقة فحسب، بل امتد ليؤثّر في صياغة منطقة ثانية على الجهة الغربية من البحر المتوسط، جهد طوال قرون في أن تكون وجها مطابقا للمنطقة الأولى وأعني بها الأندلس.
إن الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر (88-157هـ)، هو الممثل الأكبر للمدرسة الشامية في الحديث والسِّيرَ والتاريخ والفقه. وبالقدر الذي فعلت بيئة الشام فيه، فقد فعل هو فيها. ولا شك في أن طيب المناخ والميل إلى الزراعة وتمازج الأجناس والأديان، قد عبّرت عن نفسها مجتمعة من خلال مذهبه المعتدل؛ فهو من حيث المبدأ يلتزم النص من قرآن وحديث ولا يرى بأسا في التوسّع قليلاً، أخذا ببعض ما قام به الصحابة مثل عمر بن الخطاب. وله حظ من الرأي في مسائل أملتها طبيعة الحياة الشامية، مثل حكمه بأن ما أخطأته يد الحاصد أو جنته يد القاطف، فليس لصاحب الزرع عليه سبيل؛ إنما هو للمارة وابن السبيل، مسايرةً منه لعرف شامي شائع. وهو يضيق بالبدعة وينهى عن الجدل نهيا قاطعًا، بأسلوب هو إلى النصيحة أقرب منه إلى الزّجر.
ولعل هذه المرونة في التعاطي مع شؤون الدين والدنيا، هي ما مكّنه من الاحتفاظ بنفوذه الكبير في ظل الدولة العبّاسية، على الرغم من ولائه الأقوى السابق. بل إن هذه المرونة جعلته قادرا على الاضطلاع بمهمة الناصح الأمين والواعظ الحازم، لخليفة جبّار مثل أبي جعفر المنصور، ما سهّل عليه التدخّل من حين لآخر، رفعا لضيم أو إصلاحا لخطأ.
ويبدو أن ترفّق الأوزاعي، في الإنحاء على من قال بالقدر من الشاميين، وغيرهم من الفرق مثل المرجئة، قد آتى أُكله لاحقا، في صورة تضاؤل دعوتهم، مقارنة باشتداد القدرية وغيرهم من الفرق في العراق، التي شهدت صراعًا داميًا بين السُنَّة ممثلة بابن حنبل والمتكلّمين ممثلين بالمعتزلة، حيث أسهم تصلّب الحنابلة، في تفجير مواجهة شرسة، طالت الشام وعلماءها بإيعاز من المأمون.
لقد أرسى الأوزاعي وتلاميذه، مجموعة من التقاليد والأعراف التي غدت بمرور الوقت ميسما مميزا لمدرسة الشام في العلم، أهمها : الاعتماد على السماع المباشر، وعدم التشدّد في الإسناد إبّان المرحلة الأولى، والانقطاع إلى العلم حد الإملاق، والاعتماد في السير والمغازي على أسلوب السؤال والجواب، وعدم الاعتناء بالسرد التاريخي المنظّم للمعلومات التاريخية كما نلحظ لدى الواقدي.
ومع أن الشام حلّت محل الجزيرة العربية وجنوب العراق - على صعيد إطلاع جيل من الشعراء- إلا أنها لم توصل إلى عاصمة الخلافة العباسية من هؤلاء الشعراء سوى القليل، وذلك لأن معظمهم ظل يحوم في بلاد الشام. وأما من قصد بغداد منهم فقد رفع لعاصمة الخلافة العباسية ألوية خفاقة إلى يومنا هذا، وأعني بذلك الطائيين أبا تمام والبحتري. وإذا ما نحن صوّبنا النظر إلى النثر الشامي أثناء هذه الحقبة، لم نجد في هذا النثر ما يستحق الإشارة، سوى رسائل الأوزاعي التي أثبت إحسان عباس طائفة منها.
لقد أبرز إحسان عباس في هذا الكتاب، الحدث الجوهري في تاريخ الحقبة المدروسة، ونظمه في سلك زمني متصل، كما ربطه بالمحيط الموضوعي، وفق قانون الطّرد المركزي للهامشي والخيالي والمشكوك فيه، ثم دفع بالمسكوت عنه إلى سطح الحدث التاريخي، اعتمادا على القراءة المقارنة لنصوص التاريخ الإسلامي والنصوص الأخرى، أو باستقراء المسكوكات والآثار المكتشفة.
واستعاض أيضا عن اللّهاث خلف حركة الزعيم الفرد، بتتبع حركة الإيقاع الجمعي للمشهد التاريخي، اعتمادًا على رصد حراك العامة وردود أفعالهم. على أن أخطر ما يمكن التوقّف إزاءه فيما كتبه إحسان عباس - عن المزاج النفسي والفكري لبلاد الشام في هذه الحقبة - هو التقبّل الجماعي لفكرة المنقذ أو المخلّص المنتظر، الذي ارتبط لا شعوريا ببني أمية، وقد ظلّت هذه الفكرة تعيد إنتاج ذاتها من خلال أكثر من ثائر ومتمرّد، اعتمادًا على هذا الميل العام.
