عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
يوسف بكّار في حَفْرياتِه.. تختلِفُ القراءاتُ باخْتِلافِ النَقَدَة
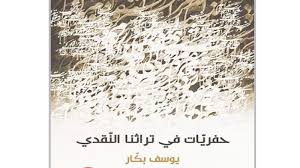
الدستور-إبراهيم خليل
في كتابه حفريات في تراثنا النقدي يواصل الدكتور يوسف بكار تتبعه للأنظار النقدية العربية القديمة من زاوية المقابلة والموازنة والمحاذاة. ممهدا لهذا بالحديث الشيق عن مصطلح «القراءة « فهو مصطلح – في رأيه – وإن كان جديدا شاع في أواخر القرن الماضي، إلا أنه من حيث المدلول والوظيفة مصطلح قديم، فالقدماء كانوا بدورهم يقدمون ما يجوز وصفه بالقراءة الجديدة، والمتعددة، للمتن الواحد، أو البيت، أو المجموعة من الأبيات. ويختلفون اختلافا شديدا، أو يسيرا، في تأويلاتهم، وتقويمهم لما في الشعر، والنثر من حسن النظم، أو ما يعرض لهم فيه من ركاكة، ومعاظلة، أو خروج سافر، أو شبه سافر، عن حدود المنطق.
وفي هذا المقام لا مندوحة لنا من الإشارة لحقيقة لم يشأ المؤلف إثارتها، والتنبيه عليها، وهي تعدد الشروح للنص، أو المتن الواحد، فلا يخفى على متابع أن عدد شروح المعلقات يربو على سبعة عشر شرحًا، وهذه الشروح إذا قوبل بعضها ببعضها الآخر تبين لكل ذي عقل أن فيها اختلافات في التفسير، وتباينات في الفهم والتأويل، وفروقا في تحديد الدلالات، وتشخيص المعاني(1). علاوةً على المعلقات نجد شروحا بمثل هذا العدد للمختارات؛ من مفضليات وأصمعيات وحماسات، عدا عن الشروح المتعددة للدواوين، فمن يقرأ شرح أبي العلاء المعري لديوان أبي الطيب المتنبي سيجد فيه الكثير الجم من الاختلاف عن شرح ابن جني الموسوم بالفَسْر، أو في شروح غيرهما من معاصريهما، والمتأخرين.
وهذا كله، لا بعضه، يؤكد الرأي الذي يذهب إليه د. يوسف بكار في كتابه القيم هذا. فالقراءة الجديدة، والقراءات المتعددة للأثر الأدبي الواحد، ليست شيئا جديدا يتيه به المحدثون، ويتباهون، بل هو شيء قديم قِدَم الأدب نفسه.
فبيت حسان بن ثابت الذي سبّب خلافا بين الشاعر والنابغة الذبياني في عكاظ، وهو الذي يقول فيه:
لنا الجفناتُ الغرُّ يلمَعْنَ في الضحى
وأسيافُنا يقطرْنَ من نَجْدةٍ دما
تداوله النَقَدةُ، والشراح، واختلفوا فيه، وفي مرماه، وتباينوا في تقدير قيمته ومعناه، وكذلك في مزيته الجمالية من حيث هو بيت في الفخر، وهو ضرب من ضروب الشعر له قِيَمُهُ، وله معاييره. فالنابغة الذي لم يستحسن البيت يزعم أن الجفنات جمع للقلة، وليس يليق بموضع الفخر بالكرم اعتماد هذا الجمع، فلو قال (الجفان) لكان في ذلك دليلٌ أصحُّ على الكرم والبذل والعطاء. واعترض على كلمة أسياف للسبب ذاته، ولو قال الشاعر سيوفنا بدلا منها لكان أقرب إلى الفخر، وأدلَّ على كثرة الفرسان. وهذه هي قراءة النابغة، الذي هو من هو في الشعر، والمحاكمة النقدية، وقد أنكر بعضهم هذه الرواية جملة، لأن مصطلحات جمع القلة، والكثرة، لم تكن معروفة، ولا متداولة في زمن النابغة، وحسان. وهي من صناعة النحاة كالخليل، وسيبويه، وهذا ينم على حقيقة خفيت على كثيرين، وهي أن الرواية مختلقة بلا ريب.
وممن توقف عند هذا البيت، وقرأه قراءة أخرى قدامة بن جعفر، وهو مَنْ هو في البلاغة واللغة والنقد، وكتابه «نقد الشعر» من المتون النقدية التي لا تخفى قيمتها إلا على الجهلة بالنقد العربي وتاريخه. فقد رأى في قول حسان (الجفنات الغُرّ) ما لم يره النابغة ولا غيره ممن شايعوه، فالجفنات ذكرت في كتاب سيبويه على أنها للتكثير، والغرّ، أي: المشهورة، وليس البيض لونًا. ولا ريب عنده في أن لحسان خيارًا آخر أنسب لو ذكر الدُجى، عوضا عن الضحى، وقد فضَّل يقطرْنَ على يجرين؛ لأن المعروف عن السيف الذي يُفتخر به هو مشهد الدم الذي يقطُرُ منه، ولذلك قال الآخر:
ولسنا على أعقابنا تُدْمى كلومُنا
ولكن على أقدامِنا تقْطرُ الدِما
فقدامة - على وَفْق هذه القراءة - يراعي ثلاثة أشياء: جمالية الملفوظ الشعري، و ما هو طبيعي وشائع لدى المجتمع في هذا الموقف الذي هو موقفُ فخر، و الالتزام بحدود المنطق. فتفضيله الدجى على الضحى تفضيلٌ يقوم على أن الجفنات إذا كانت تلمع في الضحى، فهذا اللمعان لا يلفت النظر، ولا مزيّة فيه، وإنما اللافت أن تلمع في الدجى، لا في رابعة النهار.
وكان د. بكار قد حقَّق، ونشر، ديوان الشاعر زياد الأعجم، و استوقفه بيت يصف فيه كلب أعرابيٍّ مضياف اعتاد الترحيب بالطارئين ليلا، أو نهارًا، على حين غرة:
يكادُ إذا ما أبْصَرَ الضيف مُقبلا
يكلِّمُه من حبّه، وهو أعجـــــمُ
ولهذا البيت رواية أخرى بذكر (تَراهُ) بدلا من (يكاد). والبيت متنازع في نسبته بين زياد الأعجم، وابن هرمة، وهذا ليس موضوعنا، ولا موضوع المؤلف، ولكن موضوعنا - ها هنا - هو ما القراءات المتعددة لهذا البيت، وكيف أوضحت كل قراءةٍ ما فيه من حسْن التأتّي، وقوَّة الاستعارة؟
وأول من استوقفه هذا البيت منتقدًا قدامة بن جعفر، فقد اعترض على الشاعر اعتراضا معياره المنطق، إذ نسب للكلب الكلام، ثم وصفه بالأعجم. وهذا تناقضٌ كوصفك الشيء بالساكن أي بالمتحرك. وقد رد على هذا الاعتراض النقدي الشريف المرتضي، زاعما أن القائل لم يقصد الكلام الذي ينطق به الإنسان، وإنما قصد به المعنى العام، وهو الحركات – أي كلام الجسد ولغته- التي يومئ بها الذيلُ إيماءً يشبه الكلام الملفوظ عند الإنسان. وقد أعْجِبَ المرزوقي بهذا التخريج، ووجد فيه قراءة تذكره بما يقوله عنترة:
فازورّ من وَقْع القنا بِلَبانهِ
وشكا إليّ بعَبرةٍ وتحَمْحُمِ
وهذا لو كان في بيت زياد الأعجم لأرضى قدامة، فهو أقربُ إلى المنطق الذي لا يُتطلَّبُ في الشعر. ويرى د. بكار أن الذي يخالف المنطق هو قدامة، لا الشاعر، فالشعر لا يُقرأ في ضوء البدائه الرياضية، أو الهندسية، فقدامة نفسُه لا ينفي عن الشعر مبدأ الكذب ( أعذب الشعر أكذبه) تارة، والغلوّ تارة أخرى، فأين هذا من المنطق الذي يريده؟!
وأما ابنُ سنان الخفاجي (466هـ ) صاحب «سر الفصاحة» فردّ في قراءته للبيت على قدامة، مؤكدا أن الأعجم ليس الأخْرس، الذي انعدمت لديه القدرة على النطق، وإنما هو الذي لا قدرة لديه على الإفصاح، وإنْ تكلم، لقوله تعالى في الآية 103 من سورة النحل (لسان الذي يلحدون إليه أعجميٌّ وهذا لسان عربيٌ مبين) بيد أنّ ابن سنان - وإن كان بلاغيا - إلا أن ما خفي عليه - ها هنا - هو الاستعارة في كلمة (يكلمه) وما فيها من التشخيص، وهي لا تقتصر على المعنى وحده، بل ما فيها من التصوير الجمالي. أما حازم القرطاجني صاحب منهاج البلغاء (684هـ) فقد عرض لما سبق من قراءات للبيت، وما فيه وفيها من التقصير، ومن سوء الاحتراس، في قوله (وهو أعجم) وقد اجتهد اجتهاده، ففسَّر مراد الشاعر بيكلمه تفسيرًا مجازيا. يتفق من حيث المبدأ مع قراءة الشريف المرتضي. إذ يقول: لم يعنِ بالكلام اللفظ، وإنما عنى به إشارة من لا يستطيع النطق. ولهذا فهو مع الرواية التي تؤكد ابتداءَه بيكادُ لا بتراهُ. وهذا التحليل - في رأينا - ليس ببعيد عن الدقة، لأن (يكادُ) من أفعال المقاربة، وبهذا ينفي أنه أراد النطق، حكمًا، ويعزو وضوح المعنى، واستبانة هذا المرمى، للمخاطَب، تاركا هامشا كبيرًا للفهم، والتأويل. فبقوله (يكادُ) احتراسٌ يضاف لاحتراسه في (وهو أعجم). وتفسير حازم هذا يورد قراءته هذه مَوْاردَ التخييل، والمحاكاة، وذلك مما لا ينكره قدامه في الكثير الجمّ من آرائه، وموقفه في ذلك كموقف القرطاجني، وغيره، من قول المثقِّب العبدي الذي ينسب للناقة كلامًا من باب التمثيل، والاستعارة، التي تتأبّى على المنطق:
تقول إذا درأتُ لها وضيني
أهـذا ديـنُـُه أبــدًا وديني
أكلَّ الدهر حِـــلٌ وارْتِحــالٌ
أما يُبْقي عليّ ومـا يقيني
عمود الشعر:
وقد لفتَ نظرنا في هذا الكتاب القيِّم، واستأثر باهتمامنا، الفصل الموسوم بعنوان (أصولُ عمود الشعر) وسبب هذا الاهتمام اللافت للنظر شيوع الخطأ القائم على تصنيف الشعر العربي الحديث، وقسمته على نوعين، هما: حرّ وعمودي. فيقول لك القائل قصيدة « تنويمة الجياع» للجواهري قصيدة عمودية، أما قصيدة أنشودة السياب للمطر فحرَّة. وهذا تصنيفٌ خاطئٌ شاع شيوعا كبيرًا يذكرنا بالمثل القديم:» اتسع الخرق على الراقع «. وقد عرفت واحدا من حملة الدكتواره في العربية، ومن الملقبين بلقب أستاذ، أي: (بروفسور) يرتكب هذا الخطأ أمامي كثيرًا، وأوضحتُ له ما هو التصنيف الصحيح، وأن عمود الشعر لا شأن له بهذا، فظلَّ على دأبه يصنف كل ما هو موزون مقفى على بحور الخليل شعرًا عموديًا، على الرغم من أن بعضه لا يلتزم فيه شعراؤه بأيّ قاعدة من قواعد هذا العمود السبع، الذي هو موضوع الفصل الذي عُني فيه الدكتور بكار بجلاء اللبس، وإزالة ما علق به من الخلط والطَمْس.
فعمود الشعر لفظ استُخدم للمرة الأولى في الموازنة بين الطائيين للأمدي، وإن كان البحتري الشاعر هو أول من استخدمه في إشارة لمذهب العرب القدماء في شعرهم، وهو مذهبٌ لا يتسق مع مذهب المحدثين أمثال بشار وأبي نواس وأبي تمام من المحدثين. وقد شاع خطأً أن صاحب هذه الفكرة هو المرزوقي في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام. والصحيح الذي لا مِرْية فيه، ولا جدال، أن المرزوقي هذا ألمَّ بجلّ ما جاء عند السابقين من قواعد، وأصول، جمعها، وبوَّبها في نسق يشبه نظرية لنقد الشعر، تقوم على قواعد سبع، أولاها شرف المعنى وصحته. أيْ أن يكون من أحسن المعاني تداولا في موضوعه، فثمة معان تحسُن في الغزل، ولا تحسن في المدح، أو الفخر، وصحة المعنى أي ألا يتضمن في جزءٌ منه ما يناقض الجزء الآخر، كقول الشاعر:
تلذّ له المروءة وهي تؤذي
ومن يعشقْ يلذّ له الغرامُ
فإنّ لفظة تؤذي نقضت ما سبق. فهذا ينفي عن البيت صحّة المعنى. ومن قواعده جزالة اللفظ واستقامته، والبيت المذكور حجّة على هذا، فالجزالة فيه متوافرة، لكن البيت لا يستقيم فيه النظم ما دام العشق، ولذة الغرام، لا صلة لهما بما في صدر البيت من حيث أن المروءة تلذ، وتؤذي. لذا خرج هذا البيت في عجزه عن شرط الاستقامة، أو التناسب، مع أن الشطر الثاني يمكن أن يُعد تذييلا جاريًا مجرى المثل.
أما الإصابة في الوصف، فتعد قاعدة نسبية، ولا تحتاج لشواهد عليها، ومن قواعده أيضا المقاربة في التشبيه، أي أن يكون المشبه والمشبه به متقاربين، وكل منهما يليق بالآخر، فمن التشبيهات التي لا يستقيم فيها هذا قول أحدهم:
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها
شمس الضحى وأبو إسحق والقمر
فقد اعترض أكثرُهم على هذا التشبيه، لأن الشمس والقمر تشرق بهما الدنيا، فأين أبو إسحق من ذلك؟ فأركان التشبيه ها هنا لا ينسحب عليها، ولا يتسق، مبدأ ملاءمة المشبه للمشبه به، أو العكس. ولا مقاربة المستعار منه للمستعار له. والقاعدة السادسة الأخرى هي ائتلاف اللفظ وتلاحمه على متخير من لذيذ الوزن. ويحسن بهذه القاعدة أن تكون اثنتين في رأينا، لأن التئام ألفاظ القصيدة شيء والوزن شيء آخر. فالأثر الذي يسفر عنه التئام النظم هو تفاعل المتلقي بالمحتوى، في حين أن لذيذ الوزن يسفر عن الطرب، وعن الإحساس بالنشوة الناتجة عن الموسيقى، لا عن ائتلاف النظم والتحام أجزائه. وهذه القاعدة وقف منها القدماء وقفة صارمة، إذ أُخذ على غير شاعر جمْعُه لأشياء في البيت لا تتفق، ولا تنسجم، كقول أبي تمام:
لا والذي هو عالمٌ أن النوى
صبرٌ، وأن أبا الحسين كريمُ (2)
فلا شيء يجمع بين النوى وأبي الحسين الممدوح. وهذا من الأصول التي ما تزالُ من المعايير التي تنم على الجودة، فإذا خلا منها النصُّ خلوًّا لافتا دلَّ على فساده. أما القاعدة السابعة والأخيرة فهي مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائها للقافية. ومنهم من عد المشاكلة ائتلاف اللفظ والمعنى، ومنهم من أشار لإئتلاف اللفظ والوزن.
وأيا ما يكن الأمر، فإن الدكتور يوسف بكار عنّى نفسه كثيرًا بجمع هذه القواعد، والأصول، من مظانها المتعدِّدة. فعاد بنا إلى طبقات ابن سلام الجمحي، فالبيان والتبيين، وإلى الحيوان، فبرهان ابن وهب، فإلى عيار ابن طباطبا العلوي، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر، فوساطة القاضي عبد العزيز الجرجاني، فحلية المحاضرة للحاتمي، وكتاب التشبيهات. ولغيرهم من قدماء الناقدين، ومتأخريهم، كإحسان عباس، وبدوي طبانة، ومحمد زغلول سلام، وزكي نجيب محمود، وأحمد بدوي. وفي ذلك من العناء الشيء الكثير الذي يُشكر له شكرا موصولا، ويحمد له حمدا كبيرا. بيد أن مفهوم عمود الشعر الذي تكلم عليه المرزوقي، وغيره، لا يستحق منا كل هذا العناء، ولا هاتيك المشقة. فقواعدهُ، وأصوله، لا تشكل - في رأينا- مادة نظرية تصلح لتطبيقها في نقد الشعر؛ قديمه وجديده. فما الذي يفهم - على سبيل المثال - من شرف المعنى. فوصف المعنى بالشريف، أو الوضيع، وصف غامضٌ، مبهم، فما قد يكون شريفا في موضع قد يكون وضيعًا في غيره، وما هو شريف عند قارئ، يجوز أن يكون بعيدًا عن الشرف لدى قارئ آخر. علاوةً على أن تركيزهم على المقاربة في التشبيه تارَةً، وملاءمة المستعار منه للمستعار له تارةً، قواعد يصعب القبول بها، والامتثال لها، لأنَّ من الشعر شعرًا يبهر المتلقي مع أنه لا يستقيم مع هذه القاعدة، أو مع القاعدتين، بكلمة أدق، فهذا أبو تمام يخاطب المعتصم:
بَصَرْتَ بالراحةِ الكُبْرى فلم تَرَها
تُنالُ إلا على جسْر منَ التَعَبِ
فقد استعار الجسر، وهو مما لا يلائم، ولا يناسب المشبه، وهو التعب. لكن الصورة جاءت في غاية الجمال، والسحر، والألق. وهذا يَنْسحب على الكثير جدا من شعر المولدين، مما دعا للقول بأن هذه القاعدة أعاقت الشعر لزمن غير طويل عن ارتياد آفاق مبتكرة من المجاز الشعري؛ فهي كالقيد الذي يَحُدُّ من حرية الطليق فتجعله أسيرًا كالسجين. كذلك قولهم «على متخير من لذيذ الوزن «: قول لا معنى له في رأينا، لأنه يقوم على تصوُّر افتراضي غير صحيح، وهو الفصل بين القصيدة، ووزنها، فكأنَّ الشاعر يؤلف القصيدة أولا، ثم يختار لها وزنا لذيذا، وهذا ضرْبٌ خاطئٌ من الظن.
صفوة القول هي أنَّ هذا الكتاب يعيد النظر في غير قليل من القضايا اللائذة التي غفل عنها الباحثون، ولم يتنبه لها النقدةُ إلا النُدْرة منهم، والدكتور يوسف هو أحد هؤلاء النُدْرة.
***
1.انظر الشطي، سليمان، المعلقات في عيون العصور، ط1، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون،2011 ص ص 41- 69
2.أبو تمام، حبيب بن أوس، ديوان أبي تمام بشرح التبريزي،ط1، القاهرة، دار المعارف، جـ 3 ص 290 وانظر تعليق عبد القاهر الجرجاني عليه في دلائل الإعجاز، ضبطه وعلق على حواشيه: رشيد رضا، ط1، بيروت: دار المعرفة 1981 ص 173 .
