عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
نظرات في المجموعة الشعرية ذئب المضارع
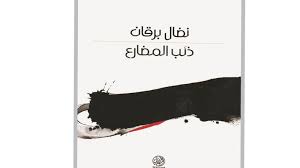
الدستور-منال العبادي
سيميائية العنوان:
لو توقفنا عند الدلالة الرمزية لكلمة «ذئب»: فهي ترمز إلى التوحش، الخطر، الافتراس، والقلق الوجودي، وقد يشير إلى صراع الشاعر مع الزمن، الموت، أو الذات.
أما مصطلح «المضارع»، يحيل إلى الزمن الحاضر في اللغة العربية، ممّا يوحي بصراعٍ مع اللحظة الراهنة، أو هيمنة الواقع المؤلم على الحاضر وعند المزاوجة بين الكلمتين تخلق مفارقةً بين الوحشية (الذئب) والزمن المتجدد (المضارع)، ليعكس صدامًا بين الثبات والتحول، أو بين الفناء والاستمرارية.
العنوان يلمّح إلى أن «المضارع» (الحاضر) ليس بريئًا، بل هو كائن مفترس يهدد الذات والإبداع، ممّا يضفي طابعًا دراميًا على المجموعة.
المتمعن بالمجموعة يجدها قد امتلأت بثيمات عديدة مثل: الفقد والغياب حيث أكثر الكاتب من تكرار رثاء الغائبين («إلى ضحايا غيابك»، «الخسارة تربح»)، و التركيز على الموت كخسارة وجودية كما عمل على توظيف الصور العائلية كرمز للذكريات والأشباح التي تطارد الحاضر.
وكان الاحتلال والحرب حاضر الوجود بين ثيمات المجموعة كقصيدة «أغنية حب من أجل غزة» تُجسّد معاناة الفلسطينيين، بدمج البطولة («العاشقين.. قضوا نحبهم واقفين») والقسوة («أبٌ يحمل أصغر أبنائه»).
ركز الكاتب على الوحدة والعزلة أيضا من خلال «كرنفال الوحدة» حيث تصف العزلة كاحتفال مرير، ويُستبدل التواصل البشري بالكحول والصمت.
لا تخلو المجموعة من الأمل من خلال ثيمة الحب والعلاقات الإنسانية، فالحب يُصوَّر ملاذًا من القسوة («أيها الحب: شكرًا»)، لكنه أيضًا مصدر حيرة («هل أضعتُكِ؟»).
وقف برقان وقفة الشاهد بين الشعر واللغة يستعرض الصراع مع الإبداع («في عجاج القوافي»)، حيث تصبح القصيدة «بئر مجاز» عميقة، واللغة أداةً للضياع أو الخلاص.
تميزت لغة المجموعة بالمراوحة بين البساطة والتعقيد واستخدم لغة يومية في صور العائلة («خمس بنات وصبي»)، ثم تنقلب إلى مجازية غامضة («ذئب مجاز يبحث عن دمه بدمي») وعمل على توظيف اللهجة المحكية مثل «الطبليّة»، «صُبّها»، ممّا يضفي واقعيةً على النص أن التنويع بين الشعر التفعيلي (بحور الخليل) والنثر الشعري («صور عائلية»)، مع إيقاع متقطّع يعكس اضطراب الذات كما أنه تعمد تكرار كلمات مفتاحية «المعتاد»، «الصورة»، «الخسارة»، لخلق تأثير تراكمي.
ومن الواضح تميز المجموعة بالمفارقات اللفظية مثل «الخسارةُ تربحُ» (مفارقة بين الخسارة والربح) «سماءٌ قتلت نفسَها» (تحويل الكون إلى كائن فانٍ).
القارئ للمجموعة يلمس كمية الاستعارات المدهشة التي تم توظيفها كـ»ذئب مجاز»، «بئر مجاز»، «عتمة الروح»، مع تحويل المفاهيم المجردة إلى كائنات حيّة.
نلمس أيضا استخدام الكاتب للتشخيص كـ»الخسارة تربحُ وتختار قلبي»، «رياح تخفق بجانب النافذة.»
فعّل برقان الرمزية بمجموعته ومن الأمثلة على ذلك:
-رولا» التي ترمز إلى الحب، الأرض، أو الأمل المتجدد، وتظهر كملاذ من العزلة («يا رولا... كم أحب النداء عليك»)
-غزة»: هي رمزٌ للصمود والألم الجماعي.
ومن المفارقات التي تلمس قلب القارئ قبل عينيه
«لا فرق بين الذي وجد الله.. أو ضيعه» (في «كرنفال الوحدة»)
«أنت غيركِ.. أنا غيري» (في «نافذة المتدارك»)
كانت المجموعة غنية بالأساليب البلاغية،
كالجناس («تعتع الليل من تعتعا»)، والطباق («أبعدَ من أن يحاولَ فيكَ مجاز/ أقربَ من أن تحيطَ بك عين»).
والتكرار مثل تكرار «إذن» في «الخسارة تربح» لخلق إيقاعٍ تأملي.
إن المجموعة عبارة عم مزيج بين الشعر والسرد في «بئر مجاز» يُصبح الكلام حكايةً عن الضياع.
كما استخدام مصطلحات عروضية («متفاعلن»، «نافذة المتدارك») وإحياء الصور الصوفية («حديقة موغلة في التسابيح»).
وتوجه للحداثة وتفكيك اللغة («كلامي أضحى مبهماً»)، ومساءلة الذات («من أنا؟»)
لم ينس الشاعر فلسطين وخصوصيتها فلقد أعطاها مساحة كبيرة (للخصوصية الفلسطينية) والجمع بين الهمّ الشخصي والجماعي (غزة، الشهداء، المنفى)
هذا ما عزز التراث وإبراز الهوية الشعرية لدى الشاعر.
من زاوية أخرى لو نظرنا إلى الذات الشاعرة كـ «ذئب المضارع» وتحليل الرمز في هوية الشاعر.
وعملنا على تطابق صفات الذئب مع هوية الشاعر.
من صفات الذئب الافتراس وتجلت هذه الصفة في شعر برقان بافتراسُه للحقيقة والكلمات: «ذئب مجاز يبحث عن دمه بدمي» – صراعه مع اللغة كفريسةٍ وجودية
كما يتصف الذئب بالوحدة/ العزلة وكان في المجموعة انعكاسها في «كرنفال الوحدة»
الذئب كائنٌ منفردٌ، ووجدنا بان الشاعر يعيد تشكيل عزله كفنٍ مقاوم
كما يتصف الذئب بالحدس والحذر لنجد بان برقان يظهر لنا يقظته لخطر الزمن («المضارع») وترصُّده لتهديدات الحاضر (الاحتلال، الموت، الضياع)
ومن أهم صفات الذئب الولاء للقطيع لنجد برقان متمسكا بهويته الجمعية: ذئبٌ ينعق باسم «غزة» و»رولا» كرموزٍ للانتماء المُفترَس.
وأخيرا المطاردة/ الصيد من صفات الذئب لنجد برقان يطارد المعاني في عتمة الوجود: «أبحث عن دمي» – بحثٌ عن جوهر الذات وسط فوضى العالم
ولو أمعنا النظر بالمفارقة التراجيدية في هذا التوصيف لوجدنا الشاعر
ذئبٌ في قفص هذا الزمن.
و»المضارع» سجنٍ وجودي رغم افتراسه للحظات، فهو أسيرٌ حاضرٍ لا يمتلك سوى أنيابه (قصيدة «هل أضعتُكِ؟»).
الوحشية الناعمة فهو ذئبٌ يلعق جراحَ الغائبين («إلى ضحايا غيابك») – افتراسُه تحوّلَ إلى رثاءٍ ورعايةٍ للضحايا. وأصبح عواؤه بلا صدى. وصوته الشعري («عجاج القوافي») كعواءٍ في صحراء اللامبالاة المعاصرة، خاصةً في نصوص مثل «بئر مجاز»
لماذا لا اختار الشاعر الذئب تحديدًا؟
هل كان خرقا للصورة النمطية وأنه ليس ذئبَ شرٍّ تقليدي، بل ذئبٌ ضحيةٌ لفعل الافتراس نفسه «ذئب مجاز» يجرح نفسه بسؤال الهوية («من أنا؟») أم أنه اتصال بالتراث الرمزي في الموروث العربي، الذئبُ صاحبُ عزة ووفاء أم أنه (كذئب يوسف) تم ظلمه، وقام برقان بإسقاطه كرمز للجرح الفلسطيني.
«أبٌ يحمل أصغر أبنائه» (في نص غزة) الذئب الأب الذي يُهاجم قطيعه لا ليفترسه، بل لينقذه!
أو أنه سعى لخلق التوازن بين القوة والهشاشة من خلال أنيابُ اللغة التي تحمي عُرْيَ الروح: «كلامي أضحى مُبهماً» (القوة الوهمية للشعر في مواجهة العجز).
أو أن المضارعُ أصبح جحيم الذئب وأن الزمنٌ يأكل ذئابه
فالحاضر («المضارع») ليس فضاءً له، بل فخٌّ: يُذكِّره بلحظات الفقد («صور عائلية»)، ويسرق منه المستقبل («الخسارة تربح»).
وقد تكون هروبا إلى الماضي أو المتخيَّل حيث أن هروبه من «ذئب المضارع» يتجلَّى في التماس ملاذٍ عند «رولا» (الحب/الوطن) أو في «حديقة موغلة في التسابيح» (التراث الصوفي).
تميزت المجموعة في عمق الرؤية الفلسفية والوجودية، ونجاحه في تحويل الألم الشخصي إلى رمز إنساني وجرأة اللغة وتنوع التقنيات، خاصة في المزج بين اليومي والمجازي
والتماسك الموضوعي رغم تعدد الثيمات، حيث تربط «الغياب» جميع القصائد.
كما أ ن المجموعة تُعيد تعريف «القصيدة الحديثة» عبر كسر التابوهات، كتدجين الموت («كرنفال الوحدة») وتحويل الحب من غزل تقليدي إلى حوار مع الغياب («هل أضعتُكِ؟») والعمل على توظيف الموروث العروضي في سياق حداثي («متفاعلن»).
كان الذئب «مأساة متجددة» .
برقان – كذئب عصره – لا يَصْطادُ، بل يُصَاد.
يصطاده الحاضرُ بفوضاه، ويصطاده الموتُ بغِياب أحبته، ويصطاده الوطنُ المُغتَصَب بجرحه الذي لا يندمل، في هذا التشابك، يصير «ذئب المضارع» استعارةً لأزمات المثقف العربي، فهو وحشٌ يملك أنيابَ الكلام، لكنه عاجزٌ عن إنقاذ من يحبُّ في عالمٍ يُحوِّل الأفكارَ إلى غبارٍ، والذاكرةَ إلى «صور عائلية» باهتةٍ على جدار الزمن.
هكذا يصبح العنوان نبوءةَ الشاعر عن نفسه ذئبٌ يكتبُ سيرة انقراضه بلغةٍ هي آخرُ أراضيه.
في المجمل، «ذئب المضارع» عملٌ شعريٌّ مكتمل، يوثّق صراع الذات العربية بين الفقد والأمل، ويؤسس لشعريةٍ تعانقُ الحزنَ دون أن تستسلمَ له.
