عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"أنثروبولوجيا الممارسات الغنائية النسائية في فلسطين".. دراسة فلسفية وتأريخية
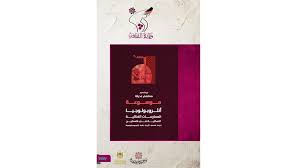
الغد-عزيزة علي
ضمن برنامج الحفاظ على الرواية، الذي تصدره وزارة الثقافة الفلسطينية، صدر كتاب بعنوان "موسوعة أنثروبولوجيا الممارسات الغنائية النسائية في فلسطين"، وهو عبارة عن دراسة فلسفية – تأريخية – بلاغية – إثنوميوسيكولوجية، للبروفيسور في جامعة النجاح معتصم عديلة.
تتجاوز هذه الموسوعة الفلسفة والأنثروبولوجيا والبلاغة والموسيقا في مشروع علمي فريد يعيد الاعتبار للغناء بوصفه فعلًا إنسانيًا مقاومًا، يعبر عن الذات الفلسطينية في لحظات الفرح والفقد، وفي صراعها من أجل البقاء والذاكرة. فالمرأة هنا ليست راوية للحكاية فحسب، بل صانعة لخطاب وجودي تكتب به تاريخ المكان عبر نبرتها، إيقاعها، وإصرارها على أن يظل الصوت شاهدًا على الحضور.
وتمتاز الموسوعة، التي صدرت بالتعاون مع جامعة دار الكلمة في رام الله، بجمعها ما يقارب 1000 نموذج غنائي نسائي شعبي، ينتمي إلى مجتمع واحد، تم تدوينها شعرياً وموسيقياً، ودراستها وتحليلها من مختلف أبعادها الإثنية. وجاءت هذه الموسوعة في 2000 صفحة.
إنها موسوعة تؤسس لمرجعية فكرية وجمالية جديدة في دراسة الغناء النسائي الشعبي، وتفتح أفقًا رحبًا لفهم العلاقة العميقة بين الفن والهوية، بين الجسد واللغة، بين الصوت والذاكرة، لتجعل من الغناء الفلسطيني سجلًّا أنثروبولوجيًا نابضًا بالحياة، يوثّق رحلة الإنسان الفلسطيني في مواجهة الفقد بالصوت واللحن والكلمة.
ويقدّم المؤلف تعريفاً بالموسوعة، يشير فيه إلى أن "موسوعة أنثروبولوجيا الممارسات الغنائية النسائية في فلسطين" دراسة فلسفية، تأريخية، بلاغية، إثنوميوسيكولوجية، تشكّل وثيقة إبستمولوجية فريدة، تُعدّ أول عمل موسوعي عالمي يعالج أنثروبولوجيا الممارسات الغنائية النسائية باعتبارها حقاً معرفياً متكاملاً.
إنها موسوعة تؤسس لمرجعية فكرية وجمالية جديدة في دراسة الغناء النسائي الشعبي، وتفتح أفقًا رحبًا لفهم العلاقة العميقة بين الفن والهوية، بين الجسد واللغة، بين الصوت والذاكرة، لتجعل من الغناء الفلسطيني سجلًّا أنثروبولوجيًا نابضًا بالحياة، يوثّق رحلة الإنسان الفلسطيني في مواجهة الفقد بالصوت واللحن والكلمة.
وتجمع الموسوعة بين التحليل الصوتي والجسدي والثقافي والرمزي للأداء الغنائي، وتعيد صياغة الخطاب الغنائي النسائي بوصفه ممارسة تولّد المعنى من داخل الطقس والجسد واللغة، مُؤسِّسةً بذلك مرجعية علمية جديدة لدراسة الصوت والتاريخ والهوية والجمال والسياسة والثقافة الشعبية الفلسطينية، باعتباره خطاباً إنسانياً مركباً ومتجذراً في البُنى الاجتماعية والروحية.
وبذلك تُعدّ الموسوعة عملاً تأسيسياً نادراً في حقل الدراسات الأنثروبولوجية الثقافية والموسيقية العربية، إذ تقدّم مقاربة تكاملية للغناء النسائي الشعبي عبر توظيف الفلسفة والتاريخ والبلاغة والأنثروبولوجيا الموسيقية.
ومن هذا المنطلق، تمثّل الموسوعة خطوة رائدة في توثيق الغناء النسائي الشعبي في فلسطين بوصفه مكوّناً جوهرياً من الهوية الثقافية، ووسيلةً لصون الذاكرة الجمعية، وأداةً للتعبير عن الانفعالات الإنسانية والوجودية في سياقات الأفراح والأحزان والطقوس الاجتماعية والدينية، إضافةً إلى تجليات النضال والصمود.
وتنبع أهمية الموسوعة من كونها أول عمل يجمع هذا التراث في صيغة موسوعية أكاديمية شاملة، من خلال توثيق النصوص الشعرية واللحنية وتحليلها ضمن منظور إثنوميوسيكولوجي وفلسفي معمّق، ما يفتح آفاقاً جديدة لقراءة الغناء النسائي كخطاب معرفي وثقافي متعدّد الأبعاد الرمزية والتاريخية والجمالية.
وهكذا تسدّ الموسوعة ثغرة بارزة في حقل الأنثروبولوجيا الثقافية الفلسطينية، بتركيزها على المرأة بوصفها فاعلاً ثقافياً منتجاً للمعرفة وناقلاً للذاكرة، بعيداً عن الصور النمطية التي تحصر دورها في موقع التلقي أو الاستهلاك. وتتحوّل الأغنية النسائية، في هذا السياق، إلى نصٍّ حيٍّ يكشف بنية المجتمع ويعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والأرض والهوية والذاكرة.
تتجلّى أهمية هذا العمل الموسوعي في كونه قائماً على قاعدة بحثية واسعة شملت أكثر من ألف (1000) نموذج غنائي نسائي شعبي، جُمعت من خلال جهد ميداني وتوثيقي دؤوب أتمّه الباحث في إطار مشروع بحثي تمهيدي لهذا العمل، الذي حمل عنوان "موسوعة الغناء النسائي الشعبي في فلسطين".
وشملت عملية الجمع توثيق الأغاني، وتدوين الجمل الشعرية والخطوط اللحنية، ورصد الأبعاد الإثنوغرافية من مختلف المناطق الفلسطينية، سواء عبر البحث الميداني المباشر من أفواه الناس من خلال مقابلات شفوية مع المغنين والمغنيات، أو من خلال الحصول على التسجيلات الغنائية القديمة المحفوظة في أرشيف المؤسسات والمراكز المعنية بالتراث الفلسطيني، إضافةً إلى بعض الأغاني المستقاة من الدراسات السابقة.
بعد ذلك، خضعت هذه المادة لمقاربة متعددة التخصصات، تدمج بين الرؤية الأنثروبولوجية والتحليل الفلسفي الفينومينولوجي والبلاغي والتأريخي والإثنوميوسيكولوجي، ما منحها عمقاً معرفياً مركباً، وحوّلها إلى مادة موسوعية امتدّت على ثلاثة مجلدات تجاوزت صفحاتها ألفي (2000) صفحة، مقدّمةً بذلك مساهمة رصينة وجديدة في دراسة أنثروبولوجيا الممارسات الغنائية النسائية في فلسطين.
وجاءت هذه الموسوعة، كما يذكر المؤلف عديلة في ثلاثة أبواب علمية، يتدرّج كلٌّ منها من البنية النظرية إلى التطبيقات الدقيقة. وجاء الباب الأول بعنوان "المفاهيمي (مفاهيم الدراسة)"، حيث يؤسس هذا الباب الإطار المفاهيمي للموسوعة من خلال بلورة المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها تحليل الغناء النسائي الشعبي في فلسطين، مبرزاً الترابط العضوي بين النظرية والتحليل الميداني والبعد الثقافي.
ويُشكل هذا الباب العمود الفقري المفاهيمي للموسوعة، إذ يهيّئ القارئ للتعمق في الأبعاد الثقافية والفلسفية والإثنوميوسيكولوجية التي يعالجهما البابان الثاني والثالث، كما يتيح مقاربة شاملة للعلاقة بين الأداء الصوتي والرمزية والهوية الفلسطينية. ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول تعنى بتأصيل المفاهيم التي تشكّل الإطار النظري للموسوعة.
أما الباب الثاني، فيتناول أبعاد الدراسة الدلالية والثقافية؛ فيقدّم الأغنية النسائية الشعبية في فلسطين بوصفها خطابًا دلاليًّا متكاملاً تتقاطع فيه الأبعاد اللغوية والجمالية والدينية والوطنية والتراثية. ويبرز تفاعل الأصالة مع الرمزية، ويكشف عن حضور الأغاني كأداة لتوثيق أنثروبولوجيا الذاكرة الفلسطينية عبر الأداء الصوتي النسائي.
ويُمثّل هذا الباب قلب الموسوعة التحليلي، إذ يتناول الأغنية النسائية الشعبية باعتبارها نصًا صوتيًّا مركب البنية، ينتج المعنى من خلال تداخل مستمر بين الأبعاد المشار إليها، ويتألّف من خمسة فصول.
فيما يتناول الباب الثالث، بعنوان "جوانب الدراسة" التاريخي والميوسيكولوجي، محور الموسوعة، حيث يركّز على تاريخ تطوّر الموسيقا العربية والخصائص الموسيقية للأغاني النسائية الشعبية في فلسطين، مع تقديم تحليل معمق للمقوّمات الموسيقية والهوية الصوتية للغناء النسائي.
وينقسم هذا الباب إلى فصلين محوريين يدمجان بين البعد التاريخي لتطور الموسيقا العربية والتحليل الميوسيكولوجي، لتقديم رؤية شاملة تربط بين تطوّر الأغنية وأبعادها الصوتية والجمالية.
ثم يتحدّث المؤلف عن الإطار النظري والمنهجي، موضحًا أنه استند في إعداد هذه الموسوعة إلى منهج تكاملي متعدد الحقول، يجمع بين الرؤية الأنثروبولوجية والفلسفية والتاريخية والبلاغية والإثنوميوسيكولوجية والميوسيكولوجية، بما يتيح قراءة معمّقة للغناء النسائي الشعبي في فلسطين.
