عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"رائحة الزينكو".. المخيم ككائن حي في أحدث أعمال زياد أبو لبن
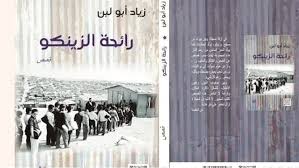
الغد-عزيزة علي
تأتي المجموعة القصصية "رائحة الزينكو"، للناقد الدكتور زياد أبو لبن، التي صدرت عن دار الخليج للنشر والتوزيع، لتعيد قراءة المخيم من الداخل، بوصفه تجربة وجودية وحياة تتشكل وتقاوم، لا مجرد مكان مرسوم في الوعي العام.
هل جاءت هذه المجموعة ضمن ما يطلق عليه "أدب المخيمات"، وما هو هذا الأدب؟ رأى الدكتور زياد أبو لبن أن أدب المخيمات هو محاولة لالتقاط نبض إنساني تشكل في فضاءات الفقر واللجوء؛ في جدران الزينكو، وأفران الخبز الضيقة، وخطوات الأطفال المتعبة. وهو أدب لم ينشأ بقرار أو تنظير، بل ولد من التجربة والندبة، من الخيمة والمدفأة البسيطة، ومن تفاصيل الحياة اليومية التي تحولت إلى ذاكرة جمعية حية.
هل أضافت مجموعة "رائحة الزينكو" إلى أدب المخيمات بعدا جديدا؟ قال أبو لبن "أنا في هذه المجموعة لم أتعامل مع المخيم كخلفية جاهزة، بل ككائن حي يتنفس داخل النص".
وأضاف "اعتُبر المخيم فيها حالة إنسانية ونفسية ولغوية تتسرب إلى كل تفصيلة في السرد، ليصبح لغة ورائحة وإيقاع يومي وصوتا من الزقاق الضيق إلى أسئلة وجودية واسعة".
تميزت هذه المجموعة، وفق أبو لبن، بمحاولتها التقاط ما وراء المعاناة: ذاكرة البيوت المهدمة، حساسية الأطفال، والأحلام الصغيرة التي تنمو رغم محدودية الفضاء.
وحول ما قدمته "رائحة الزينكو"، قال "قدمت زاوية مكثفة للواقع، مستخدمة مفردات المكان، كالزينكو، الغبار، الأبواب الصدئة، رائحة الخبز، وضجيج الكهرباء، كجزء من تكوين الشخصية وسياقها النفسي، لا كزينة لغوية".
كما أبرزت هذه المجموعة، بحسب المؤلف، صدق تجربة المخيم، بعيدا عن صدى الإعلام والسياسة، وأعادت الإنسان إلى مركز الحكاية، وسمحت للمكان أن يتحدث بلسانه الحقيقي.
وحول كيف ينظر إلى المخيم، رأى أن المخيم ليس هامشا من التجربة الفلسطينية بل هو قلبها؛ ففيه تتكون اللغة والمشاعر والانتماء، ويتعلم الإنسان معنى الخوف والصبر، ويكتشف أن المؤقت قد يتحول إلى قدر طويل. ويتجاوز هذا الأدب وصف الضيق والجوع ليكشف عمق الحالة النفسية للإنسان الذي يعيش انتظارا دائما ويورث حلما يواجه واقعا يعاد كل صباح.
كما أن أدب المخيمات يلتقط الأصوات الصغيرة والمقاومة اليومية: ضحكات الأطفال، حركة الأمهات، نداءات الوكالة، وحكايات الشباب بين بوابات مغلقة وسماء منخفضة. وهو أدب يتجاوز الحدود؛ لأن المخيمات، رغم اختلاف أسمائها، تحمل الوجع ذاته والرجاء ذاته، مما يجعل ذاكرة كتابها مشتركة.
أما خصوصية هذا الأدب، فأشار إلى أنها تكمن في كونه عابرا للحدود والخرائط؛ فالمخيم واحد رغم اختلاف الأسماء، من جنين إلى اليرموك ومن عين الحلوة إلى البقعة، وتظل التجربة الإنسانية نفسها: القلق، الرجاء، الحنين. لذا يستطيع كاتب من مخيم بعيد أن يكتب وجع مخيم آخر لم يره؛ لأن الذاكرة هنا جماعية وموحدة.
أدب المخيمات يمتلك وجدانا ولغة ومخيالا خاصا، وهو شهادة على بشر عاشوا ظروفا فوق طاقتهم، فحولوا معاناتهم إلى قصص تروى، ويظهر أن الإنسان يمكن أن يتحول من شاهد على مأساته إلى صانع لمعناه. هذا الأدب ليس مجرد موجة عابرة، بل أرشيف إنساني يحمي القلب من السقوط، ويذكر العالم بأن الفلسطيني، مهما تكسرت أيامه، ما يزال يقول: أنا هنا.
وعن مقومات أدب المخيمات، قال "يقوم أدب المخيمات على مقومات عدة تمنحه خصوصيته داخل المشهد الأدبي العربي: الذاكرة: الكتابة ليست مجرد سرد، بل استحضار للماضي وحماية ما تبقى من ملامح المكان الأول. الواقعية الكثيفة: تصوير تفاصيل الحياة اليومية في الأزقة الضيقة، صراعات البقاء، ازدحام البيوت، وتشكل الوعي تحت ضغط الفقد والمنفى. البعد الإنساني: منح الفرد صوته المستقل، سواء الأم، الطفل، العامل، أو اللاجئ الذي يحرس مفتاح بيته كحارس للذاكرة. اللغة المتوترة والمشحونة: توازن بين الحس الشاعري والخطاب اليومي، بين قسوة الواقع ورهافة الشعور، مما يمنح الأدب نبرة خاصة. الرمز: عناصر مثل المفتاح، الخيمة، الطوابير، الحدود، رائحة الخبز، وذكريات القرية، التي تربط الماضي بالمستقبل والذاكرة بالهوية. كل هذه المقومات تجعل من أدب المخيمات شهادة فنية على تجربة إنسانية قاسية، لكنها معبرة وحية".
وعن أهمية أدب المخيمات، رأى أنها تكمن في كونه أكثر من كتابة عن مكان جغرافي؛ إنه سردية تجربة وجودية عاشها شعب بأكمله. يمثل الذاكرة التي تصر على النجاة من النسيان، ومرآة تعكس الوجع الإنساني بعيدا عن الخطابات الجاهزة.
يلتقط هذا الأدب التفاصيل الصغيرة التي لا تراها الكاميرا: تعب الأمهات، خطوات العائدين من العمل، ضحكات الأطفال، ليظهر الفلسطيني كإنسان له حلم وحكاية وحق في رواية تاريخه.
كما يحول المخيم، رغم قسوته، إلى فضاء لصياغة هوية جديدة، واختبار للغة وأسلوب وحساسية مختلفة، مما يجعله إضافة مهمة للمدونة العربية. أدب المخيمات هو شهادة حية ووثيقة إنسانية وصرخة جمالية في وجه عالم يحاول أحيانا تجاهل أصل الحكاية.
وعن تأثر كتاباته كناقد. قال "نعم، تأثرت كتاباتي الأدبية بالنقد، لكنه لم يكن قيدا بل مرآة تساعدني على كشف المناطق المعتمة في نصوصي. منحني النقد قدرة أكبر على الانتباه لبنية النص وإيقاع الجملة وما يمكن أن يثقل الكتابة بلا حاجة، لكنه علمني أيضا ترك مساحة للنص كي يتنفس بحرية".
يضيف "أحاول الكتابة بعين المبدع وقلبه، ومراجعة النص بعقل الناقد ومسؤوليته، فتتشكل تجربتي بين الصرامة والاندفاع، لتكون الكتابة صادقة، حية، ومحكمة في الوقت نفسه".
وحول من كتب أدب المخيمات بصدق، قال "من عاش في المخيم أو اقترب من نبضه الحقيقي، ملتقطا الروح الداخلية للمكان: خوفه، عزته، تعب يومه، وحنين ليله. من هؤلاء: غسان كنفاني الذي جسد وجدان المخيم في أعماله، مثل رجال في الشمس وأرض البرتقال الحزين، وسميح القاسم ومحمود درويش اللذان رسما أحلام وألم اللاجئ ضمن الهوية الفلسطينية، وفدوى طوقان التي كشفت التجربة الإنسانية للاجئ من زاوية حسية وشعرية دقيقة. وهناك كتاب آخرون من أبناء المخيمات كتبوا بنبرة يومية وواقعية، ملتقطين تفاصيل الأزقة، العلاقات، ورائحة الخبز والحديد والغبار، موثقين ما لا يظهر في الكتب الرسمية. صدقهم جاء من انغماسهم في التجربة، لا من التجميل أو المبالغة".
ويختتم حديثه بأنه يعمل على قصص جديدة عن المخيم، ما تزال في مرحلة التكوين الأولى، حيث النص يتشكل ببطء. المخيم ما يزال يهمس بحكايات لم تُرو بعد، متضمنة تفاصيل صغيرة مثل وجوه عابرة، أصوات الأبواب المعدنية، ومشاهد الحياة اليومية المتكررة لكنها متباينة.. هناك دائما قصة جديدة تستحق أن تكتب.
