عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"الاستشهاد عبر الثقافات".. تحليل تطوره وأبعاده في الحضارات القديمة
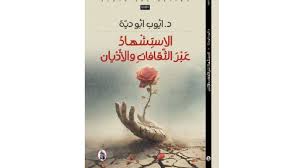
الغد-عزيزة علي
يكشف كتاب الأكاديمي والباحث الأردني الدكتور أيوب أبو دية، "الاستشهاد عبر الثقافات والأديان.. سياسة"، عن مفهوم الاستشهاد عبر الثقافات والأديان المختلفة، من خلال تحليل تطوره وأبعاده في الحضارات القديمة والديانات التوحيدية الثلاث: اليهودية، المسيحية والإسلام.
ويقدم الكتاب الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، رؤية شاملة تربط بين الممارسات والرموز المشتركة للاستشهاد، موضحا كيف يعكس هذا المفهوم بنية عقلية وروحية إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية.
يناقش الكتاب الذي يتناول مفهوم الاستشهاد في بعدين: الأول في الإسلام، والثاني في الحضارات العالمية؛ دور الاستشهاد في بناء الهويات الوطنية والدينية، وتأثيره في تحفيز الشعوب على مقاومة الظلم والاضطهاد، ليكون بذلك نافذة لفهم أعمق لتراثنا الإنساني المشترك.
في مقدمته، يقول الدكتور أيوب أبو دية، إن نشوء فكرة الاستشهاد وتطورها في ثقافات العالم المتنوعة، سواء انبثقت من رحم تعاليم الديانات التوحيدية، أو من حكايات الإغريق والرومان، أو من ثقافة حضارات نهري دجلة والفرات في العراق القديم من خلال ملحمة جلجامش، كان وسيلة للدفاع عن الوطن، والأمة، والأسرة، والعقيدة، والعدالة، والحاكم. كما اعتُبرت الاستشهادية مخرجًا إبداعيًا من مواجهة الموت، هذا الحدث البشري الحتمي، ولغرض تعليم الدروس الأخلاقية والاقتداء بها.
ويرى المؤلف أنه، على الرغم من الجذور المتناثرة لفكرة الاستشهاد عبر الحضارات والعصور، فإن ممارسة هذا الفعل تُظهر ترابطًا على الصعيد العالمي، حيث تتقاسم الثقافات المختلفة موضوعات وزخارف ونماذج أولية مشتركة، تكشف عن تراث إنساني يوحد بين المذاهب والثقافات المتنوعة.
ويؤكد الدكتور أبو دية، أن هذه الدراسة لا تعد سردًا تقليديًا لمفهوم الاستشهاد، بل تمثل تحليلًا وتركيبًا للعلاقات المتشابكة بين مفاهيم الاستشهاد في مختلف الثقافات، على مستوى عالمي. فعلى الرغم من تنوّع الخلفيات الثقافية، واختلاف الأزمنة والأمكنة، فإن الاستشهاد يكشف عن أنماط عالمية من الفكر والعاطفة والتعاطف، إلى جانب مشاعر التضحية بالنفس والسعي نحو الخلود.
ويشير إلى أن هذه الممارسات ليست مجرد بقايا معزولة من الماضي، بل هي ظواهر حيّة ما تزال تتطور وتتجدد، ويتردد صداها في وجدان كل جيل، وفي كل ثقافة، باستمرار. ومن هنا، فهي ليست حكرًا على المسلمين وحدهم. لافتا إلى أن مفهوم الاستشهاد يعد ممارسة عقائدية نابعة من بنية العقل البشري، تتجاوز الحدود الثقافية الضيقة، وتكشف عن خيوط مشتركة نُسجت تاريخيًا، وبيولوجيًا، ونفسيًا، عبر معاناة فكرية وجسدية وبيئية امتدت عبر العصور.
ويضيف أنه، رغم الأصول المتنوعة والسياقات الثقافية الفريدة لبعض أشكال الاستشهاد، فإن هذا المفهوم غالبًا ما يشترك في موضوعات أساسية تسلط الضوء على تجربتنا الإنسانية المشتركة، وعلى البناء العقلي والنفسي الموحد، بما يبرز مدى تقارب الحضارات المادية والروحية وتشابكها.
ويؤكد المؤلف أن وحدة مفهوم الاستشهاد في ثقافات العالم تتجاوز الحدود الجغرافية، والثقافية، والعرقية، والدينية، والمذهبية، كاشفة عن وحدة أساسية في الخيال البشري، والعقل، والطموح، والعاطفة الجياشة. سواء أكانت التضحية بالنفس من أجل الخلود في الجنة، أو لغسل الذنوب، أو لتأدية الواجب في الدفاع عن الوطن، أو العرض، أو الأرض، أو العقيدة، أو الحاكم، أو غير ذلك، فإن الاستشهاد يعكس قاسمًا إنسانيًا مشتركًا.
وخلص أبو دية إلى أن مفهوم الاستشهاد يشكّل نسيجًا عالميًا يجسد إنسانيتنا المشتركة، من خلال ارتباطنا المادي بهذه الدنيا الفانية، ورغبتنا العميقة في البقاء والخلود. وهذا ما يعزز فهمًا أعمق لقصتنا الجماعية، المتشابكة حيويًا، والمرتبطة بتاريخ الحضارة البشرية في سياق تطورها التاريخي.
في خاتمة هذه الدراسة، يشير المؤلف إلى أنه سعى منذ البداية إلى استكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين الديانات التوحيدية الثلاث. وقد تبين أن جميع الأديان السماوية تنظر إلى الاستشهاد بوصفه تضحية سامية، وإن اختلفت التفاصيل والسياقات من دين إلى آخر. ففي اليهودية والمسيحية، غالبًا ما يُرتبط الاستشهاد بالدفاع عن الإيمان الديني، بينما يتخذ المفهوم في الإسلام بعدًا أكثر غنى وتعقيدًا، حيث يرتبط بالجهاد والقتال في سبيل الله، إلى جانب الدفاع عن المال، والعِرض، والأرض، وتحقيق العدالة.
ويقول المؤلف إن فكرة الاستشهاد في الإسلام، بوصفها "في سبيل الله"، تعد من أعلى مراتب الفضيلة، إذ يضحي الفرد بحياته دفاعًا عن الإيمان أو الوطن. أما في المسيحية، فالاستشهاد يُنظر إليه كتجسيد لتضحية السيد المسيح من أجل البشرية، بوصفه "شهيد الإنسانية"، ويعكس تفاني الإنسان في سبيل العقيدة حتى الموت.
كما يتطرق المؤلف إلى مفهوم الاستشهاد في الحضارات الأقدم، مبينًا أنها، وإن اختلفت في تعريفاتها ومعاييرها، فإنها كانت تتمحور حول موضوعات متقاربة، وتعكس تقديرًا لفكرة التضحية القصوى. فقد قدرت الثقافات القديمة فعل الاستشهاد، وإن عرّفته ضمن أطرها الدينية والثقافية والمجتمعية الخاصة. فقد تنوع معناه من الموت دفاعًا عن الإيمان بالآلهة أو الملك أو الوطن، إلى تأمين الشرف والعدالة للأجيال المقبلة، كما في حضارات بلاد الرافدين.
وفي الثقافتين الكونفوشيوسية والتاوية، أضيف إلى ذلك بعد الدفاع عن شرف الأجداد والواجبات الأخلاقية، بينما ارتبط مفهوم الاستشهاد في الثقافة الهندوسية بالدفاع عن "الدارما"، أي الطريق الصحيح، والعدالة، والواجب الأخلاقي، موضحا أنه في الحضارة اليابانية، يرتبط مفهوم التضحية والشرف بولاء المحارب وإيمانه بالشرف والإمبراطور. أما في ثقافة السيخ، فقد اقترن الاستشهاد بالدفاع ضد الاستعباد والاضطهاد الطبقي. ورغم تنوع الخلفيات، فإن جميع هذه الأمثلة تدور في فلك واحد، حيث يُنظر إلى الاستشهاد على أنه تضحية من أجل قضية سامية، سواء كانت دينية أو وطنية أو اجتماعية.
لكن ما يميز بعض الثقافات، مثل اليابانية والهندوسية واليهودية، هو ظهور الانتحار الجماعي كمظهر من مظاهر الاستشهاد، كما حدث في أوكيناوا، ومعركة شيتورجاره، وقلعة مسعدة. ويشير المؤلف إلى أنه إذا ما تم البحث في عمق التاريخ، فلا بد أن تظهر حالات مشابهة في ثقافات أخرى أيضا.
ومن هنا، يرى أن وحدة المضامين التي يحملها مفهوم الاستشهاد، رغم تطورها عبر آلاف السنين، تدل على وحدة العقل البشري وتشابه حاجاته المادية والنفسية. فالبشر، في مختلف الثقافات، يشتركون في حاجات أساسية مثل الأمان، والغذاء، والحب، والانتماء إلى وطن، وأمة، وأسرة. وهذه الحاجات المشتركة توجه العديد من التصرفات والتقاليد العابرة للثقافات، ما يدل على وجود بنية عقلية مشتركة تتجاوز الفروقات السطحية بين الثقافات والأعراق.
وبالطبع، لا يعني ذلك وجود تطابق كامل في تصور مفهوم الاستشهاد بين مختلف الثقافات، فالتجارب الثقافية والاجتماعية والبيئية والمذهبية الفريدة تنتج أشكالا متميزة من التفكير والسلوك. ومع ذلك، فإن الأسس البيولوجية والنفسية والبيئية التي تشكل البنية العقلية البشرية تظل متشابهة إلى حد كبير، ولدينا أمثلة عديدة تؤكد ذلك من أبحاث وتجارب لعلماء بارزين في مجالات متعددة.
ويرى المؤلف أن هذه الرؤى العلمية المتعددة، تشير مجتمعةً إلى وجود توافق واسع بين علماء البيولوجيا، وعلم النفس، واللغة، والفلسفة، حول وجود بنية عقلية أساسية مشتركة بين البشر. وهذه الفرضية مدعومة بأدلة من الأنثروبولوجيا، وعلم النفس التطوري، واللسانيات، وعلم الأحياء. وانطلاقًا من هذا الفهم، فلا بد من الإقرار بوجود قرابة روحية ومادية بين الثقافات، تتجلى في المعتقدات المشتركة، وتعود جذورها إلى بنية بيولوجية وعقلية متماثلة.
ويعود المؤلف إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، الذي رأى أن العقل البشري واحد، لا يختلف في جوهره من إنسان إلى آخر، وهو ما تؤكده أيضًا المفكرة الأميركية مارثا نوسباوم وغيرها من الفلاسفة. فهناك شبه إجماع فلسفي على أن العقل البشري يمتلك بنية موحدة، ولا يمكن الادعاء بتفوق حضارة على أخرى من حيث البناء العقلي.
هذا العقل الموحد في أدائه وسعيه، يعبر عن رابطة روحية ومادية بين البشر، مهما اختلفت ثقافاتهم أو تباعدت حضاراتهم زمانيًا ومكانيًا. ومن هنا، يظهر مفهوم الاستشهاد كوسيلة ثابتة وعابرة للثقافات للدفاع عن الوطن، والأمة، والأسرة، والشرف، والعقيدة، والعدالة، والحرية، والحاكم. كما يشكل محاولة إنسانية لإيجاد مخرج أخلاقي ووجودي من معضلة الموت والفناء الحتمي، عبر تكريس القيم، وتعليم الدروس، وتأسيس أنماط من القدوة الأخلاقية التي تسهم في تنظيم المجتمعات، وتحقيق غاية الإنسان في السعادة.
وبالتالي، يرى المؤلف أن الفكرة اليهودية التي تقصي "الأغيار" من غير اليهود باعتبارهم أقل مرتبة، تبدو فكرة سخيفة وغير متسقة مع هذا الإدراك الواسع للمشترك الإنساني، الذي يظهر أن القيم العليا مثل الاستشهاد، ليست حكرًا على دين أو أمة، بل تعبير عن جوهر إنساني واحد.
بل إن هذا المفهوم لا يقتصر على فئة دون أخرى، بل يطال الشعوب كافة؛ إذ إن الظروف الموضوعية القاسية، والشعور العميق بالاضطهاد والظلم الذي تتعرض له بعض الأمم في هذا العصر العنيف، يسهم في إحياء التراث المقاوم، كوسيلة للبقاء والحفاظ على الكرامة والهوية.
ويؤكد المؤلف أن مفهوم الاستشهاد، بوصفه ظاهرة متشابهة في الحضارات المختلفة، رغم تباعدها الجغرافي والثقافي، يعزز من فكرة الوحدة العقلية الأساسية في التجربة الإنسانية. فهذه الظاهرة تحمل في طيّاتها موضوعات وزخارف ونماذج أولية متكررة، تكشف عن تراث إنساني متداخل، وتجربة روحية ومادية متماثلة، وبنية عقلية مشتركة، تجعل البشر -على اختلافهم- أقرب إلى أن يكونوا أنسباء في الجوهر، متحدرين من أصل واحد، مهما اختلف الزمان والمكان.
وخلص الى أن هذا الإدراك يمنحنا أملًا في تقارب إنساني حقيقي، وتصالح تاريخي بين الثقافات، والمذاهب، والأعراق. بل وربما يفتح الباب أمام اندماج عميق وأصيل، قد يقود إلى سلام عالمي طالما حلم به الفلاسفة، مثل إيمانويل كانط، ممن تمنوا أن تنتهي الصراعات بالحوار والتفاهم، لا بالدماء والتناحر.
