عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
نظرات في كتاب حسب توقيت الغياب لخلود الواكد
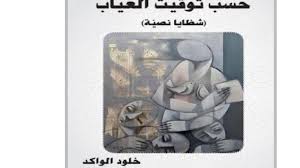
الدستور د. سلطان المعاني
يشتغل كتاب حسب توقيت الغياب لخلود الواكد على بناءِ متواليةٍ من «ومضاتٍ نثرية» تلتئمُ رويدًا في ملحمةٍ طويلةٍ عن الفقد والانتظار والذاكرة، حيث يعملُ الغيابُ كمنطقٍ ناظمٍ للإيقاع والصورة والتفكير. يتأكد ذلك من طبيعة التقسيم إلى مقاطع قصيرة تفصلها علامات نجميّة، بما يشي بوعيٍ بنيويٍّ يراهن على التكثيف والتقطيع لإنتاج توتّرٍ دلاليٍ مستمر.
يؤسّس النص معجمه من حقولٍ حسّيّة مألوفة: الليل، والمطر، والضباب، والبحر، والشمعة، والباب، والنافذة، والهاتف؛ غير أنّه يُحمّلها دلالاتٍ وجوديّة تتجاوز محض الزينة البلاغية. حين «تسجد الشمعة سجودها الأخير» وتتعالى العتمة، يُعاد ترتيب علاقة الضوء بالكتابة والزمن، فيتحوّل الضوء من أداةِ كشفٍ إلى كائنٍ فانٍ، ويغدو الظلامُ شرطًا لانبثاق صوتٍ داخليٍّ أكثر صفاء.
وتستعيد النصوص المطر كقوة تطهّر الأرصفة والوجوه، وتستعير الضباب كغلالةٍ نفسيةٍ تُعطّل الاتجاهات وتُربك البوصلة، فيما يُستحضر البحر بلا مجداف لإحلالِ العجز موضعَ الحركة.
يستدعي الخطابُ الوطنيَّ الإنسانيَّ بوصفه تخومًا للذات: فلسطين تُذكر صراحةً، و«غزة» تُستحضرُ مرارًا ككفٍّ تمتد عليه «خطوط الحياة» وكجرحٍ مفتوحٍ في الوعي الجمعي، كما يطلُّ مشهدُ الهاتف الذي يرنّ في جيب الشهيد بما يحفر مفارقةً بين منطق التقنية ومنطق الفقد. بهذه اللقطات، يخرج النص من ذاتيّته إلى ذاكرةٍ عموميّةٍ محمّلةٍ بالدمع والرماد و«الدّحنون»، ويُعيد توزيع العبء بين الأنا والـنحن من غير شعاراتية مباشرة.
يبني الصوتُ الملحمي شخصيّتَه الساردة بضميرٍ ذاتيّ غالبٍ، أنثويّ الإيماء في الغالب، لكنه يوسّع مدارَه بمخاطباتٍ حُلميّة ومونولوجات تساؤليّة تنتهي إلى لا يقينٍ مقصود. تتجاور الجُملُ الاسمية مع الفعلية القصيرة، وتتكسّر التراكيبُ على حوافّ البياض لتوليد «وقفةٍ» إيقاعيّةٍ تحاكي النبض المُرتجف للذاكرة. تتكرّر صيغٌ وأنماطٌ لغوية بعينها، من قبيل: «قلبي مخلوع» و«يقف على باب عيني بكاء»، لتأسيس لازمةٍ عاطفيةٍ تُثبت أثر الجرح في الجسد والخطاب معًا. وتتكاثف الأسئلة البلاغية: «ما كان؟ هل كان خطأً كلّه؟ كيف أعود إلى صوابٍ كاذب؟» لتؤكّد وظيفة السؤال بوصفه شكلًا للعيش في الحيرة.
يشتغل التّناصّ بإيماءاتٍ مقتضبة؛ يحضر نصّ واسيني الأعرج بوصفه مرآةً لجدل الانتظار/الجنون، فيُعاد تدوير المقولة داخل نسيجٍ جديدٍ يخلّصها من «الاقتباس» إلى «التوليف»، فتمسي جزءًا من سردية الغياب لا هوامش لها. وإلى جوار ذلك، تتواتر الميتاشعريّة: تتردّد جُملٌ عن خيانة الكتابة حين تخلع الكلماتُ «ثوب الحزن»، وعن الوطن بوصفِه «وطنًا للكتابة»، وعن الورقة البيضاء بوصفها كاهلًا يُثقلُه زُؤانُ الذاكرة؛ وكلّها مفاتيحُ لفهم الكتّابة كفعلِ تضميدٍ لا شفاءَ فيه ولكن إرجاءٌ لوجعٍ نقيّ.
تُفلح المجموعة في استخدام المقابلات الكبرى، حضور/غياب، ضوء/عتمة، قول/صمت، حياة/موت، لكن ليس على هيئة ثنائياتٍ مغلقة؛ إذ تُذاب الحدودُ بينها بلقطاتٍ كالهاتف الذي يرنّ في جيب الشهيد، والشمعة التي «تسجد»، والقبر الذي يصبح مأوى للأحياء، فتُقلب وظائف الأشياء والمعاني وتُختبر اللغة على تخومها القصوى. من هنا يتولّد «الإيقاع الداخلي»: جُمل قصيرة، توقفات مفاجئة، علامات تنقيطٍ متقشّفة، وتدويرٌ للصورة على أكثر من مشهد (المطر/القنديل/البحر/النافذة)، بما يخلق تآلفًا بين الموسيقى الدلاليّة و«مَقادير» التوتر الشعوري.
تفكّك المجموعة الغياب إلى أنماطه الزمنية: غيابٌ يتأخّرُ «فتأتي البداية»، غيابٌ يوقظ «رسائل لا تصل»، غيابٌ يملأ «حقائب الأمس»؛ فتتحوّل اللغة إلى جهازٍ لقياس الزمن لا لتمثيله فقط. كما تُعيد صهر الخاص بالعام حين تُدخل المشهد الفلسطيني في جسد القصيدة بغير «إملاءٍ» أيديولوجي، فتستوي «غزّة» رمزًا وتجربةً في آنٍ، ويغدو رنين الهاتف في جيب الشهيد استعارةً كُبرى لفراغِ الخطاب أمام انقطاع الحياة. كما أنها تقيم جسرًا بين الكتابة والعلاج، إذ تُعلن الكاتبة مرارًا أن القصيدة «تُبرّئ القافية» وتوقظ «النشيج»، وأنّ الورقَ يتهشّمُ حين «تخلع الكلماتُ ثوب الحزن»، فيتشكل وعيٌ أخلاقيٌّ باللغة: لا تزيّن الألم حيث تمنحه صيغةً كريمةً للوجود.
يُحصّل النص في مجمله أثرًا وجدانيًّا صادقًا، ويؤكّد مقدرةً على صناعة صورةٍ تُقيم في الذهن، قنديلٌ ينطفئ ببطء، نافذةٌ ينعقدُ عليها الضباب، هاتفٌ يرنّ في جيب الغياب، وتلك علاماتُ كتابةٍ تعرف كيف تُحوِّل مألوفَ اليوميّ إلى أيقونةٍ دائمة. بهذه السّمات، يخرج الكتابُ من حدِّ «التعبير» إلى أفق «الإنشاء»؛ حيث يُنشئ له زمنًا ومكانًا وطقوسًا لغويّة تُقاس بها الحساسيّة الحديثة في أدب الاعتراف والحداد.
تتشكل مجموعة «حسب توقيت الغياب» لخلود الواكد في أفقٍ يزاوج بين الشعر والنثر، حيث يتجلّى النص ككيان يتنفّس من خلال التكثيف والاختزال، متوسّلًا الومضة القصيرة التي تومض في العتمة وتخبو، لتعيد ترتيب العلاقة بين اللغة والوجود. فالمقاطع المقتضبة التي تفصلها نجيمات، هي ومضات جمالية تجعل الغياب حاضرًا في البنية ذاتها، إذ يغدو الصمت فراغًا مقروءًا، والبياض جزءًا من النسيج الدلالي الذي يتيح للقارئ أن يملأ الفجوات بما يشبه التأمل أو الحنين بين الومضة والشذرة والنص القصير جداً. وتكمن فرادة التجربة في أن المفردات الحسيّة المألوفة، مثل المطر والبحر والشمعة والنافذة والهاتف، ترد مثقلة بدلالات وجودية تحوّلها إلى علامات على الفقد، بحيث تصبح الشمعة حين «تسجد سجودها الأخير» رمزًا للزمن الذي ينطفئ، وللكتابة التي لا تُنقذ من العتمة إلا بقدر ما تستسلم لها.
ينبني النص على منطق الغياب باعتباره قوة مهيمنة تعيد تشكيل المعنى. فالغياب هو القانون الداخلي الذي يسيّر السرد ويصوغ الإيقاع، فيحوّل الانتظار إلى قدر، والحضور إلى ذكرى، واللغة إلى أثر لما لم يعد حاضرًا. ومن هذه الزاوية يتحوّل النص إلى كتابة داخل الفراغ، وإلى مقاومة للعدم عبر تحويله إلى دلالات متجدّدة. وتستثمر الواكد هذا الغياب في بناء معجم يراوح بين التجربة الذاتية المرهفة وما يتجاوزها نحو الجماعة، فالنص يقف عند حدود الجرح الفردي وعند الفقد العاطفي، ويتقاطع مع الغياب الجمعي والوطني، مع فلسطين والشهداء وغزة، بحيث يغدو الغياب الشخصي صورةً من الغياب القومي، والحنين الفردي مرآة لفقدٍ جماعي يتكرر في التاريخ والذاكرة.
وتتجلّى في النصوص موسيقى داخلية تنبثق من التكرار والتوازي والتقطيع الإيقاعي، موسيقى تعتمد على التوقفات والانكسارات والانعطافات التي تجعل من الجملة شظية تتردد في الفراغ. هذه الموسيقى الخافتة توازي أنفاس الحزن أو وقع الخطى في ممر طويل، فتغدو اللغة نفسها مشبعة بإيقاع الغياب. وتتعزّز هذه الجمالية عبر توظيف الصمت باعتباره لغة موازية، إذ إن البياض بين المقاطع ليس خواءً إنه نصّ آخر مختلف ومنسجم في آن، مما يترك أثرًا عميقًا على القارئ الذي يجد نفسه أمام كتابة تقول بقدر ما تسكت، وتُظهر بقدر ما تخفي. وبهذا تغدو المجموعة نصًا مفتوحًا على التأويل، يكتب ذاته من الداخل كما يكتب القارئ نصًا آخر في الهامش أو في البياض.
إن «حسب توقيت الغياب» عمل يؤسس لقصيدة النثر الومضية بما هي طقس لغوي وفلسفي في آن، حيث يتحوّل الغياب إلى جوهر يتخلل اللغة والمعنى، ويتحوّل الصمت إلى مساحة للفكر، وتصبح التجربة الفردية علامة على مأساة جمعية لا تنطفئ.
