عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
كيف تفوز الصين بالمستقبل: إستراتيجية بكين لامتلاك الحدود الجديدة للقوة (2-2)
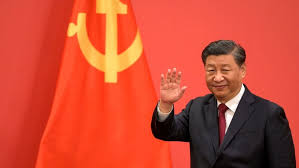
الغد
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
إليزابيث إيكونومي - (فورين أفيرز) 9/12/2025
بجرأة، إلى حيث لم يذهب أحد من قبل ثم هناك الحدود النهائية: الفضاء. بأقدمية تعود إلى العام 1956، اعتبرت الصين استكشاف الفضاء أولوية للأمن القومي. وعلى خلفية إطلاق الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لأقمار صناعية في العامين 1957 و1958، أعلن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ: "سوف نصنع نحن أيضًا أقمارًا صناعية". وقد نفذ البلد ذلك، بإطلاق "دونغ فانغ هونغ 1" إلى المدار في نيسان (أبريل) 1970.
خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أنشأت الصين برنامجًا فضائيًا واسعًا مدفوعًا باعتبارات علمية واقتصادية وعسكرية. وفي العام 2000، نشرت الحكومة أول ورقة بيضاء تحدد أولوياتها في الفضاء الخارجي، التي شملت الاستفادة من موارد الفضاء، وإطلاق رحلات فضائية مأهولة، والشروع في استكشافات فضائية تركز على القمر. ويشكل مجال الفضاء أولوية خاصة بالنسبة لشي، الذي قال في العام 2013: "إن تطوير البرنامج الفضائي وتحويل البلاد إلى قوة فضائية هو حلم الفضاء الذي نسعى إلى تحقيقه باستمرار". وفي العام 2017، وضعت الصين خريطة طريق للتحول إلى "قوة فضائية رائدة عالميًا بحلول العام 2045"، مع تحقيق اختراقات كبيرة مخطط لها. وقد نفذت الصين ذلك فعليًا: إلى جانب برنامجها الفضائي التجاري المتقدم، طورت الصين قدرات قتالية فضائية متطورة، بما في ذلك نشر كوكبة متنامية من أقمار الاستطلاع والاتصالات والإنذار المبكر. ومن بين أكثر من 700 قمر صناعي أطلقتها الصين إلى مداراتها، يخدم أكثر من ثلثها أغراضًا عسكرية. وقد أشادت الورقة البيضاء للعام 2022 بهذا التقدم. ويعتقد بعض مسؤولي وخبراء الفضاء الأميركيين أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتكون الدولة الرائدة في مجال الفضاء خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بما في ذلك من خلال كونها أول من يعيد البشر إلى القمر منذ مهمة "أبولو 17" الأميركية في العام 1972.
مثلما هو الحال في أعماق البحار، تتيح القدرات التكنولوجية الكبيرة للصين وطبيعة الحوكمة الأكثر انفتاحًا في هذا المجال لبكين لعب دور قيادي كبير في الفضاء. فقد أصبحت بكين شريكًا مهمًا للدول الأقل تطورًا المهتمة بالبحث الفضائي والاستكشاف. وهي تمتلك اتفاقيات ثنائية مع 26 دولة. كما تتعاون مع "مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي" لإجراء تجارب من محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ".
لكنّ المسعى الأكثر أهمية لبكين في قيادة الفضاء هو "محطة الأبحاث القمرية الدولية" المخطط لإنشائها، وهي جهدٌ مشترك بين الصين وروسيا أُعلن عنه لأول مرة في العام 2017. ومن المقرر أن تبدأ المحطة كقاعدة دائمة عند القطب الجنوبي للقمر، وأن تتوسع تدريجياً لتصبح شبكة من المنشآت المدارية والسطحية التي تدعم الاستكشاف واستخراج الموارد والإقامة طويلة الأمد. وتهدف الصين إلى استقطاب 50 دولة و500 مؤسسة بحثية دولية و5.000 باحث من الخارج للانضمام إلى المحطة، من خلال منحهم فرصاً للتدريب العلمي والتعاون وإمكانية الوصول إلى بعض التقنيات الفضائية الصينية والروسية. ولتحقيق هذا الهدف، روّجت بكين للمحطة من خلال منظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون".
قدّمت بكين وموسكو "محطة الأبحاث القمرية الدولية" كبديل لبرنامج "أرتميس" الذي تقوده الولايات المتحدة -مسعى واشنطن للعودة إلى القمر- وكذلك كبديل لـ"اتفاقيات أرتميس". وكانت الاتفاقيات التي أرستها الولايات المتحدة وسبع دول أخرى في العام 2020، قد وضعت مبادئ وإرشادات غير مُلزِمة للاستكشاف السلمي للفضاء، واستخدام موارده، والحفاظ على التراث الفضائي، والتشغيل المشترك، ومشاركة البيانات العلمية. وصُمّمت الاتفاقيات لتكون منسجمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية القائمة في مجال الفضاء؛ وحتى أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت 60 دولة قد وقّعت عليها.
يصف أحد كبار الخبراء الصينيين الاتفاقيات بأنها محاولة أميركية لـ"استعمار القمر" وإرساء "سيادة عليه". لكن الصين لم تنجح كثيراً في جذب الدول إلى مشروعها؛ حيث لم تستقطب "محطة الأبحاث القمرية الدولية" سوى 11 دولة فقط إلى جانب الصين وروسيا، والعديد منها لا تملك برنامجاً فضائياً أو لديها برنامج ناشئ فحسب. وقد انضمت دولتان من الأعضاء -السنغال وتايلاند- لاحقاً إلى "اتفاقيات أرتميس" أيضاً. ويعود انتشار جاذبية هذه الاتفاقيات إلى عدة عوامل؛ على العكس من طمحطة الأبحاث القمرية"، تتأسس "الاتفاقيات" على علاقات قائمة مُسبقًا -علمية وأمنية وتجارية- بين وكالة أبحاث الفضاء الأميركية، "ناسا"، والدول الأخرى. وهي تمنح الدول الصغيرة فرصاً لتطوير صناعاتها الفضائية، وتقدّم معايير واضحة للشفافية والتشغيل المشترك ومشاركة البيانات، كما أنها لا تُقحم الدول في عزلة روسيا عن معظم النشاط الاقتصادي والعلمي العالمي. وأخيراً، وعلى خلاف "محطة الأبحاث القمرية الدولية"، سوف تحصل الدول الموقّعة على "اتفاقيات أرتميس" على فرصة لإرسال رواد فضاء منها إلى القمر من خلال برنامج "ناسا" القمري.
واجه النهج الأوسع للصين في حوكمة الفضاء صعوبات أيضاً. في العام 2022، لم تنضم سوى سبع دول أخرى إلى الصين في التصويت ضد قرار للجنة الأولى في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف تجارب الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية من نوع "الإطلاق المباشر"، والتي تنتج حطاماً فضائياً مدمّراً. وفي العام 2024، امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن بشأن قرار يدين وضع أسلحة نووية في الفضاء الخارجي -وهو قرار أيده جميع الأعضاء الآخرين باستثناء روسيا. كما أن محاولات بكين وموسكو لصياغة معاهدة خاصة بهما لمنع وضع الأسلحة في الفضاء لم تحصل إلا على دعم محدود من دول مثل بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية.
ومع ذلك، واصلت بكين التقدم. وهي تواصل الدفع بأطرها الحاكمة وتستثمر في التقنيات المتعلقة بالفضاء. وإذا ما استطاعت حقًا إعادة البشر إلى القمر أولاً، فإنها ستحقق ميزة رمزية قوية على الولايات المتحدة، والتي تعزز جهودها لتشكيل القواعد والتقنيات في سباق الفضاء.
الأسلاك الصلبة والقوة الصلبة
تعمل الصين للهيمنة على ما هو أبعد من المجالات المادية. يريد شي أيضاً أن تسيطر بكين على المجال السيبراني. وعلى مدى فترة ولايته، أصبحت الصين قوة اتصالات عالمية. ومكّنت مبادرة "طريق الحرير الرقمي" للعام 2015 شركتي الاتصالات الصينيتين "هواوي" و"زد. تي. إي" من الحصول على نحو 40 في المائة من سوق معدات الاتصالات العالمية، وفقاً لمقياس الإيرادات. كما يتمتع نظام الأقمار الصناعية الصيني "بيدو" بدقة تحديد مواقع تفوق نظام "جي. بي. إس" في العديد من مناطق العالم. وتزداد حصة الصين بسرعة في سوق تقنيات الكابلات البحرية.
وتسعى بكين أيضًا إلى وضع المعايير العالمية للتقنيات الاستراتيجية المستقبلية. وأدت مبادراتها، مثل استراتيجية "معايير الصين 2035"، إلى زيادة كبيرة في عدد المشاركين الصينيين والمقترحات الصينية في الهيئات المعنية بوضع المعايير. في العام 2022، قدمت "هواوي" وحدها -بحسب مجلة "الطبيعة" Nature- أكثر من 5.000 مقترح للمعايير التقنية إلى أكثر من 200 منظمة معايير. (ذكر بعض المراقبين الخارجيين أن بكين قوّضت أفضل الممارسات من خلال إصرارها على أن تصوّت الشركات الصينية ككتلة واحدة لصالح المقترحات الصينية، ومن خلال تقديم حوافز مالية للشركات لتقديم هذه المقترحات، ما أدى إلى طرح عدد كبير من المقترحات ضعيفة الجودة).
بالنسبة للصين، لا يقتصر وضع المعايير على ضمان مكاسب تجارية فحسب. بل يتعلق الأمر أيضاً بترسيخ قواعد سياسية وأمنية مواتية. ويبرز في هذا السياق مقترح الصين لإنشاء بنية جديدة للإنترنت تُعرف باسم "الإنترنت الجديد" (New IP). وكانت "هواوي" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم" ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قد تقدمت في العام 2019 بمقترح "الإنترنت الجديد" إلى المجموعة الاستشارية المعنية بتوحيد معايير الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، كانت حجة المسؤولين الصينيين هي أن بروتوكول "TCP/IP" العائد إلى سبعينيات القرن الماضي -والنظام المعتمد حالياً لتوجيه البيانات وتسليمها-لن يكون قادراً على تلبية احتياجات إنترنت المستقبل، مثل الانتشار الواسع للمركبات ذاتية القيادة. وبعيداً عن الجوانب التقنية، يعتقد القادة الصينيون أن الإنترنت الحالي، المبني على بروتوكول صُمّم في الولايات المتحدة، يعكس نظام حوكمة تقوده واشنطن ولا ينسجم مع مصالح بكين. وفي المقابل، يضمن "الإنترنت الجديد" التحكم المركزي للدولة، بما في ذلك تسهيل قدرة السلطات المركزية على إغلاق أجزاء من الشبكة. وهكذا، يشكّل "الإنترنت الجديد" محاولة من الصين لغرس تفضيلاتها التقنية والسياسية في بنية الإنترنت العالمية.
سرعان ما جاءت ردود الفعل السلبية على مقترح الصين من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك من أبرز مهندسي الإنترنت. ورأى الخبراء أن النظام القائم مرن بما يكفي للتطور، وأن "الإنترنت الجديد" سيؤدي إلى تجزئة الشبكة العالمية إلى شبكات تسيطر عليها الدول. وأشار الأوروبيون إلى أن البروتوكول الحالي لم يُعِق تطوير الذكاء الاصطناعي أو التقنيات المهمة الأخرى، كما أكدوا على ضرورة أن تتولى الهيئات التقنية الراسخة -وليس الاتحاد الدولي للاتصالات- وضع المعايير.
عملت الصين بجد لحشد الدعم لرؤيتها في الاقتصادات الناشئة والمتوسطة الدخل، فأنشأت "معهد بحوث شبكات المستقبل لدول ’بريكس‘" بهدف تنسيق الأبحاث والتطوير في شبكات الجيل السادس والذكاء الاصطناعي وبروتوكولات الإنترنت الجديدة. كما جادلت بأن بروتوكولات الإنترنت التي تقترحها، إلى جانب تمويل "طريق الحرير الرقمي" وتجهيزاته وبرامجه التدريبية، ستساعد في سد الفجوة الرقمية لدى الاقتصادات الناشئة. وقد دعمت عدد من الدول الأفريقية -ساحل العاج وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب السودان وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي- مقترح "الإنترنت الجديد". لكن الحماسة خارج هذه الدائرة كانت محدودة. ومن الجدير بالملاحظة، كما أشار المحللان هنري توغندهات وجوليا فو، أنها لم تكن هناك أي علاقة بين تلقي دولة ما مساعدات من "طريق الحرير الرقمي" وبين دعمها لمقترح "الإنترنت الجديد".
مع ذلك، لم تحرز بعض الجهود الرقمية الأخرى التي تبذلها الصين تقدّماً أكبر. ثمة الكثير من دول "بريكس"، بما فيها البرازيل ومصر وإثيوبيا والسعودية وجنوب أفريقيا والإمارات، التي تتعاون تجارياً مع "هواوي". كما تحاول الصين وضع الأسس لشبكة إنترنت تخضع لسيطرة الدولة من خلال سلسلة من المقترحات والتقنيات الجديدة. وعلى سبيل المثال، أعادت "هواوي" طرح مقترح "الإنترنت الجديد" تحت اسم "شبكات وبروتوكولات الاتصالات العمودية المستقبلية". وكما لاحظ مجموعة من الباحثين في جامعة أكسفورد، فإن الصين "تتسوّق" لمقترحاتها عبر أطر متعددة، فتقدّم المقترحات ذاتها أو المشابهة لها في هيئات مختلفة بحثاً عن قبول. وفي ورشة عمل حول شبكات الجيل السادس عقدتها إحدى هيئات وضع المعايير، ضغط المشاركون الصينيون من أجل تقنية "شبكة جوهرية جديدة بالكامل للجيل السادس" تسمح بتحكم أكبر، وهي تقنية تعمل "هواوي" على تطويرها مسبقًا. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين تطوير نظام توجيه لبيانات الإنترنت يعطي مزيداً من السيطرة لمزوّدي الشبكات والحكومات على حركة البيانات. ويقول الخبراء أن بكين طبقت هذا النظام في عدة دول أفريقية.
الرنمينبي مقابل أفكارك
من بين آخر الأعمدة المتبقية لهيمنة الولايات المتحدة العالمية الدور المركزي الذي يلعبه لدولار في الاقتصاد العالمي. ما يزال الدولار هو العملة الأكثر تداولاً والعملة الاحتياطية المهيمنة. وهذا يمنح الولايات المتحدة عدة مزايا: انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات الأميركية؛ والقدرة على تقييد الوصول إلى المعاملات المقوّمة بالدولار؛ واستمرار تفوق الأسواق المالية الأميركية.
لكنّ الصين عازمة على توسيع الاستخدام الدولي لعملتها، "الرنمينبي"، وعلى إزاحة الدولار عن موقعه. في أعقاب الأزمة المالية العالمية، اختبرت الصين في العام 2009 برنامج تسوية تجارية بالرنمينبي مع "رابطة دول جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ وماكاو". ولم تلقَ الجهود الأولية لتدويل الرنمينبي زخماً كبيراً، لكنها واصلت المسار. طرحت الصين سندات مقوّمة بالرنمينبي، ووسّعت خطوط مبادلة العملات مع أكثر من 30 دولة، وأنشأت بنوك مقاصة لتسهيل المعاملات بالرنمينبي في المراكز المالية الكبرى. وفي العام 2015، أطلقت "نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك"، المصمم ليكون بديلاً لـ"سويفت" -النظام الذي يهيمن عليه الأميركيون والأوروبيون. واليوم، يربط هذا النظام الصيني بين أكثر من 1.700 بنك حول العالم.
شكّل القطاع المالي العالمي، أكثر من أي مجال آخر، أرضية خصبة لجهود الصين لتعزيز مصالحها عبر أطر متعددة الأطراف. واستخدمت بكين مبادرة "الحزام والطريق" لدفع الدول الشريكة إلى قبول الرنمينبي في العقود. بل إن بعض الاقتصاديين الصينيين دعوا إلى إلزام المشاركين في المبادرة بإجراء التسويات بالرنمينبي. وقد أثمرت هذه الجهود: بحلول حزيران (يونيو) 2025، بلغت نسبة التجارة الثنائية للصين التي تتم تسويتها بالرنمينبي ما يقارب 29 في المئة.
تعزَّزت جهود الصين بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية. وقد شدد شي على هذه النقطة في خطاب ألقاه أمام "مؤتمر العمل المالي المركزي للحزب الشيوعي الصيني" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فقال: "تتعامل قلة من الدول مع المال كأداة لألعاب جيوسياسية. وهي تكرر اللعب بهيمنة العملة وتلوّح كثيراً بالعصا الغليظة للعقوبات المالية". بطبيعة الحال، تخلت إيران وروسيا، وهما من أكثر دول العالم تعرضاً للعقوبات، عن استخدام الدولار الأميركي في التجارة الثنائية. لكن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا دعمت أيضاً اعتماد العملات المحلية ونظام مدفوعات متصلاً لدول "بريكس"، حتى مع أنها لم تُبدِ اهتماماً بتقويض الدور المركزي للدولار.
كما حدث في مساعيها الاستراتيجية الأخرى، واجهت جهود الصين للترويج لعملتها انتكاسات. ولا يشكل الرنمينبي سوى 2.9 في المئة من المدفوعات العالمية من حيث القيمة، كما أن حصته في احتياطيات العملات الأجنبية العالمية بلغت ذروتها في العام 2022 عند 2.8 في المئة. واليوم، ما يزال الرنمينبي يراوح مكانه عند نحو 2.1 في المئة. ويتطلب تدويل الرنمينبي بالكامل مزيداً من الانفتاح في حساب رأس المال، وتحريراً مالياً أعمق، وتدخلاً حكومياً أقل في السياسة النقدية -وهي خطوات قد تُضعف سيطرة الحزب الشيوعي على الاقتصاد.
لكن الصين مستعدة أيضاً للابتعاد عن الدولار وتوسيع استخدام العملات المحلية من دون زيادة استخدام الرنمينبي. وقد نجحت في ذلك، جزئياً بفضل توظيف واشنطن للدولار كسلاح، وكذلك بسبب مخاوف دول أخرى بشأن استدامة الدَّين الأميركي. وقد انخفضت ملكية الأجانب لسندات الخزانة الأميركية من 49 في المئة في العام 2008 إلى 30 في المئة في العام 2024.
سباق نحو القمة، سباق نحو القاع
أوضح شي أنه يريد إصلاح النظام الدولي بطرق تعكس المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية للصين. وهو يريد أن تقود بلاده استغلال قاع البحار العميقة والقطب الشمالي والفضاء. ويريد إنشاء بروتوكول جديد للإنترنت يرسّخ سيطرة الدولة. ويريد إنشاء واستثمار والتجارة ضمن نظام مالي عالمي لا تهيمن عليه الولايات المتحدة ولا الدولار. ولتحقيق هذه الأهداف، أمضت بكين سنوات وفي معظم الحالات عقوداً- وهي تحشد مستوى استثنائياً من الموارد الحكومية والخاصة، وتطوّر رأس المال البشري، وتحاول السيطرة على المؤسسات القائمة، وتُنشئ مؤسسات جديدة. ولعل الأهم من كل ذلك هو أن بكين واظبت على نهجها. إنها تنتظر فرصها، وتُكيّف أساليبها، وتغتنم الفرص لتحقيق مكاسب كلما وأينما ظهرت.
لم تنتصر الصين بعد. حتى الآن، جاءت نتائج جهودها في نواحٍ كثيرة دون المأمول. لم يتبنَّ العالم بالكامل رؤية الصين للتغيير في أي من المجالات. وحتى الاقتصادات المتوسطة والناشئة، التي تدّعي الصين غالباً تمثيلها، كانت حذرة إزاء مقترحات بكين. ومع ذلك، حققت استراتيجية الصين نجاحات ملحوظة في كل مجال من هذه المجالات. الحكومة تمتلك موقعاً قيادياً داخل "الهيئة الدولية لقاع البحار". وقد رسخت نفسها لاعباً رئيسياً في التجارة في القطب الشمالي، وحصلت على وصول عسكري إلى المنطقة، وأعادت تشكيل السرديات بشأن من يحق له الجلوس إلى طاولة اتخاذ القرارات فيه. وفي الفضاء، تحولت إلى قوة علمية وعسكرية كبرى. وهي تحرز تقدماً في هيئات وضع المعايير التي ستساعد في إنشاء وحوكمة البنية التحتية التقنية العالمية. كما قلّصت الصين دور الدولار في النظام المالي الدولي، وزادت استخدام عملتها في التجارة الخارجية، ووسعت انتشار نظام المدفوعات البديل الذي تقوده. كما أن القدرات التي راكمتها الصين في كل من هذه المجالات -سواء كانت علمية أو دبلوماسية أو عسكرية أو مؤسساتية أو مادية- تضعها في موقع يمكّنها من مواصلة دفع رؤيتها إلى الأمام. وهذا يعني أنه على الرغم إخفاقاتها حتى الآن، فإن من غير المرجح أن تغيّر بكين مسارها، بل ستواصل التقدم.
للرد على ذلك، أمام الولايات المتحدة ثلاثة خيارات: التراجع ومنح الصين المجال الذي تريده؛ أو السعي إلى إيجاد أرضية مشتركة؛ أو المنافسة النشطة. الخيار الأول غير صالح؛ سوف يكبد التراجع الولايات المتحدة تكاليف مادية تترتب على قدرتها على حماية أمنها السياسي والاقتصادي والقومي. والخيار الثاني مغرٍ، حيث يمكن للبلدين توسيع التعاون العلمي في أعماق البحر وفي الفضاء. لكن الفجوة بين الرؤيتين في معظم المجالات كبيرة جداً بحيث لا يمكن جسرها، على الأقل في المدى القريب.
بذلك، لا يبقى سوى الخيار الثالث. ولكن، حتى تتمكن الولايات المتحدة من المنافسة والدفاع عن الحوكمة القائمة في مجالات الريادة أو تحسينها، فإنها ستحتاج إلى إعادة بناء قدراتها واستعادة سمعتها كقائد عالمي مسؤول. القدرات الصلبة لواشنطن -بما فيها كاسحات الجليد القطبية؛ ونماذج التعدين في أعماق البحار؛ وابتكارات المدفوعات المالية؛ وتكنولوجيا الاتصالات؛ واستكشاف القمر وغيرها من تقنيات الفضاء- إما أنها متأخرة فعليًا عن مثيلاتها الصينية أو أنها ستتأخر قريباً. ولحل ذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى الاستثمار في كل واحدة من هذه القدرات.
اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض الخطوات الأولية في هذا الاتجاه بإصداره أوامر تنفيذية تدعم بناء "قواطع أمنية" للقطب الشمالي، وتخفيف القيود على الصناعات المتعلقة بالفضاء، ودعم إرسال رواد فضاء إلى المريخ. كما تدعم أوامره تطوير تقنيات تعدين قاع البحار. وتعمل واشنطن على دعم العملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى لتعزيز الطلب على الدولار، وكذلك على الترويج عالمياً لحزمة التقنية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن هذه الخطوات لا تشكل الخريطة طويلة المدى التي منحتها الصين لمسؤوليها وصناعاتها. تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية شاملة في كل مجال، تتضمن رؤية واضحة لأهدافها الاقتصادية والأمنية، واستثمارات كبيرة في القدرات الصلبة الحيوية على المدى القصير، ودعماً مستمراً للأبحاث والتطوير لضمان القدرة التنافسية على المدى الطويل. وسيتطلب تمويل هذه الاستثمارات أشكالاً مبتكرة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، على غرار "قانون الشرائح والعلوم" في عهد إدارة بايدن والمتعلق بأشباه الموصلات، وشراكة وزارة الدفاع في عهد ترامب مع شركة "إم بي ماتيريالز" بشأن معادن "الأتربة النادرة". وستحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان أن تعكس مؤسسات الحوكمة في هذه المجالات قيم الشفافية والانفتاح والمنافسة السوقية. وبخلاف ذلك، لن تتمكن الولايات المتحدة من مجاراة قدرة الصين على تغيير بنية أي مجال بمجرد إعلانها ملكية هذا المجال.
ستحتاج واشنطن أيضًا إلى إعادة ترسيخ مكانتها كقائد عالمي مسؤول. وعلى سبيل المثال، سرّعت حرب ترامب الجمركية من عملية "التخلّي عن الدولار" من خلال جعل الولايات المتحدة حَكَمًا غير موثوق به للاقتصاد العالمي. وكما أشار الاقتصادي كينيث روغوف، فإن تهديد البلدان يؤدي فقط إلى تشجيعها على تنويع عملاتها. كما أن تهديد إدارة ترامب بتجاهل حظر "هيئة قيعان البحار الدولية" على استخراج المعادن من قاع البحر سيتسبب في حدوث شروخ مع العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وقد يطيح بنظام الهيئة. وقد يؤدي ذلك إلى سباق فعلي نحو القاع -وهو سباق تستعد الصين للفوز به بدرجة أكبر بكثير من الولايات المتحدة نظرًا لقدراتها. وفي مجالات مثل حوكمة الإنترنت والنظام المالي العالمي، ستحتاج واشنطن إلى استخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات التكنولوجية والمالية والدبلوماسية من أجل إقناع الدول الأخرى بتبنّي الرؤية الأميركية.
ما تزال لدى الولايات المتحدة نافذة فرصة لإعادة تأكيد قيمة عرضها واصطفاف العالم خلف قيادتها. رغم سلوك ترامب المتقلّب، تظل واشنطن شريكًا أكثر تفضيلًا لدى معظم الحكومات. لكنّ الإدارة ستحتاج إلى التوفيق بين توجه "أميركا أولًا" وبين واقع عالم يزداد تعدديةً في الأقطاب، وهو ما يتحقق من خلال الجمع بين الصفقات المعاملاتية وإطار استراتيجي أوسع يقدّم فوائد حقيقية للدول الأخرى. ويُقدّم إنشاء الإدارة الأولى لترامب "اتفاقات أرتميس" نموذجًا مفيدًا. فقد صاغت الإدارة تلك الاتفاقات لتكون قائمة على قواعد، وشفافة، وتعاونية، وشاملة، مع توفير برامج لبناء القدرات في مجالات مثل قانون الفضاء، وحوكمة الموارد، وبيانات الأقمار الصناعية. وتُميّز المبادرات التي تجسد هذا النوع من الابتكار والانفتاح والشراكة الحقيقية القيادةَ الأميركية عن القيادة الصينية، كما أنها توفّر أفضل فرصة للحفاظ على النفوذ الأميركي عبر آفاق النظام الدولي غير المستكشفة.
*إليزابيث إيكونومي Elizabeth Economy: باحثة أميركية بارزة متخصصة في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية، وتعدّ من أهم الأصوات الأكاديمية في تحليل سياسات الصين الداخلية والخارجية. تعمل باحثة أولى في دراسات الصين بمعهد هوفر في جامعة ستانفورد، وقد شغلت سابقًا منصب مديرة دراسات آسيا في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك. تركز أعمالها على الحوكمة البيئية في الصين، والتحولات السياسية في عهد شي جين بينغ، وطموحات بكين الجيوسياسية في إعادة تشكيل النظام الدولي. وهي مؤلفة لعدة كتب مؤثرة، من بينها “النظام العالمي الصيني: طموح بكين لإعادة تشكيل العالم”، وتُعدّ كتاباتها مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين المهتمين بفهم استراتيجية الصين الصاعدة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: How China Wins the Future: Beijing’s Strategy to Seize the New Frontiers of Power
