عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"كيف تجد الغول".. مزيج من الخيال الشعبي والواقع المعاش
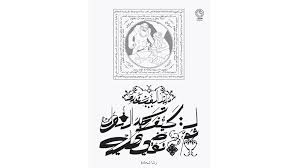
الغد-عزيزة علي
"دليل المستخدم: كيف تجد الغول، ثم لا تقضي عليه"، ليس مجرّد كتاب؛ إنه بوابةٌ نفتحها على عالمٍ منسيّ، نعيد من خلاله سرد الحكاية، لا بهدف إغلاقها، بل كي تستمر في الدوران. في هذا العمل، تمزج الباحثة رشا شحادة بين الخيال الشعبي والواقع المعاش، بين الحكاية كأداة بقاء، والقرية كأثرٍ على الأرض وفي الذاكرة.
في هذا الكتاب، الذي صدر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، لا تُستعاد البرية فقط كقرية دُمّرت عام 1948، بل تُبعث ككائن حيّ، يُروى تاريخه من خلال: الأسماء: شخوص الحكاية، والمخاتير، وأهالي القرية. الاقتصاد: نحل، زراعة، ربيعٌ تفوح منه الميرمية والزعتر. الخراب: بيتٌ واحدٌ صامد، وجدرانٌ من إسمنت مكشوف، وقضبان حديد تشهد على الذاكرة التي لم تكتمل محوًا.
Ad
تبدأ الحكاية بلعبة، لكنها ليست عبثًا. إنها لعبة معرفية تتبع أثر الغول، لا لتدميره بالكامل، بل لفهمه، تفكيكه، وإعادة الحكاية إلى أصحابها.
تنقلنا شحادة، بمرونة راوية ومهارة باحثة، من "دهليز" الحكاية الشعبية إلى تفاصيل قرية "البرية" المهجّرة قضاء الرملة، حيث تصير أرض الحكاية أرضًا فعلية، لها أسماء وبيوت، لها نحلٌ، وبطيخ، وشخوص من لحمٍ ودم. فهذا الكتاب ليس فقط دعوة للعب، بل للانتباه. للبحث عن الغول... ولمعرفة من الذي التهم الحكاية، ثم إعادتها إلى أهلها.
تقول مؤلفة الكتاب شحادة، إن المهمة التي سنخرج بها هي البحث عن الغول المختبئ بعناية في أطراف الحكاية. سنتعقبه، ثم "سنكمسره"، وبعدها "نلعن سنسفيله". سأطلب منك أن تقوم بخطواتٍ للدخول في الحكاية من دهليزها، لتبحث عن الغول بنفسك. تشجّع، لا تخف؛ فأنت تملك كل المعرفة التي تحتاجها لإيجاده... ثم القضاء عليه.
وسندخل في تجربة تأملية من نوعٍ خاص، نحفّز فيها الخيال بالقليل، ونتلقى منه الكثير. لندع أنفسنا للخيال دون مقاومة، لنشاهد ونُصغي لهذا العالم الآخر الممكن. وباستعارة من ابن عربي "الزمان مكان سائل، والمكان زمان صلب". ونحن سنكون بين "هنا" و"هناك"، في أرض الحكاية الشعبية.
إن كنت تتساءل: ما الحكاية الشعبية؟ وما الدهليز؟ من هو الغول، ومن هما الشاطر حسن وست الحُسن؟ ماذا حصل لذلك الذي لحق بالضبع؟ وكيف يمكننا دخول الحكاية؟! وإن وجدت الغول، فما آداب ملاقاته؟ وكيف تقضي عليه؟ وإن نجوت ولم تُؤكَل، فكيف تخرج من الحكاية؟ سأجيبك على كل ما يجول في خاطرك من أسئلة، بينما نتتبع الغول خطوةً بخطوة، من خلال درب اللعب.
سأكون مرشدتك في هذه المغامرة، رشا البرّية، مدرّبة نجاة ومرشدة براري في أنحاء الحكاية. أبحث عن الغول بشكلٍ عكسي، من مخيمات الشتات إلى قريتي البرّية، قضاء الرملة في فلسطين. كان أهل القرية معروفين بصناعة العسل. وبرغم النكبة والنزوح، واصل جدي صناعة العسل، حتى بعد أن استقر في قلب المخيم. أما جدّتي، فقد جاءت محمّلة بصندوق كبير من الحكايا.
ولأن الحكايا، كالصيرورة، لا تتبع دائمًا تسلسلًا زمنيًا تقليديًا، ولأنها مفتوحة على احتمالاتٍ متعددة، تبقى شخوصها في حالة من التغير المستمر. فالحكايا ليست ثابتة ولا مكتملة، بل هي عملية تحوّل دائمة. لهذا، لماذا لا نبدأ البحث عن الغول من هنا والآن؟ من الشتات والمخيّمات، وصولا إلى فلسطين ما قبل الاستعمار، فلسطين المحرّرة، من البحر إلى النهر.
خطوات اللعب هذه، رغم جديّتها الجادّة جدًا، تفتح أمامك بابًا لخوض تجارب متنوّعة ومفاجئة. فعالم الحكاية يزدحم بالمواقف غير المتوقعة، وبالأحداث العجيبة. لذلك، إن لم تكن مرنًا وذو حيلة، فستُغلب. أما إن كنت تجيد اللعب، فستمتلك الحكاية، وتُحرّك أحداثها كما تشاء.
في رحلة البحث والتقصّي عن الغول، قفزتُ من حكايةٍ إلى أخرى، مستعينةً بكتاب "قول يا طير: نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية"، للباحثَين شريف كناعنة وإبراهيم مهوّي، الذي يوثّق الحكايات الشعبية في عدد من مناطق فلسطين: الجليل، الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وقد جُمعت هذه الحكايات بين عامَي 1978 و1980. وكنتُ، كلما وجدتُ الغول ثم قضيتُ عليه، أضع علامةً على بوابة الحكاية، ليستدلّ عليه من يأتي بعدي. ستقول لي: "ولكنكِ قضيتِ عليه، فكيف أجده؟"، معك حق. لكن، لحسن حظه وحظك، أنه كلما رُويت حكايته، عاد. فلا تقلق، سيكون في انتظارك في كل مرة.
وعندما تنتهي من رحلة البحث، احكِ لنا ما جرى معك: أين جلستَ تنتظر الغول؟ كيف لاحظتَ وجوده؟ كيف بدا شكله؟ وما الحديث الذي دار بينكما؟ من ساعدك في القضاء عليه؟ وما كانت خطتكم للقضاء عليه؟ ثم لا تنسَ أن تبدأ حكايتك بدهليز،
وتُنهيها بعبارة "هذه حكايتي حكيتها، وعليكم رميتها". فمن يلتقطها، يحين عليه الدور في سرد حكايته. هل أنت مستعد للعب؟ إن كانت إجابتك: نعم ، فأهلًا بك في عالم الحكاية. أعطني يدك... واحد... اثنان... ثلاثة... اقفز!!
ثم تتحدث عن قرية "البرية"، التي هي إحدى القرى الفلسطينية المهجرة والمدمرة نتيجة التطهير العرقي خلال نكبة عام 1948، وكانت تابعة لقضاء الرملة. بلغ عدد سكانها ما يقارب 590 نسمة إبان النكبة. تقع البرية في أقصى الجنوب الشرقي من القضاء، على بعد ستة كيلومترات من الرملة مركز القضاء، يمر بالقرب من أراضي البرية الشمالية الطريق العام الواصل بين القدس والرملة، ويربط هذا الطريق طريق مرصوف من القرية إلى الطريق العام، بطول يقارب نصف كيلومتر. يحد البرية من الشمال والشمال الغربي أراضي مدينة الرملة، ومن الجنوب قرية أبو شوشة، ومن الجنوب الشرقي قرية القباب، ومن الشمال الشرقي قرية عنابة.
وفيما يتعلق بسبب تسمية البرية بهذا الاسم، يروي الحاج عبد القادر حمد، وهو من مواليد القرية: "كان فيها شيخ صاحب طريقة يقولون له (بري)، وقُبروه فيها، فسُميت البرية على اسمه".
وعن عائلات البرية تقول المؤلفة، إن القرية عرفت عدة عائلات منها: الشيخ الخطيب، حسن سلامة، خليل، حسان، علي، حمد، ضيف الله، عبد الله، شقير، عقل إبراهيم حمد، محمود، شحادة، سليم، رشيد، السنباطي، ومبارك.
أما المخاتير، ففي أواخر العهد العثماني، كان في القرية مختاران، وكان من يتغيب منهما يُعين وكيل عنه، ويعد المختار أصغر ممثل. إداري في جهاز القضاء الإداري. وكان المختار مسؤولاً عن تسجيل المواليد والوفيات، وتوثيق الزيجات، وتقديم المعلومات للسلطات في الرملة. كما كانت تقع على عاتق المخاتير مهمة تحصيل الأموال الأميرية المستحقة على السكان.
ومن شروط اختيار المختار أن يكون حسن السيرة والسلوك، ومن ملاك القرية، وأن يعرف القراءة والكتابة. غالبًا ما كان بيته يعمل كمضافة أو ديوان، وكان يحظى بكل احترام وتقدير. من مخاتير البرية في نهاية العهد العثماني: "عمر الهنوني، حسن صالح"، أما مخاتير البرية في فترة الانتداب البريطاني فكانوا: "المختار الشيخ عمر سلامة، يوسف علي، وحسن صالح".
أما الحياة الاقتصادية في قرية البرية فكانت الزراعة البعلية وتربية النحل من أهم ركائز الاقتصاد القرية. وقد أشارت البعثة الملكية البريطانية، التي زارت القرية عام 1936، إلى أن البرية كانت من القرى الرائدة في العناية بالنحل. ونظرًا لخصوبة تربة القرية، اعتمد الأهالي على الزراعة كمصدر أساسي للعيش، وكانت زراعتهم بعلية تعتمد على مياه الأمطار.
تنقسم المزروعات في القرية إلى موسمية شتوية مثل: القمح، والشعير، والقطاني؛ وصيفية مثل: الذرة، والسمسم. كما زرع الأهالي أنواعًا مختلفة من الأشجار المثمرة، أبرزها: الزيتون، والتين، والعنب، واللوزيات، والصبّار.
واشتهرت القرية أيضًا بزراعة محاصيل الخضار، مثل: البطيخ، والخس، والفقوس، والخيار، والبندورة، خاصة في الأراضي الممتدة حول وادي البرية. وفي الربيع، كانت الطبيعة تزيد القرية بهاءً، حيث تزينها الورود البرية، والزعتر، والميرمية، والبابونج، والعديد من النباتات العطرية التي تنتشر في المنطقة.
أما ما تبقّى من القرية اليوم بعد احتلالها قبل العصابات الصهيونية في عام 1948، فقد قامت هذه العصابات الصهيونية بترميم منازل قرية البرية بهدف إيواء أعضاء نواة استيطانية تابعة لمنظمة "يازق"، والتي أنشأت لاحقًا قرية "عزاريا" كموقع مؤقت. فيما بعد، استُخدمت مباني القرية كمصدر لمواد البناء والرصف.
أما موقع القرية اليوم، ممهد على وجه الإجمال، فقد سُوِّي بالأرض إلى حدٍّ كبير، باستثناء منزل حجري واحد ما يزال قائمًا، وبقايا جدران منزلين إسمنتيين تبرز منها قضبان الحديد.
أما المغتصبات الصهيونية على أراضي القرية: تقام اليوم على أراضي قرية البرية مستعمرتان صهيونيتان على أرضي القرية وهما "عَزاريا: التي أُسست عام 1949، بعد عام من احتلال القرية. أما كفار شموئيل، التي أُقيمت عام 1950 على أراضٍ تعود لقرية عنّابة المدمّرة (قضاء الرملة)، فتقع على بُعد نحو 4 كيلومترات إلى الشرق من موقع البرية".
