عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"النظريات النقدية" لعبدالله العنبر: قراءة معمقة للنصوص الأدبية
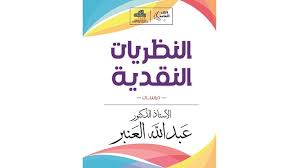
الغد-عزيزة علي
صدر عن وزارة الثقافة، ضمن سلسلة "فكر ومعرفة"، كتاب بعنوان "النظريات النقدية" للدكتور عبد الله العنبر، أستاذ النحو واللسانيات في الجامعة الأردنية. يقدم الكتاب قراءة نقدية معمقة للنصوص الأدبية من خلال تحليل النظريات النقدية المعاصرة ومراجعتها، ليقدم للقارئ أفقا جديدا لفهم دينامية النص الأدبي وتعدد قراءاته، ومواكبا بذلك التحولات المعرفية والجمالية في المشهد الأدبي العربي.
يضم الكتاب أربعة أبواب، يتناول كل منها محورا من محاور النقد الأدبي الحديثة؛ إذ يتحدث الباب الأول عن "النظرية البنائية: قراءة في دينامية النص الأدبي ودوائر الإبداع"، بينما يعالج الباب الثاني موضوع "المناهج النقدية بين الذاتية والموضوعية".
ويقدم الباب الثالث دراسة بعنوان "قراءة نقدية: التجاوز التقليدي وأوهاج الدلالة"، في حين يناقش الباب الرابع "النظرية الأسلوبية بين التماسك النصي وفرادة التشكيل"، ليشكل الكتاب في مجمله إضافة نوعية للمكتبة النقدية العربية.
في مقدمة الكتاب، يرى المؤلف أن عمله ينطلق من إشكالية محورية تتمثل في تمرد النصوص الأدبية على النظريات النقدية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تلك النظريات وتعديلها بما يواكب التحولات النصية الناتجة عن مرايا التجاوز ودوائر الإبداع.
ويشير العنبر إلى أن النص الأدبي ليس كيانا مغلقا أو نسقا ثابتا، بل هو تفاعل حي بين أيديولوجيات متباينة ومرجعيات متعددة. ومن ثم، فإن النظر إليه بوصفه نسقا متماسكا يشكل وهما تجاوزته الممارسة النقدية الحديثة. فالنص يبدأ من الاختلاف وينتهي إليه، ويقوم على تأجيل المعنى وتنوع آفاق التوقع، وهو ما يجسد جوهر أدبية الأدب.
ويرى العنبر إلى أن تعدد الثقافات وتنوع الأيديولوجيات داخل النص الأدبي يؤدي بالضرورة إلى تعدد القراءات وتنوع التأويلات، الأمر الذي يجعل من النص فضاء مفتوحا للتفاعل والتأمل والإبداع. ويشير المؤلف إلى أن هذا الكتاب يشكل تثويرا جذريا في مراجعة النظريات النقدية المعاصرة، عبر مقاربة متجددة لمفاهيمها ونماذجها والإجراءات المنهجية التي تستند إليها. وتأتي هذه المراجعة في إطار البحث عن نظرية نقدية قادرة على قراءة النصوص الأدبية ومواكبة تحولاتها الجمالية والمنهجية.
ويقدم العنبر في هذا السياق تسع نظريات نقدية، جاءت على النحو الآتي: ويبين المؤلف أن الكتاب يستعرض تسع نظريات نقدية، هي: البنائية، والشعرية، والأدبية، والأسلوبية، والإبلاغية، والقراءة النقدية، والتماسك النصي، والتلقي، والنقد الاجتماعي. وتشكل هذه النظريات مرايا متعددة قادرة على محاورة النصوص الأدبية محاورة تجمع بين الذاتية والموضوعية، في سعي لتحقيق رؤية شمولية تنظر إلى البنية السطحية للنص بوصفها تمثيلا للبنية العميقة وتجسيدا لها.
ويلاحظ المؤلف أن هذه النظريات تجاوزت حدود البنية اللغوية إلى استكشاف تجلياتها الجمالية الناتجة عن مظاهر المشاكلة والاختلاف، لتكشف عن السمات الفارقة وفرادة البنى النصية، من خلال إبراز تأثيرها الجمالي القائم على وجوه المغايرة التي تسهم في تشكيل دوائر الإبداع وتجليات الدلالة.
ويبدو أن النظرية النقدية الملائمة لتحليل النصوص الأدبية ما تزال بحاجة إلى إعادة نظر في أدواتها ووسائلها المنهجية؛ ذلك أن النصوص الإبداعية تتحدى منطق العقلانية، إذ يقودها التأجيل والتمنع والغياب والتجاوز، مما ينفي الثبات والحصانة عن علاقة الدال بمدلوله، ويجعل النظريات النقدية مطالبة دوما بمواكبة التحولات النصية وتجدد طرائق اشتغالها.
ويرى العنبر أن النقد الأدبي المعاصر مدعو إلى دراسة النظريات النقدية دراسة موضوعية، تسعى إلى الوعي بالإجراءات المنهجية التي توظفها هذه النظريات في قراءة النصوص الأدبية، والكشف عن الأنساق الثقافية التي أسهمت في تشكيلها وتوجيه مساراتها.
ويشير المؤلف إلى أن النظرية البنائية تقوم على البنية بوصفها مدخلا جوهريا للكشف عن جدلية الإفراد والتركيب، فهي تسعى إلى توضيح كيفية أداء البنى لوظائفها الجمالية داخل النص. كما يوضح أن التماسك النصي يشكل منهجا قادرا على إبراز الطاقات التعبيرية المهيمنة على عملية إنتاج الدلالة ومضاعفتها، بما يحقق أقصى تجليات المعنى والإبداع.
ونوه العنبر إلى أن العدول الأسلوبي يشكل تجاوزا للمستوى المألوف في التعبير اللغوي، بوصفه لعبة جمالية تقوم على التخفي والالتفاف من أجل بلوغ عوالم التجلي والإيحاء. كما يوضح أن النظرية الشعرية تمثل نظرية داخلية للأدب، تعنى بطرائق توظيف اللغة توظيفا فنيا خاصا، يتخطى المألوف ويكشف عن الوسائل الكامنة وراء فتنة اللغة وتجليات الدلالة.
ويرى أن الوظيفة الشعرية تحرر البنى من سياقها المعجمي لتبلغ فرادة التشكيل وجمالية التلقي، وأنها تعتمد في جوهرها على حيوية المجاز الذي يسمو بلغته ويتجلى باختلافه، ليشكل وجها من وجوه الجمال الفني.
وخلص المؤلف إلى أن الوظيفة الشعرية تقوم على حيوية المجاز الذي تسمو لغته ويتجلى اختلافه، ليشكل وجها من وجوه الجمال الفني في النص الأدبي. كما يبين أن الأدبية هي الكشف عن السمات التي تجعل من الأدب أدبا، إذ تستند إلى الإيقاع والتكثيف ودقة النظم، سعيا إلى تعزيز الطاقة التعبيرية ورفع مستوى الأثر الإبلاغي في النص.
في خاتمة الكتاب، يشير العنبر إلى أن النظريات النقدية تضع الناقد الأدبي أمام رسالته الحضارية، لتتاح له القدرة على إعادة إنتاج الثقافة وتحويلها إلى أقصى درجات الوعي لمعرفة قضايا الكون والإنسان. كما تتيح هذه النظريات تطوير الوعي النقدي من جيل إلى آخر، مما يستدعي أن تكون متجددة وقادرة على مواكبة النصوص الأدبية بمختلف أماكنها وأزمانها، لمجاراة وجوه الاختلاف وتحولات الدلالة.
ويبين المؤلف أن النظرية البنائية تمثل ثورة معرفية تتقاطع مع عدد من العلوم، ويرى النقاد أنها تعد "أم العلوم" في مجال النقد. فهي منهج تفسيري نقدي يوضح سلطة التحكم الكامنة وراء البنى اللغوية، ليبرز الوجه الكلي الذي تنتهي إليه طبقات الدلالة. ويلاحظ أن البنية تعد العنصر الحاسم في التحليل البنائي، إذ تكشف الأنساق التي يتجلى من خلالها النص الأدبي وتبين جماليات التشكيل ومرايا الدلالة.
وتكشف النظرية عن نظام المتحكم في وجوه الأداء اللغوي على نحو خاص، كما توضح ثنائيات الضدية والعناصر المهيمنة ومستويات القول، لإبراز أدبية الأدب. كما توضح الوسائل التي تضيء طاقة اللغة ودوائر الإبداع وتحقق المقاصد الجمالية للنص.
وتبدأ النظرية البنائية بقراءة النص الأدبي انطلاقا من نسجه اللغوي، فهي تبدأ باللغة وتنتهي بها، وتنظر إلى النص على أنه مكثف بذاته، مع إعطاء البنية أولوية على العناصر المكونة لها، وتبين التقنيات المنظمة للبنى المميزة التي تمنح النص فرادته وجماليته.
يوضح الكتاب أن النظرية الجديرة بتحليل النص الأدبي هي تلك التي تنطلق من النص ذاته، وتجعل البنية اللغوية جوهر تحليلها، لتظهر علاقة الدوال بمدلولاتها في سياق بحث مستمر عن أدبية الأدب. ومن هذه النظرية ينبثق مدخل منهجي آخر يقرأ ما وراء اللغة للكشف عن المراجع الاجتماعية الناظمة للأنساق التي نشأ فيها النص الأدبي.
اما الوظيفة الشعرية فتمثل وجها مختلفا في تحقيق التكوثر البياني، من خلال لعبة تنظم أشكال الربط التقليدي والأنساق الجمالية التي يتجسد من خلالها هدف المعنى. تنطلق هذه الوظيفة من إرادة التجاوز، إذ تحرر البنى من سياقها المعجمي، معلنة التخفي الذي يؤدي إلى مرايا التجلي.
كما تمثل الإبلاغية توظيفا للكلمات على نحو خاص، تتخطى فيه سياقها المعجمي، فتفرض حضورها في غيابها، وتضيء طاقة اللغة، وتجسد سطوة الإبداع. وفي سياق ذي صلة، يظهر النقد السوسيولوجي البناء الاجتماعي الكامن وراء ظواهر اللغة، ويكشف العلاقات المسؤولة عن تشكيل وجوه النظم وتجليات الدلالة. ويضيف المؤلف أن هذا النقد يضبط سيرورة العناصر اللغوية بحثا عن المقصد الذي يشكل دينامية النص الأدبي، وينطلق من فكرة مفادها اختلاف البنية عن المرجع الذي تنتمي إليه، إذ يقود النص الأدبي المتخيل الذهني الذي تتحرك فيه مرايا التجاوز ودوائر الإبداع.
ويوضح أن نظرية التلقي تقوم على إنتاج المعنى النصي من خلال الفراغات المعرفية التي يحتكم إليها النص في تشكيله. فهي بيان للأبعاد المتعددة والوظائف الكامنة داخل الأنساق، لكشف سيرورتها النصية وآفاقها المرجعية، بما يسهم في اقتران الدلالة بالسياق الاجتماعي والتاريخي الذي ينتمي إليه النص.
ويخلص العنبر إلى أن النظرية الأسلوبية تهدف إلى إظهار المظاهر الجمالية للغة، إذ يشكل الابتعاد عن النمط المألوف وجها خاصا في تشكيل المقصد. كما تسهم هذه النظرية في إظهار الفائض الدلالي للنص، الذي يتجلى عبر جماليات التجاوز والفرادة، لتكسب النص بعده الإبداعي والجمالي المميز.
