عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"من اللغة إلى الكتابة".. دراسات نقدية تتناول الإبداع وتحولاته
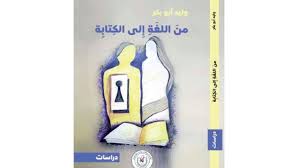
الغد-عزيزة علي
صدر عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين كتاب جديد للروائي والناقد والمترجم وليد أبو بكر بعنوان "من اللغة إلى الكتابة"، يضم ثلاث عشرة دراسة نقدية تتناول قضايا اللغة والإبداع وتحولات الكتابة.
يواصل أبو بكر في هذا العمل مسيرته النقدية المتميزة، متأملا العلاقة بين اللغة بوصفها أداة تفكير وتعبير، وبين الكتابة بوصفها فعلا معرفيا وجماليا.
استهل أبو بكر الكتاب بدراسة بعنوان "من لغة الأدب إلى لغة الإعلام"؛ حيث يطرح سؤالا مهما حول أهمية اللغة، قائلا: "إذا غاب التأمل حول السؤال الذي يدور حول ما تعنيه اللغة داخل عملية الاتصال الإنساني، قيل إنها أداة اتصال، أو وسيلة له، أو وعاء. فهل اللغة كذلك حقا. اللغة، في محاولة أولية للتعريف، هي مجموعة من الرموز الاصطلاحية القادرة على "الانتقال"، بما تعبر عنه من أفكار بين أفراد مجتمع إنساني بعينه. وهي، كما ذكر ابن جني في كتابه "الخصائص" قديما، "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم". أما في النظرة الحديثة، فهي "نظام من الرموز الصوتية، تمكن جماعة اجتماعية من التواصل بواسطتها".
ويبين أبو بكر أن النظرة الحديثة تقبل اللغة كوسيلة، وحين تفسر النظرة العربية القديمة، تعطى لفظ "يعبر" معنى تعسفيا يقصد به الأداة أو الوسيلة أيضا، لكن التأمل قد يحول دون هذا المعنى.
وإذا كانت النظرة الحديثة؛ في علوم اللغة، أو فقهها، أو فقها، أو الألسنية، تؤكد أن اللغة نظام وضعي، أساسه الرموز الصوتية التي جرى عليها الاتفاق، وهدفه الاتصال، فإن كل هذه الأمور تثير التساؤل حول الإشارة إلى اللغة كأداة: فهل هي أداة حقا في عملية الاتصال؟
ويوضح أبو بكر أن اللغة التي يتحدث عنها هي اللغة الطبيعية، أي لغة الصوت الإنساني، والحرف الذي اكتشفه الإنسان بعد أن تحول -بالتركيب والتتابع والتشكيل- إلى رموز. وهي ليست اللغة الوحيدة في حياة الإنسان، إذ اخترع لغات صناعية تناسب تطوره، وهي أيضا عبارة عن رموز اصطلاحية، لكنها ليست لغات طبيعية (مكتشفة)، لأنها غير متصلة -على الأقل- بأعضاء الإنسان التي يعد كل ما هو طبيعي امتدادا لها ولملكاتها.
ثم يطرح أبو بكر تساؤلا آخر، وهو: هل هذه اللغات الصناعية -كلغة الرياضيات، بمعنى رموزها- هي أدوات أيضا؟
إن التأمل يقود إلى القول إن الأداة هي الآلة، طبيعية كانت أو صناعية، وإن ما يوضع في الآلة ليتحول أو لينتقل، ليس هو الآلة نفسها، ولا الأداة، ولا الوسيلة، بل شيء آخر تماما.
ويرى المؤلف أن اللغة، من هذا المنطلق، شيء آخر، لأنها أصبحت "وسيلة التعبير" في مجتمعنا، من وجهة نظر حتمية سابير وورف. فهل يمكن أن تمنح هذه القيمة الكبيرة للوسيلة؟ أم أن ما فطنت إليه الكاتبة الأميركية سانورا راب، حين ذكرت أن "الإشارة إلى الكلمات باعتبارها أداة تسيء إلى الكلمات"، هو الأقرب إلى موقع اللغة؟
ويقول أبو بكر إن مثل هذه الإشارة -من دون نسيان تعريف ابن جني- تدعو إلى البحث عن مكانة أفضل للغة في عملية الاتصال الإنساني، تلك العملية التي يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل الرسالة ومتلقيها في إطار اجتماعي معين. ويبدو أن مثل هذا التعريف يعتبر الرسالة أداة، إذا تصورنا أن عناصر الاتصال ثلاثة: المرسل، المستقبل، والأداة.
ثم يطرح التساؤل: ماذا عن الآلة المرسلة؟ أليست هي أداة الاتصال حقا، سواء أكانت جهاز النطق، أو الإذاعة، أو الصحيفة؟ وماذا عن الرسالة إذا؟ عن ماهيتها، وعن وظيفتها؟
وفي دراسة أخرى بعنوان "لونان من الكتابة: نوعان من القراء"، يتناول أبو بكر مجموعة من الخصائص والمقومات التي يجب أن تتوافر في الكتابة. أولها تعلم الكتابة، حيث يتحدث عن الموهبة وتوابعها، والشكل والمحتوى، والفن من الداخل إلى الخارج، ولماذا تكتب القصة. وثانيها الهروب والتأويل، وثالثها الحبكة، والتشويق، والإدهاش، والوحدة الفنية. أما رابعها، فيتحدث فيه عن الشخصية، التي يعتبرها مع الحبكة مادة واحدة.
وأول الأسئلة التي يطرحها أبو بكر هو الآتي: "هل يمكن تعلم الكتابة؟"، ويرى أن الأمر يبدو مشابها لموقف سئلت فيه ناديا بولانجيه، مدرسة التأليف الموسيقي، عما إذا كان من الممكن تدريس هذه المادة، فأجابت: "لا أعرف، ومع ذلك سأمضي في تدريسها". وكان تعلمها ممكنا، إذ خرج من تحت يديها عدد من كبار الموسيقيين.
وإذا كان هناك من يفكر في إثارة سؤال مثل هذا حول تعلم الكتابة -وكثيرا ما يسمع شيء من هذا القبيل- فيمكن بالمقابل طرح السؤال الآتي: هل يمكن أن يعلم أحد أحدا شيئا؟ أليس الأمر كله نوعا من التعلم؟
أما عن الموهبة وتوابعها، فيقول أبو بكر إن هناك ما يوحي بأن كل شخص يمكنه تعلم الكتابة، إذا كانت رغبته وحاجته قويتين؛ فعندما يقبض على الفكرة، لا يستطيع التخلص منها أبدا.
وقد روى أحد الكتاب أن إحدى رئيسات التحرير أخبرته في مطلع شبابه شيئا لن ينساه أبدا، إذ قالت له: "يبدو أن لديك الموهبة، ويبقى أن نعرف إن كانت لديك توابعها".
وكتب كاي بويل: "إن الشيء الذي يحتاجه أي كاتب هو أن يجد من يؤمن به، ليس الموهبة، بل شخصا يؤمن به". ولكن الواقع، كما يرى أبو بكر، أن ما يحتاجه الكاتب فعلا هو أن يؤمن بنفسه. وتقول إحدى شخصيات غوركي في مسرحيته "الحضيض": "إن الموهبة هي أن تؤمن بنفسك". وهي مسرحية يستغرب أن يجد الإنسان فيها بصيص أمل.
ويشير المؤلف إلى أن غالبية الناس تتصور أن المفتاح السحري للنجاح في الكتابة هو الموهبة، لأن هناك شيئا غامضا وسحريا في الموهبة، تماما كما أن في النجاح نفسه شيئا من الغموض والسحر. وإذا كانت الموهبة هي الإيمان بالنفس، فإن كل إنسان يملك سبيلا إليها، وما تبقى يعود إلى جهده وإصراره.
ويرى أبو بكر أن هذا الإيمان ليس مفتاحا نحمله في حلقة أو سلسال، وليس أمرا يسهل الوصول إليه، ولا يحدث دفعة واحدة؛ بل هو أمر يجب العمل من أجله باستمرار. إنه أشبه بصخرة سيزيف التي لا يستطيع أحد أن يضعها بسلام فوق قمة التل، لكن يكفي أن تستمر محاولة دفعها إلى الأعلى كلما انزلقت إلى الأسفل.
في كلمة على غلاف الكتاب، كتب الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الشاعر مراد السوداني، ما يلي: "في كتابه النقدي اللافت (من اللغة إلى الكتابة)، يواصل الروائي والناقد والمترجم وليد أبو بكر تقديم عطاياه النقدية في انتباهات وسيعة تراكم تجربة نقدية غامرة الثراء، ونقدا مكينا بما هو معروف عن الناقد المضرس بالمعرفة والرؤية النافذة.
ثلاث عشرة دراسة يقدمها الناقد أبو بكر في سياحة نقدية يجمعها الحفر في طبقات اللغة وتحولات الكتابة، ومن خلال رؤيته النقدية يتقدم الناقد بحمولته القرائية المغايرة، ليمنح النص استحقاقه من الاستبطان والمداورة النقدية، المحمولة على وعي نقدي لافت، وتمكن من الأدوات المعرفية وسياقاتها.
في نقده اللافت لا مماراة ولا مداجاة، بل انكشاف للغة حد افتضاح مكنوناتها، ومخبوء الظلال في جدلية التجلي والتخلي، ومدارات يديرها وليد أبو بكر ثبتا على التجربة النقدية التي اجترحها بخصوصية وفرادة باذخة التناول.
في هذه الأوراق النقدية الجديدة، يواصل أبو بكر إيقاعه النقدي في مناولة الجماليات واقتراح المختلف لعديد الأنواع الإبداعية، ذاهبا في اللغة إلى مد مداها حد الجرح.
