عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
قراءة تحليلية في فصول كتاب "شذرات من تاريخ الأردن"
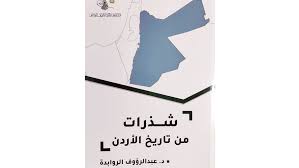
الغد-د. كايد الركيبات
صدر كتاب لدولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة "شذرات من تاريخ الأردن" عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، نهاية النصف الأول من هذا العام، وقد جاء في (301) صفحة من القطع المتوسط، مقسمة إلى ستة عشر فصلاً، وقائمة مراجع، وفهرس للبلدان وآخر للأعلام.
ولأن الروابدة رجل دولة وسياسي من طراز رفيع أكثر من كونه مؤرخاً أكاديمياً، تأتي الحاجة إلى دراسة الكتاب بالغوص في نَصِهِ السردي التاريخي، في محاولة اجتهادية لربط السردية التاريخية بالرسالة السياسية والثقافية المضمرة في متن الكتاب، وحتى نتمكن من ذلك يتوجب علينا استخلاص الأصول الفكرية التي ارتكز عليها دولته في اختيار الشذرات التاريخية في كتابه على اعتبار أن عنوان الكتاب مستودع الفكرة وخلاصتها، والتي نعتقد أنها تعكس رؤيته وتطلعاته المستمدة من سيرته الذاتية، وهذه محاولة نقرأ فيها الكتاب قراءة اجتهادية إن جانبتنا فيها الدقة المتناهية نأمل أن ننجو فيها من الخطأ.
نحاول من خلال هذه القراءة أن نؤسس إطاراً شاملاً متكاملاً للنهج الفكري السياسي الذي انطلق منه الروابدة ودفعه إلى تقديم هذا الكتاب ومخاطبة جيل الشباب على وجه الخصوص، قال في مقدمته: "هذا الكتاب يضم صفحات محددة من تاريخ الأردن، معلومات موثقة بطريقة سهلة ولكنها رصينة، أضعه بين يدي كل مواطن، وبخاصة جيل الشباب، عدّة المستقبل، ليعرف فيه بوعي موقع الأردن من الماضي، ساحة للمجد والعظمة والدور، ويعتز بحاضره من العزّة والسؤدد، فيصوغ مستقبله ساحة عربية أصيلة كانت لأمتها ومع أمتها على الدوام" (ص: 7،8).
في الفصول الستة الأولى من الكتاب أراد المؤلف أن يؤطر لفكرة المكانة التاريخية والحضارية للأردن عبر قراءة تعكس الامتداد الزمني والتنوع الثقافي والسياسي للأرض الأردنية، وبصفته رجل دولة ينظر إلى التاريخ كرصيد للهوية الوطنية، تعمد أن يضع الأردن في قلب الموروث الحضاري للشرق الأدنى القديم ليوحي بذلك ـ ونحن نتبنى معه هذا الرأي ـ أن المكان لم يكن فارغاً كما يتعمد كثيرون تصويره، بل كان مسرحاً لممالك ومجتمعات أسهمت في صياغة التاريخ الإنساني، مما عزز الإحساس بالقدم والرسوخ.
فهو من خلال استعراضه قوافل الغزاة: العبرانيين، الهكسوس، البابليين، الآشوريين، الفرس، اليونان، والرومان، أكد أن الأردن كان دائماً محط أطماع القوى الكبرى، لكنه في الوقت نفسه يقول لنا ـ بوضوح ـ بأن بقاء الإنسان الأردني بعد كل غزو دليلاً على قدرة الأردن على البقاء والاستمرارية رغم عِظم تلك التحديات.
ومن خلال حديثه عن الكيانات والدول العربية، الأدوميين والأنباط والغساسنة والهجرات العربية، أطر المؤلف للأردن كحاضنة لتشكيل هوية عربية مبكرة وذلك من خلال ربطه للجغرافيا الأردنية بالبعد القومي العربي، وعدها صلة وصل بين الجزيرة العربية والشام.
وفي سرديته عن الفتح الإسلامي والعهد الراشدي والأموي والعباسي، تعامل الروابدة مع الأردن بوصفه جزءاً حياً من المشروع الحضاري الإسلامي، وإدراجه الحديث عن فترات الحملات الصليبية، والعهد المملوكي والدولة الأيوبية كان بدافع إبراز الدور الدفاعي للأردن في حماية الأمة. وفي حديثه عن العهد العثماني أكد أن الأردن ظل جزءاً من فضاء إسلامي شرقي واسع، لكنه حافظ على خصوصيته الجغرافية والبشرية.
هذه الرؤية أسهمت في رسم صورة ناصعة للأردن وقدّمت تصوراً خاصاً لمكانته التاريخية والحضارية التي تقوم على إبراز الامتداد الزمني العميق والتنوع الحضاري الذي شهدته هذه الأرض، مؤكداً أن المكان كان دائماً مركزاً حيوياً لتشكل الممالك والثقافات، وأن الإنسان الأردني كان عنصراً مشاركاً وفاعلاً في نشر الرسالة الإنسانية، ومدافعاً صلباً عنها في إطار التفاعل الحضاري.
نستشف من ذلك رسالة المؤلف الضمنية التي تؤكد أن المكانة التاريخية والحضارية للأردن ليست مكتسبة حديثاً، بل هي نتاج تراكم عصور متواصلة عميقة في التاريخ عمق الجذور وأصالة الهوية.
ينظر الروابدة إلى التاريخ باعتباره الضمانة الأولى لبقاء المجتمع واستمرار هويته؛ لذا يعرض الأحداث بوصفها مراحل متصلة في ترسيخ بناء الدولة الأردنية، لا مجرد وقائع عابرة، ففي الفصول الخمسة ـ من الفصل السابع إلى الفصل الحادي عشر ـ تحدث عن نشأة الدولة الأردنية الحديثة باعتبارها ثمرة مباشرة للثورة العربية الكبرى وجهود القيادة الهاشمية، وتضحيات الأردنيين في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، فالروابدة يربط من خلال السردية التاريخية التي قدمها بين الثورة العربية الكبرى والعهد الفيصلي، ثم قدوم الأمير عبدالله وتأسيس الإمارة، وصولاً إلى مرحلة الانتداب والاستقلال، ليؤكد أن الدولة الأردنية لم تكن هبة من أحد، بل مشروع وطني عربي قاوم التحديات ليترسخ كيان شرعي. وعن تأسيس أول سلطة تنفيذية في الإمارة في 11 نيسان 1921، قال: "وتتضح من التشكيل الصيغة العروبية للوزارة التي ضمت زعماء وطنيين من دون أي مكانة للإقليمية. كان هدف الأمير إعادة وحدة بلاد الشام لا إقامة دولة في شرقي الأردن. وقَبِل الأردنيون الأمر لأنهم يعدون الوطن لكل العرب، ولالتزامهم بالهوية العروبية" (ص: 102). وكون الروابدة من جيل خَبِر شرعية القيادة الهاشمية عملياً، فإنه يركز على دورها في حماية الكيان الأردني وربطه بالعروبة والإسلام، ويرى أن الحكم الهاشمي هو الامتداد الطبيعي للثورة العربية الكبرى بصفتها ثورة عروبية قومية، رغم ما تعرض له من دعاية وتشويه من دول الجوار والإقليم العربي، قال: "أدت المزايدات، واستجداء الشعبوية على حساب الحقيقة والواقع إلى إيصال الأمة العربية إلى أوضاع صار فيها ما يقل بأشواط عن قرار التقسيم مطلباً عربياً نضالياً تتفق عليه الدول والفعاليات الوطنية، لقد جعلت سياسات الملك عبدالله الواقعية الحكيمة هدفاً لاتهامات ظالمة له وللأردن من أولئك الذين لم يحرروا أرضاً، ولم يحتفظوا بالأرض التي كانت تحت أيديهم. لقد التهوا بالصراعات الزعامية عن توحيد الجهود وقوى النضال" (ص: 171).
وبرأيه أن استشراف المستقبل يتطلب من جيل الشباب معرفة الماضي، فوعي الشباب بمرحلة التأسيس وأخطارها يُرسّخ الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهكذا أراد أن يزرع في وعي الشباب أن حماية الأردن اليوم لا تنفصل عن إدراك مسيرة بنائه بالأمس، وأن المستقبل لا يُستشرف إلا عبر استيعاب دروس التأسيس ومواجهة التحديات.
ولأن الروابدة يقرأ التاريخ الأردني من زاوية التحديات الأمنية (غزوات، تمردات، مؤامرات إقليمية)، تأكدت قناعته السياسية أن الأمن هو الشرط الضروري للتنمية والسيادة، فالأمن والاستقرار أولوية وطنية، فمن وجهة نظره وفقا لانتخابه موضوعات محددة في الفصل الثاني عشر من الكتاب والحديث عن محطات مثل حلف بغداد، وتعريب قيادة الجيش العربي، وانتخابات 1956، وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية، والعدوان الثلاثي على مصر، ومشروع أيزنهاور، والاتحاد العربي والانقلاب العراقي، نجده يؤكد أن الفكر السياسي الأردني قائم على التوازن بين الواقعية السياسية والتمسك بالثوابت، ويصور الروابدة من خلال هذا الطرح عهد الملك الحسين بأنه مرحلة اختبار وجودي للدولة الأردنية، وأن الملك كان قائداً سياسياً استثنائياً استطاع بحنكته أن يحافظ على الدولة الأردنية، ويمنع انهيارها، وأسس لاستقلالية القرار الأردني، الأمر الذي جعله رمزاً للصمود وبقاء الدولة في محيط مضطرب.
في الفصل الثالث عشر، نجد أن الروابدة بحكم خبرته السياسية يرى أن الأردن جزء من قضايا الأمة، لكنه لا يذيب كيانه في الآخرين؛ فهو يعطي أولوية للقضية الفلسطينية لكنه يوازنها مع ضرورة بقاء الأردن قوياً مستقلاً، فسرديته تكشف عن رؤية واقعية وطنية ترى أن الأردن وفلسطين كيانان متداخلان في التاريخ والجغرافيا والمصير، لكن مع ضرورة الفصل بين التضامن القومي والاعتبارات السيادية الخاصة بالدولة الأردنية.
لذا نجده يعرض القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأردن، مرتبطة بالأمن الوطني وبالشرعية التاريخية للقيادة الهاشمية، ويظهر قبوله لمشروع الوحدة بين الضفتين في حينه باعتباره خياراً قوميّاً طبيعيّاً، لكنه يشدد ضمنياً على أن الوحدة لم تُلغِ خصوصية الأردن، وأن الغاية من هذه الوحدة "أن الضفة الغربية وديعة لدى الأردن، وأنه لا يجوز أن تؤثر هذه الوحدة على التسوية النهائية للقضية الفلسطينية" (ص: 177).
وقد تحدث عن حرب حزيران 1967، باعتبارها مأساة قومية، لكنها أبرزت أيضاً ثبات الأردن رغم الخسارة، أما بخصوص حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والعمل الفدائي فقد قدّم موقفاً نقدياً محافظاً؛ إذ يرى أن العمل الفدائي داخل الأردن قاد إلى أزمات هددت الدولة، وبرأيه أن التوازن بين دعم المقاومة وحماية السيادة كان ضرورياً، كيف لا وكانت دعوة الشقيري تتضمن "أن تحرير عمان شرط مسبق لتحرير فلسطين، ودعا إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وطلب من الوزراء الفلسطينيين الاستقالة من الحكومة الأردنية فلم يستجب له أحد، ثم أعلن تشكيل مجلس ثوري سري ينفذ عمليات فدائية في الأردن" (ص: 187).
وينقل عن صلاح خلف (أبو إياد) قوله: "الثورة الفلسطينية ارتكبت خطأ جسيماً عندما سمحت بقيام منظمات عديدة للعمل الفدائي حتى وصل الأمر إلى قيام (12) منظمة لها (12) قائداً بـ (12) عقلية ومفهوماً مختلفاً" (ص: 192). فكان موقف الأردن الصلب في التصدي للفوضى التي جرتها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح موقفاً مشروعاً.
أما بخصوص مشروع المملكة العربية المتحدة 1972، فبرأيه أن المشروع كان فرصة كبيرة لخدمة القضية الفلسطينية لكن خيارات الأردن كانت محتكمة ومقيدة بالواقع السياسي الفلسطيني والعربي الذي جابه المشروع بالرفض القطعي، وأن قرار الأردن فك الارتباط الإداري بالضفة الغربية 1988، كان قبولاً بالرغبة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية المدعومة عربياً، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن هذا القرار كان تثبيتاً لسيادة الدولة الأردنية وحماية لمصالحها، رغم قسوته على المستوى القومي.
وفي الفصل الرابع عشر المعنون بـ "السلام العربي الإسرائيلي" يرى أن الأردن لا يملك خيار الحرب المفتوحة، لكنه يملك خيار حماية الأرض والناس بالسياسة، وبالمفاوضة، وبالصمود الهادئ طويل النفس، وبذلك يمكننا القول إن موقفه كان يتسم بالبراغماتية والواقعية، وهو موقف رجل دولة يوازن بين الثوابت القومية والضرورات الوطنية. ومن خلال استعراضه إرهاصات السلام والصلح المصري ـ الإسرائيلي، يلمّح الروابدة إلى أن مسار التسوية لم يكن اختياراً حرّاً بقدر ما كان نتيجة موازين قوى إقليمية ودولية ضاغطة، وبرأيه أن مضي الأردن في الطريق إلى السلام ومؤتمر مدريد كان خياراً نابعاً من مسعى الأردن الدائم لأن يكون جزءاً من الجهود الجماعية العربية، حفاظاً على وحدة الموقف، لكنه تحرّك بمرونة حين تباينت المسارات.
وأن نتائج اتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربة التي انتهت بتوقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، كانت تسوية واقعية تهدف إلى حماية الأردن من أخطار ديموغرافية وأمنية، وضمان اعتراف دولي بحدوده وحقوقه، خصوصاً في ظل غياب حل شامل للقضية الفلسطينية. والرسالة الضمنية التي يمكننا فهمها من هذا التقديم أن الروابدة يُرسّخ فكرة أن الأردن لم يتخلَّ عن التزامه القومي، لكنه اختار مسار السلام حفاظاً على كيانه واستقراره، في وقت كان البديل فيه الفوضى أو العزلة، وأن هذا حق مشروع له كدولة، وواجب وطني مناط بالنظام السياسي تحمل مسؤوليته التاريخية بعزيمة واقتدار.
قال في ذلك: "استرد الأردن حقوقه في أرضه ومياهه ورسّم حدوده من دون الإخلال بالحقوق الفلسطينية والعربية الأخرى، وأصبح أكثر قدرة وعزماً في دعم تلك الحقوق. ومن ثمّ، فإن الأردن لم يقبل الحل المنفرد إلا بعد أن قبل الفلسطينيون مثل ذلك الحل" (ص: 229).
يُظهر عبدالرؤوف الروابدة في تناوله لموضوعات الفصل الخامس عشر رؤية سياسية متوازنة تربط بين الداخل الأردني ومحيطه الإقليمي. فهو يرى في الحياة البرلمانية مرتكزاً للشرعية السياسية وأداة لترسيخ المشاركة الشعبية في الحكم، حتى وإن شابتها فترات تعثر أو تعطيل، إذ تبقى جزءاً أصيلاً من هوية الدولة الحديثة. أما في تناوله الحرب العراقية ـ الإيرانية وغزو العراق للكويت، فيكشف عن موقف واقعي يؤكد أن الأردن كان محاطاً بتحديات جسيمة فرضتها الصراعات الإقليمية، وأن التعامل معها تطلّب سياسة توازن دقيقة بين الالتزام القومي وحماية المصالح الوطنية.
وفي طرحه لموضوع الوصاية الهاشمية، يبرز قناعة راسخة بأنها ليست مجرد دور ديني أو رمزي، بل عنصر جوهري في شرعية النظام السياسي الأردني، ومصدر مكانة دولية للأردن في محيطه العربي والإسلامي. والرسالة الضمنية التي يوجهها الروابدة للأجيال هي أن تماسك الداخل عبر الدستور والحياة البرلمانية، مع تمسك القيادة الهاشمية بدورها التاريخي، شكّل الأساس الذي مكّن الأردن من الصمود في وجه التحولات العاصفة في المنطقة.
تجربته كرئيس وزراء دفعته للنظر إلى التاريخ من منظور تطور الدستور، الحياة البرلمانية، والسلطات الثلاث، ليؤكد أن الدولة تُبنى بالقانون لا بالصدفة، ففي عرضه للفصل السادس عشر حول نظام الحكم الأردني، قدّم تصوراً سياسياً يؤكد أن قوة الدولة واستقرارها ينبعان من المؤسسات الدستورية التي تنظم العلاقة بين السلطات، فهو يرى أن السلطة التنفيذية، بقيادة الملك والحكومة، تمثل محور إدارة الدولة وضمان سيرها بفعالية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. أما السلطة التشريعية، فيُبرز دورها كصوت الشعب ومصدر التشريع، بما يرسّخ فكرة المشاركة الشعبية في الحكم ويعطي شرعية لقرارات الدولة. وفي تناوله للسلطة القضائية، يوضح أن استقلالها هو الضمانة لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق، والحفاظ على التوازن بين السلطات.
يمكن القول في ختام هذه القراءة إن كتاب "شذرات من تاريخ الأردن" للدكتور عبدالرؤوف الروابدة ليس مجرد إطلالة على وقائع الماضي، بل هو جهد يراد به بناء وعي وطني حديث يستند إلى إدراك عميق للمكان والزمان، فالكتاب قدّم التاريخ باعتباره حواراً مفتوحاً مع الحاضر، ومنصة للتفكير في المستقبل، لا باعتباره أرقاماً وأحداثاً جامدة. وبهذا المعنى، فإن قيمة الكتاب تكمن في توظيف السرد التاريخي ليكون أداة تربوية سياسية وثقافية، تتيح للأجيال الشابة أن تنظر إلى وطنها بعين الاعتزاز والالتزام والمسؤولية. ختاماً؛ أضم صوتي لصوت أستاذنا ومعلمنا الدكتور علي محافظة الذي قال في ختام تقديمه للكتاب: "إنه كتاب يجدر بكل أردني وعربي قراءته لما يحتويه من معلومات وأفكار وآراء وقضايا مهمة، وآمل أن تتولى وزارة الثقافة الأردنية نشره ضمن برنامج مكتبة الأسرة الأردنية ـ القراءة للجميع، لما فيه من فائدة. وهو كتاب جدير بالاقتناء أيضاً. وأتمنى لدولة عبدالرؤوف الروابدة مزيداً من العطاء، والعمر المديد".
